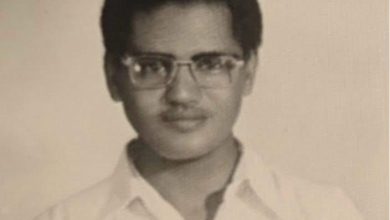صورة الحبشة. بقلم/ يوسف حمد*

11-Jul-2017
عدوليس ـ نقلا عن مجلة الحداثة السودانية
كان أوّل اتصال لي بكلمة “الحبشة” يوم أن سمعتُ اسم بائع رغيف الخبز في قريتنا بوسط السّودان. كان اسمه “الحبشي”، هكذا، بلا زيادة أو نقصان، وكان حبشيّاً حتى النّخاع، لم يتنازل، ولو للحظة، عن لباس “الشّمة”، وربما أغراه احترام النّاس له، فأسكت فيه أي حنين إلى حياته هناك، في الحبشة.كان الحبشي في نحو الخمسين من عمره، يجوب شوارع القرية بحمار أشبه بالحُمر حاملة اللبن، المستنفرة في العاصمة الخرطوم هذه الأيام. ولأنّه كان كمن ابتلع لسانه، لم يكن ينادي على بضاعته بالكلمات، على غرار الباعة الجّائلين، إنما يضرب بمنسأةٍ رفيعة على الصّناديق المحمّلة بالرّغيف: “طقطقطق” فيعرف الجّميع أن الحبشي جاء كعهده.
اختفى الحبشي من قريتنا في ظروف ما زلتُ أجهلها، أو ربما لأنّ أحوال القرية تغيّرت بوتيرة سريعة، ولم تعد تناسبه؛ لكن اختفت مع غيابه أي دلالة على وجود شيء مادي اسمه (الحبشة) في حياتي، سوى ندبة كبيرة في فخذ والدي الأيمن، خلَّفها طلق ناري أصابه من بندقيّة حبشي آخر، لكنّه نهَّاب، أيام كان والدي شابّاً يرعى إبل أبيه في أقصى شرق البلاد. ربما كان الحبشي الذي صاد والدي يحمل ضغينة منذ أيام الملك الحبشي يوحنّا (1835- 1883) الذي قتله جنود المهدية، وربما كان يثأر لرأس يوحنّا المقطوع بسيوفهم.
انتظرت عدة سنوات حتى أبلغ سن التّلمذة المدرسيّة، كي تعود كلمة (الحبشة) إلى مسمعي مجدداً؛ تعود مقرونة، هذه المرة، بسيرة ملك غير مسلم، عاش قبل يوحنّا بقرون، ينحاز هذا الملك إلى الديانة التّي أصبحت تخصّنا، في ما بعد. عرفنا أن ذلك الملك اسمه النّجاشي.
الآن أنا على وشك الانتهاء من تعليمي الابتدائي، وأعرف شخصين، فقط، من بلاد الحبشة: الحبشي، بائع رغيف الخبز، وقد رأيتُه رأي العين، ثم الملك النّجاشي، واكتفيتُ أن أرسم للنجاشي صورة ذهنية مطابقة لصورة الحبشي بائع الرّغيف، أو قريبة منها، وهي الصّورة الموجودة في مخيلتي حتى الآن، لم ينتزعها مني الممثل، عبد العظيم عبد الحق، الذي أدى دور النّجاشي في فيلم (الرّسالة) للمخرج السّوري مصطفى العقاد (1930- 2005). بعد ذلك، ازدادت معلوماتي ببلوغي السّنة السّادسة من التّعليم، وعرفتُ أن مياهاً متدفقة تأتي إلى بلادنا من بحيرة (تانا) في الحبشة، وأن حكومة الرئيس جعفر نميري (مايو 1969- أبريل 1985) تواطأت مع الدولة الإسرائيلية لنقل آلاف من الأحباش اليهود (الفلاشا).
عقب تخرجي في الجّامعة، سكنتُ لسبع سنوات بضاحية الجّريف، الخرطوم، كنت أعمل خلالها في مخبز لإعداد الرّغيف، وهو نشاط كنتُ أعين به نفسي على دفع نفقات الدراسات العليا التي افترعتها؛ فصادفتُ، خلال وجودي في المخبز، الآلاف من الحبش المقيمين هنا، وعقدت صداقات متينة مع المئات منهم، وتجادلنا معاً حول (بوب مارلي، وولسونيكا، شينوا أشيبي، ليوبولد سيدار سنغور.. وحزنت مع بعضهم، حقيقة لا تصنُّعاً، على مصرع الأميرة ديانا، المحبوبة لدى غالبيتهم، وأهداني أحدهم فنيلة رائعة، طُبعت عليها صورتها). وفي شخصيات أصدقائي الحبش، يجد المرء امتزاج الإخلاص بطيب المعشر، لكن ما يؤسفني حقاً، أنني كنتُ أهمل الكتب التّي كانت بين أيدي المثقفين والمثقفات منهم؛ لأنها مكتوبة باللغة الأمهريّة، سليلة اللغة الجّئزيّة، إذْ كانت عصيَّة على بصري ولساني، مثلما كانوا هم يهملون كتبي المكتوبة بالعربيّة. وصدف أن لازمتني طفلة حبشيّة ذكيّة، كانت في سن التّلمذة، وجدَّت في تعليمي لغتها الأم بالكتابة، لكننا كنا، أنا وهي، بالكاد نكتب اسمينا وبعض عبارات التّحايا والمجاملة، خلال محاولتها تلك.. وكانت تضحك، بكامل سعادتها، سخرية من ثقل يدي غير الماهرة في كتابة الأمهريّة. وحتى درس الطفلة ذاك نسيته منها في سياق إهمالي لثقافة جيران الخاصرة.
مع ذلك كله، لا عجب أن يكون أصدقائي وصديقاتي من (حبش الجّريف) خير معين لي في فهم التّوزيع الديمغرافي لسكان القرن الأفريقي، المقرر علينا ضمن برنامج (ماجستير العلوم السّياسيّة والدراسات الإستراتيجية) في جامعة الزعيم الأزهري. لقد كان المقرر متواضعاً بالنّظر إلى حاجتي المعرفيّة الآن، خاصة في جانبها المتعلق بالإنتاج الإبداعي والفكري لشعوب القرن الأفريقي كافة، والحبش منهم بخاصة. كان برنامج الماجستير برمّته سياسياً صرفاً، منزوع الثقافة، ويُعنى، في ما يعنى، بتفكُّك الدول واتحادها، وقضايا اللاجئين، والصّراع حول المياه، والحرب النّفسيّة، وما إلى ذلك من القضايا السّياسيّة المعاصرة.
إبان عملي في الصّحافة، كُلِّفت بعمل صحفي ميداني في شرق السّودان، ولأنني كنتُ المقترح للفكرة، كان من المأمول أن يزيد العمل الميداني من معلوماتي عن الجارة أثيوبيا، لأنني نويتُ، في ما نويت، أن أسبر غور علاقات الجوار في الشّريط الحدودي الطويل الممتد، وبتأثير من دراستي الجّامعية، كنت شديد الحساسية لالتقاط ثلمات التداخل بين الشّعبين.. فمن الخرطوم حملت معداتي الصّحفية القليلة، وشنطة ظهر، فيها بنطلونات الجّينز والفنايل المريحة، وتحركت إلى مدينة القضارف، ومن ثم إلى القرى الواقعة شمالها لعدة أيام. كنت خلال رحلتي إلى شمال القضارف أتتبع مصدر مياه المدينة الشّحيح في سد (دلسة)، إلى جانب انشغالي برغبتي الملحة في عكس حياة السّكان هناك.. ومن الشّمال، عدت إلى القضارف ليوم واحد، ومنها اتجهت جنوباً إلى قرية (كسَّاب) حيث المستشفى البائس المتخصص في حمى (الكلزار) المتفشية على نطاق واسع وسط الأهالي، ومن كسّاب، تحركت جنوباً في طريق ملتوية يحرسها جنود. تحركت من قرية إلى قرية، إلى أن بلغت مدينة (القلابات) في الحدود مع إثيوبيا، هي ليست مدينة إلا على سبيل المجاز، طفت في القلابات أتلصص المداخل ومظان مفاتيحها: وجدت مركزاً للشرطة ومبنىً للجمارك ومركزاً صحيّاً، لا يمكن التعويل عليه في صحةٍ أبداً. كانت القلابات خليطاً من السّحنات المختلفة، ومركزاً رائجاً للتجارة، يقبل التّداول بالعملتين، السّودانية والإثيوبية، وفوق ذلك، ملتقىً جيداً لتجَّار تهريب السّلع. بعد عدة أيام في القلابات، واتتني الجّرأة لدخول مدينة (المتمة) الإثيوبية، ولم يكن ذلك ليكلفني غير عبور الكوبري الصّغير المشيَّد على الخور الفاصل بين الدولتين. كان الكوبري يفتح أبوابه الحديدية عند السّاعة السّادسة صباحاً، بوساطة أفراد الشّرطة السّودانية، وتبدأ مع فتحه حركة الشّاحنات وناقلات البضائع الإثيوبية، ويبدأ، كذلك، سعي النّاس الداخلين من إثيوبيا والخارجين من السّودان: عمال من الجّنسين، وتجار، ولصوص، وطالبو المتعة والرّاحة والرّاح. يتحركون في الكوبري حتى موعد إغلاقه عند السّاعة السّادسة مساءً. كان دليلي، وهو من المقيمين في القلابات، يحذِّرني من العبور إلى المتمة، من منطلق أنني أبدو غريباً عن أهل المكان، وهذا ما يجعلني عرضة للتحرُّش من قبل اللصوص الإثيوبيين. في الواقع، كانت رغبتي في العبور أكبر من خوفي؛ فعبرت مشياً على الأقدام، كانت تحملني خواطري وأنا أمشي على الكوبري الذي لا يزيد طوله عن السّتة أمتار. وللأسف، انتظرني التّحرُّش في الضّفة الأخرى، وكم امتص من حماسي الدافق لمعرفة شيء جديد! كان التّحرُّش يمشي على أربع عشرة قدماً، وله مثلها من الأيدي، وله سبعة وجوه مستهزئة بالغريب وطامعة فيه. لا يبدو أن الذين تحرّشوا بي سمعوا شيئاً من كلام الحكيم يوحنّا إلى عبد الله التعايشي “… أنتم ونحن أولاد جد واحد؛ فإذا قاتلنا بعضنا فماذا نستفيد؟ فالأفضل والأصوب أن نكون ثابتين في المحبة جسداً واحداً…”.1
شخصياً، أستطيع أن أمضي بحكمة يوحنّا إلى قدر بعيد من الصّحة “أنتم ونحن أولاد جد واحد…” وذلك بالموقف الطريف الذي حدث لي يوم ذهبتُ لأكون معلماً في مدرسة الشّواك الثانوية، شمال مدينة القضارف. ركبت الحافلة العامة من مدينة ود مدني إلى القضارف، ومنها إلى (الشّواك) التي وصلتها قبل مغيب الشّمس بوقت قليل. وفيها، كان لابد للحافلة أن تأخذ إذن الدخول إلى المدينة من مكتب تابع للجهات الأمنية، ومن هذا المكتب صعد أحدهم بلباس مدني، وتفرّس في وجوهنا، ونحن لم نزل في الحافلة، وما تكاد تمر لحظات من التفرّس حتى اختارني بإشارة من أصبعه أن أنزل؛ فنزلت، وكنت الوحيد الذي نزل، وقادني المتفرّس إلى داخل المكتب، وبدأ سلسلة من الأسئلة: ما اسمك؟ أين بطاقتك؟ من أي المدن؟ ولماذا أنت هنا؟ عقب الأسئلة التي امتدت لأكثر من نصف سّاعة، قال لي: المعذرة يا أستاذ، ظننت أنك من إثيوبيا، ومهمتنا، هنا، القبض على اللاجئين منهم ومن الإريتريين. استفهمت في سري عن مدى التنسيق، حول اللاجئين، بين الحكومة و(المفوضية السّامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة) الموجودة في الشّواك نفسها! لكني لم أستنكر تشبيهي بالحبش الذي أكده لي، لاحقاً، أصدقائي وصديقاتي من حبش الجّريف.
سقت إليكم هذا التّداعي المطوَّل لأصل معكم وأسأل سؤالي المباشر، لا عن الحبشي بائع رغيف الخبز، ولا عن الملك النجاشي، ولا بحيرة تانا، ولا الطفلة الحبشيَّة التّي كبرت بلغتها وتركتني فيها صغيراً، أتكفف التّرجمة. إنما أسأل للعثور على ترجمات للأثر الأدبي والفكري الذي أنتجه الكتَّاب والشّعراء والفلاسفة وسائر الإنتلجنسيا من جيران الخاصرة الذين يبلغ عددهم المائة مليون.
هل فيكم من يعرف روائيّاً حبشيّاً، أو قرأ له رواية؟ هل فيكم من يعرف شاعراً حبشيّاً، أو قرأ قصيدة شعر حبشيّة؟ هل فيكم من يعرف أي مفكِّر، أو كتاب لمفكِّر حبشي؟ أي مقالة، أي سطر؟أنا، بكل أسف، لا أعرف إلا المسرحي سقاي قبرا مدَّين، ابن قبيلة القالا، ذلك المسرحي المهيب الذي قدّمه لنا الدبلوماسي الرّاحل جمال محمَّد أحمد في كتابه (في المسرحية الأفريقية)*.. درس قبرا مدَّين القانون في شيكاغو والمسرح في لندن.
قال جمال إن إثيوبيا كانت تتكشف أمام قبرا مدَّين، إذْ “ترامى إليها النّغم الجّديد في القارة (…) حين أضحت أديس، مكّة أفريقيا، مقعد اللجنة الاقتصادية الأفريقية، ومن بعد، مقعد منظمة الوحدة الأفريقية (…) وكان سقاي يرقب هذا ويحتفل صامتاً بانهيار قلاع العزلة والذعر، فغنى، أول ما غنى، بهذه النّسمة المنعشة في المرفأ، أفريقيا:
أمي أمسكي بيدي
أمي السّوداء هاك يدي
أريد لأنهض قائماً على قدمي
أريد أن أشير، أمد أصبعي، أقول:
تلك أرضي.. ذاك طافي
في قحة أريد أن أقول:
أنا أتهم”!2
يقول جمال: “آثر سقاي أن يغني أساطير إثيوبيا وأفريقيا في شعر تتقد فيه حرارة التروبادور، مع كل تجربة وقصيدة، وعكف على الأساطير والتاريخ يقرأهما، وما أظنه كان يعرف أنه حين يفعل هذا يعد نفسه لشيء كبير (…) مدّ يده بورقة ذات مساء يسألني، وكان قد عرف المرح مع الزمن: “أتستحق هذه القراءة، بله الخلود؟ لقد أضنتني إضناء وأنا أترجمها لك من أصلها الأمهري إلى الإنجليزية”، وبدأتُ أقرأ في صوت يسمعه، وهو يميل يمنة ويسرة، تذكر إذ تراه، شيخ وكتّاب قرية، يتحلَّق حوله حواريوه كل “يُسمِّع لوحه”. وقلت غير مازح: “لا بأس، لكن شعر ذقني لم يقف” كما كان يقول هاوسمان حين يملك عليه أقطار قلبه معنى يريده شعراً، والكلمات تطل وتذهب، تغيظه. ثم قرأها هو قراءة لا عجلة فيها ولا إدغام، وأشهد أن شعر ذقني، آنذاك، وقف يتلقى:
أمي السّوداءكان لي يوماً من الأيام ذات
كان لي اسم وراح
كانت الرّوح قوية
كان شاكا وحرابي لا تقاوم
في المتابيل التقينا.. وحرسنا أرض زولو
من غزاة كاسرين. بعض وقت
أسلم الرّوح لوقو نبولا
وهو قائم. رفض الرّقود
وهيروس ظل يحرس نامقا
واستحال. أسلم الرّوح يحارب”.3
ومنذ كتاب جمال، 1973، انقطع خيط الضّوء الذي يزيح غبش جارتنا من خلف الزجاج! ترى كيف تكون هي الآن؟
____________
هوامش:
* كتب جمال كتابه (في المسرحية الأفريقية، دار التأليف والترجمة والنّشر، جامعة الخرطوم، 1973م) وخصّص الجّزء الأكبر منه للإثيوبي قبرا مدَّين، حيث استعرض مسرحيته (أزماري وثيودورس)، والمسرحية الشّعرية (الإله في جوف شجرة البلوط) التي طبعتها أكسفورد في العام 1964.1- رسالة الملك الحبشي يوحنّا إلى عبد الله التعايشي، ضمن كمال الجّزولي، إنتلجنسيا نبات الظل- مدارك 2008.
2- جمال محمد أحمد، في المسرحية الأفريقية، دار التأليف والترجمة والنّشر، جامعة الخرطوم، 1973.
3- جمال، مصدر سابق
* صحفي وكاتب سوداني.