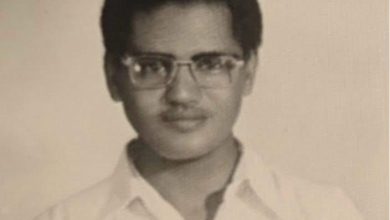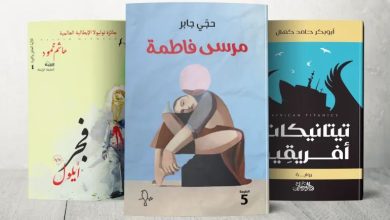قراءة لمعوقات مشروع نهضة إرترية : بقلم: زين العابدين محمد علي
21-Jun-2007
ecms
هذه المقالة تحاول أن تثير عددا من التساؤلات من بينها: ما هى حقيقة الأوضاع في إرتريا؟ من المسؤول عن التدهور العام لأوضاعنا؟ لماذا لانلاحظ أي تقدم ملحوظ في رؤى الناس وأفكارهم، وبالتالي انعكاس ذلك في الاختيار السليم لانتماءاتهم؟ لماذا نرى تقهقرا في الهويات الجامعة،
وتتعزز دعوات التشرذم والتقزيم، ويحصل دعاتها على شعبية واسعة؟ أين هي الثقافة الوطنية الإرترية المتعددة والمنفتحة على الآخر؟ هل هناك إمكانية للوصول إلى تعددية سياسية من نوع آخر، لا تتحمل فشل التعددية السابقة في التنظيمات والتيارات السياسية في الساحة الإرترية؟ لو افترضنا جدلاً أن إرتريا تتكون من ثلاثة أطراف يعتبرون فاعلين أساسيين في تكوينها وهم: 1. السلطة الحاكمة 2. المعارضة السياسية 3. عامة المواطنين (المجتمع المدني)، نرى خللاً واضحًا في علاقة هذه الأطراف ببعضها، ما يؤثر سلباً على سلامة وعافية هذا الكيان. من الطبيعي أن نرى أن طرفي المعادلة (1و2)، أي السلطة الحاكمة والمعارضة في سعيهما للوصول إلى السلطة وهما يبذلان جهدًا في استمالة الطرف الثالث باعتباره المكون الأساسي الذى يحسم كل من الطرفين السابقين صراعه من خلاله مع منافسه. في الحالة الإرترية هناك إشكالية واضحة وكبيرة في علاقة المعارضة والسلطة بالمواطن، وهي علاقة ضعيفة بالنسبة للمعارضة بحكم تمركزها خارج البلاد أولاً، وبحكم أن قوى المعارضة نفسها لم تبتدع أساليب للنضال تمكِّنها من الوصول إلى الداخل، ناهيك عن الحديث عن سلوك المعارضة ومنهجها وبنيتها والذي أدى إلى عجزها عن اجتذاب المناصرين لها حتى بين الجاليات المتواجدة في الخارج. أما علاقة السلطة السياسية بمواطنيها، مع اعترافي بعدم الإحاطة بمجريات الأحداث في الداخل، إلاّ أن الأمر الملاحظ والمؤكد أنها ليست علاقة طيبة، بدليل أن أي مواطن إرتري تتاح له فرصة الخروج من بلاده لا يتوانى في ذلك، خاصة فئة الشباب، بحيث أصبحت إرتريا من أكثر بلدان العالم الطاردة لشعبها. ولو تطرقنا باختصار إلى وضع كل طرف من الأطراف الثلاثة على حدة، نجد أن السلطة القائمة في إرتريا تفتقر إلى أبسط مقومات الشرعية، بعد أن استهلكت رصيدها الثوري منذ دخولها أسمرا وتحول النظام إلى سلطة استبدادية فردية مدعومة من فئات مصلحية يتساقط أعضاؤها تدريجياًّ ويتناقصون كل يوم، هذا إذا استثنينا الزخم الذي كانت السلطة تنعم به في السنوات القليلة الماضية نتيجة تعبئتها الطائفية والجهوية، إلاّ أنها أثبتت عجزها عن استثماره حتى لإطالة أمد حكمها، وعمليات التآكل الداخلي لتجربة الجبهة الشعبية أفضل مثال إلى ما ستؤول إليه هذه السلطة إذا ما استمر الحال على ما هو عليه اليوم في الداخل. كما أن ملف السلطة فيما يخص حقوق الإنسان يبين حجم الكارثة التي لحقت بالبلاد والعباد. ودون الحديث عن المظالم الثقافية والسياسية والدينية والاجتماعية بشيء من التفصيل، فهي بادية للعيان لكل من يشاهد الفضائية الإرترية ولو لساعات قليلة، وتتحدث بشكل صارخ عن فشل السلطة القائمة في إنشاء وطن إرتري، ولم يتأهل مشروعها القائم منذ استقلال إرتريا وحتى هذه اللحظة أن يسمّى مشروعاً وطنياًّ، بل يمكن تسميته بامتياز واحداً من مشاريع الأوطان أو الدول الفاشلة في العالم الثالث. أما المعارضة السياسية التي كان مشروعها الأساسي، ولا أقول مشروعيتها، قائماً على مقاومة الظلم والاستبداد، والنضال من أجل استبدال النظام الأحادي بنظام ديمقراطي تعددي، فقدت هي الأخرى مصداقيتها، خاصة في الآونة الأخيرة، نتيجة الفشل الذريع الذي أعقب مؤتمر أديس أبابا، ولم تخرج المعارضة بعد من عنق الزجاجة الذي أقحمت فيه نفسها. يحاول طرفا التحالف الحاليّان تقديم أكبر كمية ممكنة من المعلومات والإسهاب في شرح الملابسات التى رافقت انعقاد مؤتمر التحالف لدعم موقفه أمام الإرتريين. في نظري لا قيمة لهذه الوقائع والأحداث ولا تفيد إلا إذا تم تقديمها في إطارنظري يؤسس لإمكانية تجاوز واقع الضعف والتجزئة والتشرذم، لكن الجهود المبذولة حتى الآن والبادية للعيان تسعى إلى تكريس هذا الواقع البائس. الأمر الأدهى من كل ذلك هو محاولة تقديم قراءة مبتورة ووليدة اللحظة لواقع ثقافي_سياسي معقّد ومأزوم منذ فترة ليست قليلة. من هنا يمكننا أن نرى بوضوح عجز طرفي المعادلة السياسية (السلطة والمعارضة) من القيام بالدور المنوط بهما لأسباب تاريخية تنخر في بنية كل من هذين الجسمين. من المفترض أن يكون المجتمع الإرتري قد انتقل بعد خروج المحتل وإعلان إرتريا دولة مستقلة ذات سيادة إلى مجتمع ودولة “مواطنين”، مثله مثل سائر المجتمعات المستقرة، إلا أن ذلك لم يتم، ولم تساعد السلطة السياسية ولا المعارضة فى تحقيق هذه النقلة النوعية. لذا كثيرا ما نرى في خطاب السلطة والمعارضة على حد سواء وهو موجّه إلى “الجماهير” الإرترية ولا يتحدث إلى “المواطنين”، استنادا إلى تراث الثورة من فترة الكفاح المسلح والذي أملته ضرورات التجييش والتعبئة، ما يوضح بجلاء تخلف الخطاب السياسي الإرتري عن مواكبة التطورات التي طرأت في البنية الإرترية. أما بخصوص الطرف الثالث، أي عامة المواطنين “المجتمع المدني” نرى أيضًا حدوث تراجع واضح في الإحساس بالهوية الجامعة، أي الانتماء الوطني “المواطنة” بمعناها المعروف لدى الكثير من الأمم، لصالح دعوات الانعزال والتقوقع، نتيجة عوامل كثيرة سنأتي على تناول البعض منها لاحقًا في هذه المقالة. بعد استقلال البلاد وجلاء الوجود الأجنبي عن إرتريا كان من المفترض أن يتعزز ويتقوى الانتماء للوطن لدى الارتريين، إلاّ أن تطورات الوضع في إرتريا أضعف هذا الشعور لديهم، وتتحمل النصيب الأكبر فيه السلطة الحاكمة، كما أن قوى المعارضة تشاركها هي الأخرى في تفاقم هذه المعضلة في ممارساتها اليومية أكثر من ملاحظة ذلك في طرحها أو برامجها السياسية. يصبح هذا الحكم ظالما إذا توقف الحديث في تحميل الفاعلين الأساسيين (السلطة والمعارضة) مسؤولية تردي الأوضاع بالصورة التي هي عليها اليوم، لأن المجتمع المدني الارتري المنظم منه وغير المنظم يتحمل أيضا نصيبه من المسؤولية في ميله الواضح إلى الانجذاب إلى الانتماءات الضيقة على حساب الهوية الجامعة والمنفتحة على الآخر، والعمل في سبيل تثبيت المصالح المشتركة مثل إرساء دعائم الديمقراطية، والنضال من أجل حقوق الإنسان، وحقوق المواطنة وغيرها من القضايا التي تساعد على توسيع آفاق الناس دون التفريط في الدفاع عن هوياتهم الخاصة ومصالحهم المباشرة. نخلص من كل ذلك إلى ملاحظة ضعف شعور “المواطنة” و”الوطنية” المنفتحة على التعدد ومستوعبة له، وقادرة على احتضان أحلام المكونات الوطنية المتباينة في النمو والتطور، والسماح لها بقدر من التميز والحرية، مقابل استعداد أصحاب الهويات الخاصة لتقديم تنازلات طوعية وإظهار مرونة واضحة لصالح الهوية الجامعة “المواطنة”. هذا النوع من الانفتاح والنمو لسائر مكونات الوطن “المواطنين” لايتم إلاّ في ظل بيئة ديمقراطية تعددية، وفي ظل دولة القانون التي لا يجرأ في ظل تشريعاتها الدستورية وقوانينها أي أحد أو أية مجموعة على الاستقواء على الآخرين تحت أي مسمى أو مبرر . والاستقواء لا يتم عادة إلا بالعصبية سواء أكانت دينية أم جهوية، كما هو حادث الآن في الواقع الإرتري. والعصبيات بكل أنواعها تستهدف الهوية الجامعة وتضعفها، ونراها تستخدم في أي صراع أو نزاع من قبل طرفي الصراع سواء ظالمًا كان أو مظلومًا، والحالة الإرترية ليست استثناء في ذلك. والإنسان بطبعه يميل إلى استخدام نفس أدوات الصراع التي يستخدمها خصمه، فإذا استقوى خصمه برصيده الثقافي والديني لفرض سلطته وهيمنته عليه، من الطبيعي أن يستنفر المظلوم أيضًا مخزونه الثقافي والديني والعرقي لمقاومة الظلم. وهذا ما نراه واضحًا في تعبئة طرفي الصراع الارتري، السلطة والمعارضة، رغم الفروق الكبيرة في طرق استخدام هذا الرصيد الذي سبقت الإشارة إليه. فبينما نرى السلطة السياسية تبتز المشاعر والانتماءات المعادية للهوية الجامعة بصورة فاعلة وتوجهها لصالح ترسيخ أركان سلطتها، نرى المعارضة، بعكس السلطة السياسية، تستخدم التباينات القائمة في المجتمع الإرتري بصورة تضعف مقاومتها للسلطة المستبدة، وتبدد قدراتها، ما يؤدي بالنتيجة إلى ضعف قوى المعارضة والمجتمع المدني المناصر لها في سعيهما من أجل إقامة دولة القانون والتعددية الديمقراطية. هناك ظاهرة تنهك الجسم السياسي الإسلامي الإرتري بصورة مستمرة وهي التهرب والتسرب من الهوية الجامعة لصالح الانتماءات الضيقة، بعضها تبرره الظروف التاريخية التي مرت بها البلاد، إلاّ أن معظمه يتم تحت تبريرات واهية وضعيفة. الإشكالية الأساسية في فهم الناس لهذه الانتماءات تتمثل في النظر إليها وكأنها قدر مؤبد ضمن ثقافة ثابتة، وهذا ما يدحضه واقع الناس، لأن كثيرًا منها معطَّل ومعطِّل من الناحية العملية، لكنها يتم إحياؤها وتحريكها لخلق نوع من الارتصاص والاصطفاف السريع والمتهور وغير المدروس، ليزيد هذه الهوية المأزومة أصلاً أزمات إضافية أخرى سماها أحد الأصدقاء منذ فترة “مشاريع أزمات”، وليست بالطبع مشاريع تطرح حلاًّ لمعضلات حقيقية قائمة. كلنا يعلم أن المسلمين الإرتريين لعبوا دوراً رياديًّا في تنمية الشعور الوطني “الانتماء إلى إرتريا” بجعله خيارهم الأول ورفضهم تقسيم بلادهم بين السودان وإثيوبيا، وكان ذلك ناتجاً في اعتقادنا عن فهم استراتيجي ومتقدم لأوانه في عقد الأربعينيات من القرن النمصرم، لضمان وحدتهم الداخلية كمسلمين إرتريين تميزون بتباينات عرقية (قبلية)، ووجود امتداداتهم في دول الجوار الثلاث (إثيوبيا، السودان، وجيبوتي)، بعكس مسيحيي الهضبة التجرينيين الذين كان خيار الغالبية العظمى فيهم في ذلك الحين الانضمام إلى إثيوبيا التي يشاركون الفئة الحاكمة فيها (الأمحرا) التاريخ الثقافي والديني (أحباش-أورثوذوكس)، إضافة إلى وجود امتداد قومي وحيد لهم في إقليم تجراي الإثيوبي. لو عدنا لموضوع الخيارات نفسه لتبين لدينا أنه ليس مرهونًا فقط بإرادة جماعة ما، بل تحكمه ظروف وتفاعلات أخرى تحيط بالأوطان والمجموعات المكونة لتلك الأوطان. نحن هنا لسنا بصدد إعطاء موضوع “الوطنية” أكثر مما يحتمل من قيمة سلباً كان أم إيجاباً، لكن في الحالة الإرترية كان نماء المشاعر الوطنية مرهوناً بمدى تمسك المسلمين الإرتريين به، وهم لم يتمسكوا بتلك المشاعر إلاّ لأنها تضمن لهم حدًّا أدنى من تماسكهم الداخلي، مقابل تمسك الطرف الآخر في المعادلة الوطنية الإرترية (المسيحيين التجرينيين) بالانتماء الوطني كخيار ثان وبديل ضمن عدد آخر من الخيارات، مرة عندما عبروا عن أنفسهم كأحباش إثيوبيين، ومرة أخرى (في الوضع الراهن) عندما اختارت غالبيتهم مساندة دولة الاستبداد انطلاقاً من مشاعر قومية ودينية. رغم كل تلك المرارات بعضها تاريخي وبعضها الآخر آني مازال غالبية المسلمين الإرتريين يتبنى خيار التمسك بهذا الوطن، إلاّ أنهم أضافوا إليه وعياً جديدًا وهو حمايته من أي تغولات في المستقبل بضمانات دستورية. تمسك المسلمين بمثل هذا الخيار ناتج عن أنه أولاً هو الخيار الممكن من الناحية العملية في الظرف الراهن، بالإضافة إلى أنه يعزز وحدة المسلمين الداخلية التي ثبت تاريخيًّا أنها ليست مفيدة ومربحة للمسلمين وحدهم بل للوطن بأسره. آمل ألاّ يفهم من كلامي هذا انه دعوة للتمسك “بالوطنية الفجّة” التي تضحِّي بمصالح المسلمين كمجموعة قدمت في سبيل هذا الوطن وبقائه تضحيات جسام، بل إلى “وطنية حقة” تحكمها ضوابط وقابلة للمراجعة من أساسها إذا اقتضت الضرورة، خاصة وأن الشريك الآخر في هذا الوطن ما زالت غالبيته تتمسك ببقاء النظام الحالي على اعتقاد أنه يحمي مصالحهم العليا وتفوقهم، رغم أن الكثيرين منهم طالتهم مساوئ هذا النظام، وإذا لم يتمكنوا من إبقاء هذا النظام فهم حريصون على عدم التفريط في المكاسب القومية التي حققها لهم هذا النظام حتى في حال زوال رأس النظام. شخصيًّا كنت متحمسًا في الفترة الماضية لفكرة مقاربة قضية الهوية الجامعة من باب انتمائي “الإسلامي-الإرتري” إلاّ أن مراجعة لمواقفي وفهمي السابق لهذه القضية تملي عليّ أن أمارس نقدًا لهذا الفهم وتطويرًا لأدواته وآلياته، دون التنازل عنه كمرتكز للهوية الوطنية الجامعة التي تساعدني على العمل مع الآخرين، والتعايش معهم في إطار أوسع وأكثر مرونة مما كان في السابق. ما حدث في هذه المراجعة النقدية لفهمي لذاتي وانتمائي هو أن الدفاع عن هويتي الخاصة سواء أكان ذلك في الجوانب الثقافية أم السياسية أم القانونية ممكن فقط في بيئة ديمقراطية جامعة تراعي التنوع وتحترمه وتقنن لأسس التعايش السلمي التي تحكمه، وتمكِّننا جميعًا من الدفاع عن هوياتنا الخاصة بعيدًا عن الانغلاق أو الانزواء الذي يظهر صاحبه ذو النزعات الانعزالية قويًّا ومتماسكًا ظاهريًّا ولبعض الوقت، لكن هذا الانعزال والانغلاق يقتل صاحبه على المدى البعيد. التاريخ يعلِّمنا أن الهويات القوية هي القادرة على الانفتاح على الآخرين، والانتفاع بما لديهم من حسنات، والتفاعل معهم، وإعطاؤهم والأخذ عنهم بالقدر الذي لا يضر بثوابتها (مع الإقرار بنسبية مفهوم الثوابت هذا). هنا تحضرني قضية في غاية الأهمية يطرحها الداعية والمفكر السعودي الدكتور/مازن المطبَّقاني، وهي “ثقافة الاعتزاز بالإسلام” التي نحن اليوم كمسلمين إرتريين بأمس الحاجة إليها، خاصة وأن العصبيات الضيقة آخذة في الانتشار السريع في أوساطنا، وذلك حتى يسترجع المسلمون الإرتريون ثقتهم في أنفسهم وفي اتنمائهم الثقافي “العربي-الإسلامي”، شريطة أن يكون ذلك بعيداً عن أي تعصب ممقوت الذي نستنكره نحن الآن على شركائنا في الوطن. بل نحن بحاجة إلى اعتزاز متوازن وواع لايتغول على حقوق الآخرين، ويدافع بصلابة عن حقوقه المشروعة. هناك منحى واضح لدى قطاع كبير من سياسيينا ومثقفينا لوضع مكونات الوطن في ثنائيات تبسيطية رغم معرفتنا بأن المسألة أعقد من الطرح التبسيطي بكثير. واحدة من الإشكاليات الأساسية في هذا الشأن أيضًا هي عدم امتلاكنا لمؤسسات تساعد على إنتاج المعرفة وضمان استمراريتها وتراكمها وتطويرها. ولو نظرنا بكل بساطة إلى ما أنتجته الثورة الإرترية من وعي وإمكانات، كانت تطمح إلى تجاوز تلك الثنائيات التبسيطية وفي طريقها إلى خلق ثنائيات تكاملية، نرى أنها ذهبت أدراج الرياح وتم هدرها وهدمها لغياب مؤسسات ترعاها وتطورها، ولم تتمكن السلطة الحالية من القيام بهذه المهمة لخلل واضح فى بنيتها وفلسفتها المعادية لمثل هذا العمل الإنساني المتطور الذي يحتاج إلى حرية وديمقراطية لا تتوفر حتى هذه اللحظة في بلادنا. موقفنا المتشكك تجاه الثنائيات التبسيطية لا يعني إطلاقًا أن ننفي أن تاريخنا الوطني حافل بصدام الهويات بين مكوناته المختلفة، كانت تأخذ أحيانًا شكلاً طائفيًّا وهذه أخطرها، بينما كانت تأخذ أحيانًا أخرى شكلاً قبليًّا أو إقليميًّا، وهذه رغم خطورتها أيضًا، إلاّ أنها يمكن معالجة آثارها بصورة ربما أسهل من الصدام الطائفي. النخب السياسية والثقافية الارترية لم تتمكن من اختراق الحواجز النفسية، رغم أن مهمتها هي الدخول فى حوار فيما بينها، باعتبار أن النخب عليها مسؤولية ولها دور بارز وطليعي تلعبه في مجتمعاتها. هناك غياب في التواصل بين النخب السياسية سواء أكانت في السلطة أم المعارضة، ثم هناك غياب تواصل على مستوى آخر بين النخب السياسية والثقافية، لما للثقافة من أهمية في خلق التفاؤل حتى في أحلك الظروف، وأنسنة السياسة وإلاّ تحولت السياسة والسياسيون إلى وحوش كاسرة. العجز الذي تم الحديث عنه سابقًا في إنتاج المعرفة وضمان استمراريتها وتراكمها وتطويرها ليس بالضرورة مسؤولية المؤسسات ويتم فقط في إطارها رغم أهمية وجود المؤسسات التي يمكن في بعض الأحيان أن تأتي كخطوة لاحقة تمليها ضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه، لكن حركة المجتمع الثقافية والسياسية نفسها التي تعتبر الدينامية في إنتاج هذه المعارف في أشكال إبداعية متنوعة قد تعطلت هي الأخرى لدينا، نتيجة التقهقر والانزواء في هوياتنا وذواتنا الضيقة، والاعتقاد بأننا مكتفون ذاتيًّا ولا نحتاج للآخر، بل يصل الأمر أحيانا إلى نفي الآخر أو إدخاله في وعي مزيف (عدونا هو هكذا لا يمكن إصلاحه أو مساومته أو الدخول في حوار خلاّق معه، وبالتالي كان وما زال وسيبقى إلى الأبد عدوًّا رغم العيش معه فى وطن واحد). هذا المنطق ناتج عن أمرين، أولهما إراحة النفس من تحمل عناء ومشقة البحث عن حلول راسخة لمشكلات حقيقية، وهذه تتطلب بالطبع جهودًا مضاعفة، إضافة إلى الاعتقاد بأننا مكتفون ذاتيًّا ولا نحتاج لهذا الآخر، وهذه مكابرة غير واقعية وسوء تقدير للقدرات الذاتية لا تحمد عقباه على المدى البعيد. السودان مثلاً يعتبر مثالاً جيدًا لانكسار مقولة الاكتفاء الذاتي هذه، وهو متجه الآن باتجاه حل معضلاته الحقيقية بعد الإقرار بها والاعتراف بأن مكوناته بحاجة إلى جهودها المشتركة جميعًا لخلق سودان جديد، فهل تحتذي إرتريا حذو هذا البلد المجاور، رغم أن سفينة التجربة السودانية نفسها تمخر في عباب بحر مائج . بقي أخيرا أن نتحدث عن إشكالية التجربة الإرترية فيما يخص التعددية السياسية التي كان من المؤمل أن مجرد الإقرار بالتنظيمات المتعددة بعد الاستقلاال مباشرة وإشراكها في العملية السياسية كانت كفيلة بنقل المجتمع الإرتري إلى حياة سياسية ديمقراطية تعددية. لذا، ما يزال هناك من يعتقد أن المشكلة هي عدم اعتراف السلطة السياسية القائمة بهذه التنظيمات والحوار معها وإشراكها في السلطة وفي تحمل مسؤولية إدارة البلاد. أنا شخصيًّا أشك في أن هذا الحل كان ممكنًا، أو أنه السبيل الوحيد للوصول إلى التعددية السياسية، وشكي هذا ناتج عن أن السلطة السياسية (سلطة الجبهة الشعبية) لم تكن مؤهلة لقيادة مثل هذا العمل. لكن المشكلة لا تكمن في هذا الأمر وحده، بل إن التنظيمات السياسية الإرترية تمسكت هي الأخرى شكلاً ومضمونًا بميراثها الثوري من فترة الكفاح المسلح، وهذا لم يكن عيبًا في حد ذاته، لكنه أظهر بصورة واضحة عدم مقدرتها على مواكبة التغيرات البنيوية الكبيرة التي طرأت على إرتريا، وبالتالي أفقد هذه التنظيمات قوتها وحيويتها وقدرتها على التعاطي مع الواقع الجديد بشكل خلاّق ومبدع. إرتريا بحاجة إلى تعددية جديدة ومن نوع آخر خالية من عبء الماضي، ولا تتحمل فشل التعددية السابقة في التنظيمات والتيارات السياسية المختلفة في الساحة الإرترية. والبحث عن هذا الطريق هي مسؤولية مشتركة للقوى السياسية والمدنية الإرترية على حد سواء.