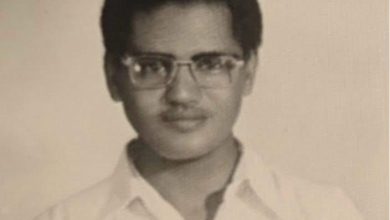بعض شواهد عما بين ارتريا والسودان
بقلم/ عمر جعفر السوري

هشيم الذاكرة …
صدرت كتب عددا عن إرتريا و تاريخها و ثورتها و قضيتها باللغة العربية، من بينها – على سبيل المثال لا الحصر – ما كتبه الزعيم الإرتري الراحل، عثمان صالح سبي، “تاريخ إرتريا” و آخر كتبه استاذ القانون الدولي المساعد بجامعة دنقلا، علي عباس حبيب، “إرتريا عبر التاريخ”، و غير ذلك، لكن العلاقات السودانية – الإرترية بتفاصيلها بقيت مهملة حتى اليوم، ما تناولتها الابحاث و الدراسات بعد بصورة مستفيضة، رغم أن اثارها لم تزل وستظل واضحة المعالم في تربة البلدين، وستبقى مساراتها تسهم في تقرير مصير الشعبين ورسم حدودهما الجغرافية، وهو ما يبدو قيد الاجراء اليوم بغير إرادة اصحاب الارض والقوى الفاعلة في كلا القطرين، وقد بلغ الوهن بهذه القوى في يومنا هذا درجة قيد حركتها والغى فعلها و قدرتها.
هنا سأسرد بعض ما شاهدت وقليل مما شهدت، ولُمعاً مما سمعت من أفواه ثُقات كانوا من صانعي الحدث، أو شهوداً عليه أو قريبين منه، وسأترك البحث والتحري والتوثيق والدرس للمتخصصين، الذين أدعوهم الى رصد ذلك لأثره العميق في مجرى الاحداث في السودان اليوم فضلاً عن إرتريا والقرن الافريقي، وفيما سيتمخض عنه في مقبل الايام. ومن بين الاحداث والمؤثرين فيها، التي أرجو أن يقفوا عليها وعندها طويلاً، تلك التي جرت قبيل الحرب العالمية الثانية مباشرة وفي أعقابها وحتى اللحظة. بعضها يتذكره الناس وفي حلوقهم غصص كهياج الجنود السودانيين، الذين دخلوا اسمرا مع جنود الحلفاء، واستباحتهم العاصمة الارترية ذات يوم، وقتلهم الناس دون تمييز بعد خلاف فردي جرى بين جندي سوداني وأحد المواطنين الإرتريين من غير المسلمين، وأخرى ما زالت تضئ دروباً وتفتح آفاقاً. و لعل الدور الذي لعبه الصحافي و الأديب السوداني حسب الله الحاج يوسف “ود محلق” حينما دخلت القوات الايطالية الى مدينة كسلا، شرقي السودان، ظل مبهما الى يومنا هذا، و أخشى أن يكون قد طواه الثرى الى الابد مع جسد الصحافي الراحل الذي بقي بيننا قرناً من الزمان أو يزيد و نحن في غفلة عنه، ثم أدواراً أخرى لضباط سودانيين تسلموا مقاليد الحكم فيما بعد في العام 1958 وبعضهم اقترن بإرتريات منهم الأميرلاي محي الدين أحمد عبدالله، واحداثاً كان في قلبها الشيخ علي بيتاي والشيخ كنتيباي وسواهما من شيوخ القبائل المشتركة وزعماء الطرق الصوفية وغيرهم.
وليس الحدث السياسي وحده الذي يستحق المراجعة والاهتمام بل مجمل الفعل الانساني الذي قام به تجار ومهربون ومغامرون أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها مثل علي درمه وحمد التلب وابراهيم المقبول، الذي أغرته اثيوبيا أكثر فرحل اليها، وبكري جعفر الذي بقي في ارتريا معاصراً الايطاليين والبريطانيين والحكم الوطني في الإطار الفدرالي وهيلي سلاسي ومنقستو هيلي مريام ثم اسياس افورقي. تغيرت الاحوال وهو لم يتغير، أتت وغادرت نُظم وجيوش ثم جاءت غيرها وهو ما برح يتاجر، يرصد حركة القادة والمقاتلين القادمين من وراء الجبال والتلال والسهول يحطون رحلهم في نُزل امباسيرا المواجه لداره، أو أولئك المغادرين وهم يحزمون امتعتهم على عجل في رحلة بلا عودة، الى أن توسد الثرى هناك؛ وبينهم صاغة لبوا جميع الاذواق، أكانت للمواطنين على مختلف عقائدهم وأصولهم أو لأبناء وبنات الجاليات التي سكنت البلاد وبعضها توطنت. أحدث هؤلاء الصاغة اثراً لا تخطئه العين في ذائقة عملائهم وتركوا بصمتهم حتى اليوم في تصاميم المشغولات الذهبية والفضية، وكان من أبرز هؤلاء الصاغة أولاد تبيدي الامدرمانيين الذين بقي منهم الحاج أبو القاسم تبيدي ردحاً طويلاً من الزمن بعد أن عاد أشقاؤه الى امدرمان مرة اخرى. ومازالت تصاميم الحاج أبو القاسم ونقوشه تطبع ذلك الذوق وتميّز الارتريات دون غيرهن؛ كذلك معلمين انتدبتهم الادارة العسكرية البريطانية بعد اندحار ايطاليا الفاشية بينهم الاخوة الثلاثة عبدالله والرياحي وجعفر أبناء الشريف عمر السّوري، والاستاذ محمد حسين الذي آثر البقاء في تسني حيث توفي ووري الثرى، وكان قد طلق العزوبية واقترن في أيامه الاخيرة بسيدة ذات اصول حجازية من آل سُنبل، ولدت وعاشت في ارتريا الى أيامها الاخيرة. وقد نعت الأستاذ محمد حسين صحيفة الزمان التي كانت تصدر باللغة العربية ورصيفتها الصادرة بالتقرينية، لكن إلكوتيديانو ارتريو “إرتريا اليومية” باللغة الايطالية – وهي الاوسع انتشاراً والاكثر توزيعاً – لم تشر الى وفاته. ربما يعود ذلك الى أن قراءها هم من ابناء الجالية الايطالية الكبيرة حينئذٍ ومن المتعلمين الإرتريين الذي تربوا في المدارس الايطالية، ثم تمطوا – ما شاء الله لهم أن يتمطوا على كراسي الادارة بعد خروج الايطاليين مندحرين – ويستحوذوا على الخدمة المدنية. كانت الايطالية هي لغة الادارة في الدواوين الإرترية، لا سيما البلديات الى منتصف الستينيات وربما بعدها بقليل. و كذلك أثّر مهندسون شقوا القنوات في غربي إرتريا، كان على رأسهم زعيم الحزب الجمهوري، الاستاذ محمود محمد طه الذي لم يكتف بعمله الهندسي، بل تطوع في حملة يخلّص بها مجتمع تلك السهول من عادات و موروثات بالية مثلما دأب على فعله في السودان؛ و بينهم مطربين منهم الحاج محمد أحمد سرور، الذي توفي هناك و دفن في العاصمة الإرترية، أسمرا، و الموسيقار اسماعيل عبد المعين، و المطرب و الملحن التيجاني السيوفي الذي لم يعد يذكره أحد في بلاده و هو الذي لحن و غنى خريدة حسن دراوي “الندامى” التي شدا بها من بعده كثر أبرزهم الخير عثمان:
أدر الكأس على العشاق صفواً ومدامه يا حبيب القلب والروح ويا روح الندامى
أيها الرافل في مجد من الحسن دوامـا ماست الأغصان لما عشقت منك القواما
لقد بلغ من طرب الناس هناك بالتيجاني واحتفائهم به أن وصّى له البلاتا سليمان تامر، من أعيان مصوع، بعود من مصر موشى بالعاج والذهب ومطّعم بالفسيفساء، كلفه خمسين جنيهاً ذهبياً من جنيهات جورج الخامس في أربعينيات القرن العشرين. ثم غادر السيوفي الى جيبوتي الى أن استقر في عدن نجاراً يصنع المراكب، ليس خشية من الطوفان أو انتظاراً له. كذلك دور الغانيات اللائي أردن المجد فولجن لعبة التنقيب عن المعلومات و استخراجها من الجنود والضباط البريطانيين وحلفائهم أفارقة وهنود و من ثم بيعها مقابل الاصفر الرنان لمن يدفع أكثر، لكنهن رحلن عن الفانية فقيرات معدمات، أشهرهن نفيسة حسين، تلك الفارعة الطول، تحسبها طوداً شامخاً، جهيرة الصوت، تحمله الريح من عداقه بعراي حتى جزيرة مصوع، إن استبد بها الغضب، لكنها توفيت ضريرة في ذلك الحي الذي ردد صدى صوتها بالقرب من مقبرة قتلى الحرب الايطاليين في نهاية شارع كلابريا ، ظلت تأبي أن يقودها أحد، تتعرف على الناس من وقع أقدامهم – و هم حفاة – قبل سماع صوتهم، و تعرف الاماكن المحيطة بها و النقود و العملات الورقية معرفة يقين العين، يظنها الغريب مبصرة حينما يرى عينيها الواسعتين المحدقتين في اللانهائي و هي ترنو من علٍ!
وغير هؤلاء وتلكم، أعداد من رجال الشرطة الذين بقي قلة من ضباطهم في هذا السلك حتى منتصف ستينيات القرن العشرين يطاردون الثوار الإرتريين بحسبانهم قطاع طرق “شفتا”، بعد أن نقلوا بنادقهم من كتف نافح عن البريطانيين ثم الحكومة الإرترية إبان الفدرالية الى كتف الاحتلال الاثيوبي.
وفي مرحلة تقرير المصير في اربعينيات القرن الماضي لم يتوان بعض السودانيين من الانغماس في تلك المعركة بكل جوانبها السياسية والثقافية والاجتماعية، فها هو جعفر السَّوْري ومحمود الربعة يؤسسان جريدة “اسمرا الاسبوعية” التي سرعان ما أغضبت الادارة العسكرية البريطانية فأغلقت الصحيفة وأبعدت جعفر السَّوْري الى السودان ليلتحق الى حين بحوار أبيه، الشيخ على بيتاي، في مشروعه التنويري والاصلاحي المشع من همشكوريب. وكان جعفر السَّوْري قد أسهم، قبل ذلك، مع عديله المحسن الإرتري الكبير والسياسي الوطني الثري صالح باشا كيكيا في تأسيس مدرسة حرقيقو، بالقرب من ميناء مصوع، التي لعبت دوراً رائدا في الحفاظ على اللغة العربية ونشر التعليم والوعي الوطني، إذ كان من بين تلاميذها ثم معلماً بها ثم مديراً لها القائد الإرتري الراحل، عثمان صالح سبي. وكان سبي قد حدثني كثيراً عن دور مدرسة حرقيقو في الحركة الوطنية الإرترية مما يجدر تسجيله في غير هذا الموضع. وحرقيقو لم تكن قرية بداوتها تبدو، بل بلدة ترفد البندر بحاجته من العنصر البشري المؤهل. مما يذكر للباشا أيضاً موقفه الحاسم في انهاء النقاش عن اعتماد اللغة العربية لغة رسمية اثناء المداولات التي جرت في البرلمان الإرتري حول مشروع الدستور الذي وضعته الامم المتحدة بناء على قرار فدرالي ربط بين أثيوبيا وإرتريا في اتحاد قسري، وصفه مندوب الاتحاد السوفيتي حينذاك، اندريه قروميكو، قبيل صدوره “بانه زواج كاثوليكي بالإكراه”.