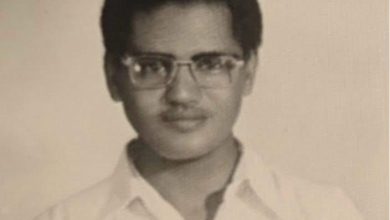بائع الصحف الجوّال. بقلم/ عبدالقادر حكيم
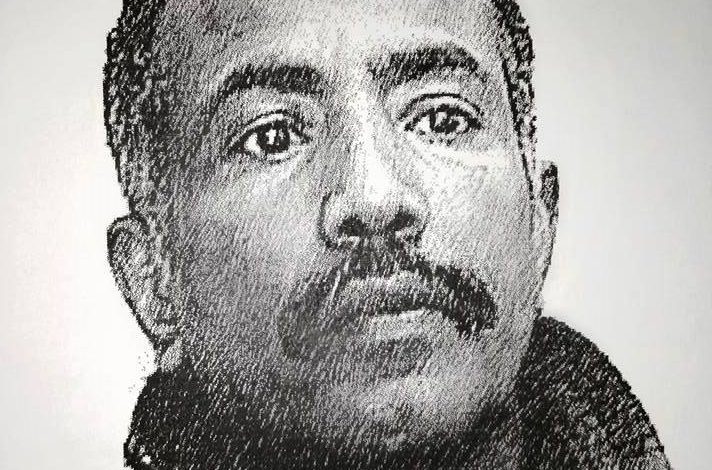
26-Mar-2018
عدوليس ـ ملبورن
كان نحيلاً من غير سوء، أسود اللون، ربعة.. ليس بالطويل ولا بالقصيرِ.. التقيته للمرة الأخيرة عام 1993م في عاصمة إقليم سنحيت، ولا أذكر الشهر،، لكنّه، أي الشهر، ربما كان مارس أو أبريل.. لأنّ أشجار وورود الشوارع والحدائق في تلك المدينة الجميلة كانت تفوح بالأريج. تبادلنا السلام، وتحدثنا قليلاً عن كسلا وعرفت منه أنه ترك عمله هناك كبائع صحف متجوّل، وأنّه عاد إلى الوطن للمشاركة في بنائه وتعميره. سألني عن مكان اقامتي في المدينة وقلت له أنني أقيم في مدرسة الفجر الابتدائية، بشكل مؤقت، وسأصعد غداً إلى بلدة حلحل لزيارة أقاربي هناك، فأخبرني أنه أيضاً يقيم في ذات المكان منذ ليلتين اثنتين، وأنه أيضاً، مثلي، سيغادر كرن غداً إلى العاصمة أسمرا.
تركته مع رفاقه الثلاث، وذهبتُ إلى حال سبيلي.. وكان سبيلي مفروشاً بالأحلام الباذخة من شاكلة أنّ بلادي ستؤول إلى سنغافورة أخرى،، أو كما كان يحلو للحالمين الكثر، من أمثالي، القول ( سنغافورة افريقيا).. وكان سبيلي لا يكاد يسع غبطتي بالانجاز الكبير لشعبي، صانع المعجزات، فكنتُ أمشي كما لو أنّي أحلّقُ! على الطرقات الفرعية، داخل الاحياء والأزقة التتبعثر في فوضى ،، التصعد، التهبط، التتقارب بيوتها في حميمية البيوت الموغلة في البساطة. في مساء ذات يوم لقائنا، جاء لزيارتي في مبنى ملحق بالمدرسة، حيث أقيم، وكان معي ابن عمّي موسى، وشخص آخر إسمه أحمد – إن لم تخنّي الذاكرة – وأحمد هذا، مقاتل وُلدَ ونشأَ وتربّى في الخرطوم، وهو شخصية روائية بامتياز.. لا أدري أين هو الآن؟.. هل ما يزال يعيش كالميّت، في البلاد؟ ـ لأنّي أوقنُ تماماَ أنّ مثله لن يسمحَ لروحه المقاتلة أن تتبلّدَ ـ أو هو في تلك الأقبية اللعينةِ، محاصراً بالجندِ المدجّجين بالكلاشينكوف، وبالجدرِ اللعينةِ في وطنٍ أضحى من أقصاه إلى أقصاه سجناً كبيراً، أو ربّما طاله خيار المنافي أو تايتانيكات كهال ؟. سأحاول الكتابة عنه، إذا كتبَ الله لي العُمر. قال لي زائري.. بائع الصحف السابقِ، الذي لا أذكرُ إسمه حتى ولا كُنيته، قال لي: ” سنصعدُ غداً إلى العاصمة كما أخبرتكَ، وربّما ستطول (مأموريتنا).. قالها لي هكذا مأموريتنا.. كما يقول الجندُ في العامية السودانيةِ ( مأموريّة).. وأعتقدُ أنّها مشتقة من الفعل أَمَرَ، فالجنودُ مأمورين، كما نعلم. قبل أن أردّ عليه سوى بتلك الابتسامة المتواطئة، طلبَ منّي أن أعيرهُ كتاباً، على أن يلتزمَ بإعادتهِ إليّ قبيل صعوده إلى ( الأورال) * صباح اليوم التالي.. كانت بحوزتي حينها مجلّة الكرمل، دفعتُ بها إليه دون تردّد ـ رغم ندرة الكتب والمجلاّت في البلادِ حينها ـ تلقّتْ يدهُ اليمنى المجلّة ( ما فائدة هذه التفاصيل الآن؟!).. وأشرقتْ في عينيه السوداويتين شموساً غير منجابةٍ كما يقولُ الغالي صالح. مضى إلى حالِ سبيله.. وكانت سبيله ـ كما اتضح لي بعد ذلك ـ أكثر بذلاً وعطاءً عن تلك التي كانت لي.
تأجّلَ موعد صعودهم إلى عاصمة البنفسجِ حتى منتصفِ النهارِ، نهار اليوم التالي، وكنتُ قرّرتُ ـ ليس بسبب انتظاري له / للمجلّة ـ أن أؤجّلَ صعودي لحلحل ليومٍ آخر. هطَل علينا بابتسامةٍ كتلك التي لمسافرٍ بُعيد وصوله إلى وجهتهِ.. أو كما يصفُ محمد مدني حبيبته :
” يا أنتِ يا عبقَ الحجارةِ
يا تباشيرَ الوصول”
مدّ إليّ المجلّة، يعيدها إليّ.. ليس ذلك فحسب، إذ أخذ يقرأ لي من ذاكرته قصيدة لمحمود درويش كانت ضمن ذلك العدد، وكانت تلك القصيدة الشهيرة والموسومة بـ ( من فضّة الموت الذي لا موت فيه).. استطاع أن يحفظ قصيدة بذلك الطول، في ذاكرته، من ألفها إلى يائها، في فترة لا تتجاوز بضع ساعات!!!!.
بعد أن وضعت الحرب أوزارها ، وكنتُ جالساً قُبيل الغروبِ، أحتسي قهوتي في بلدة قونية، في انتظار سيارة تقلني إلى بارنتو، بلغني نبأ استشهاده في تلك اللعنة!. أذكرُ أنّ عينيّ العصيّتين على الدمعِ قد دمعتا.. وأذكرُ أنّي تذكّرتُ شطراً لبيتٍ شعريّ لحامد عبد الله واستعصى عليّ شطره الآخر!.. كما ردّدتُ بين دموعي أبياتاُ من تلك القصيدةِ التي حملها معه إلى قبره:
” هل هكذا التاريخ لا يروي سوى سِيَر الملوك الناجحين ؟
دافعت عما لا أراه ، ولن أراه ، ولن أراه ، وعن سرير العاشقهْ
دافعت عن شجرٍ سيشنقني إذا ما عدتُ من لغتي إليهْ
دافعتُ عمّا كان لي . ويفرّ مني حين توقظه يدايْ
دافعتُ عما ليس لي . وسأستطيع إذا استطعت سأستطيع
أن أرجع الماضي إلى ماضيهِ، أن استلَّّ موعظة الجبل “.
————————————————————-
هامش:
ـــــــــــــــــــ* أورال: شاحنة نقل عسكرية روسية الصنع.