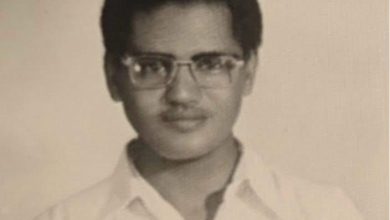حول مقاربات العودة والإصلاح السياسي
بقلم /عبدالرازق كرار

لقد خلقت حالة الحرب التي تفجرت في إثيوبيا في نوفمبر من عام 2020م، واستمرت لعامين كاملين قبل أن تتوقف في نوفمبر من عام 2022م، والدور الإرتري في هذه الحرب، حالة من الانقسام وسط المعارضة الإرترية وتسببت في حالة من الشلل لمنظماتها ومظلاتها. وبالمقابل خلقت حراكا موازياً تبنى أطروحات العودة إلى الوطن كشرط أساسي للتغيير، أو الدعوة الى الإصلاح السياسي الذاتي للنظام بحكم أن إرتريا تعيش الآن مرحلة مختلفة عمّا سبقها تضاءل فيها الخطر الوجودي؛ وهو ما يقتضي الدفع بالاستحقاقات التي كانت مؤجلة بسبب هذه المهددات. وإذا ما تجاوزنا أنصار النظام الإرتري المعروفين والأسماء المستعارة التي تروج لهذه الأطروحات، فإن عدد من أصحاب الرأي والمواقف المعارضة التي لا يمكن الشك في مواقفهم تبنوا هذه الأفكار أيضاً، وقد خلقوا بذلك حراكاً ربما كانت الساحة بحاجة إليه في ظل حالة الركود والتوهان التي كانت السمة الأبرز للساحة في السنوات الفائتة. إن مواقفهم المعارضة التي يصعب التشكيك فيها، ومثابرتهم على طرح هذه الأفكار خلال هذه المرحلة في أجواء أقل ما يمكن أن يقال عنها هي سلبية للغاية، هو مما يحسب لهم ويستدعي التعاطي مع هذه الأطروحات بشكل جدي، وفي هذا الإطار تأتي هذه المحاولة.
بادئ ذي بدء لابد من التأكيد أن العودة للوطن هي حلم كل إنسان يعيش خارج وطنه، وهي بالتالي حلم كل إرتري دفعته الظروف لأن يكون لاجئاً في دول الجوار أو المنافي البعيدة، وهي بالتأكيد برنامج عمل لكل ناشط في العمل المعارض، لأن الغاية من نشاطه هو إحداث التغيير الذي يوفر ظروفًا مواتية لعودته وغيره الى الوطن، وإذ ترى معظم قوى المعارضة في الساحة الإرترية أن العودة تتطلب تهيئة ظروف مناسبة لتتحقق، بالمقابل يرى طارحوا فكرة العودة مفهوماً مختلفاً وهو أن العودة هي في حد ذاتها آلية من آليات التغيير في ظل انعدام خيارات بديلة من قوى المعارضة. وبالتالي الخلاف هنا ليس حول مبدأ العودة، بل في توقيت وظروف العودة، وحول ما إذا كان التغيير شرط لازم للعودة أم أن العودة ذاتها وسيلة من وسائل التغيير، بل وربما الوسيلة والوحيدة للتغيير وفق ما هو مطروح.
في تقديري تنطلق الدعوة للعودة للوطن بالمفهوم الآنف الذكر من منطلقين أساسيين متداخلين، أولهما على المستوى النظري هو رجاحة فرضية التغيير من الداخل على ما دونها من الفرضيات، والآخر على المستوى العملي هو غياب مقاربة متماسكة للمعارضة يمكن من خلالها تنزيل دعواتها للتغيير على أرض الواقع. وعلى سلامة منطلقات فرضية العودة المشار إليها أعلاه في بعدها التجريدي لكن لابد من الإشارة إن مقاربة العودة ليست مقاربة متماسكة هي الأخرى، وهى لا تعدو أن تعبّر في جوهرها عن حالة اليأس وتشكّل تمظهراً لضعف المعارضة وقلة خياراتها مما يشي بانغلاق أفق التغيير. إن عدم تماسك مقاربة العودة بشكلها الحالي يعود في تقديري الى عدة مآزق تعتري المقاربة في جوانبها النظرية والعملية، أفصلّها على النحو التالي:
المأزق المنطقي
إن عدم تماسك مقاربة العودة يبدأ من الضبابية حول الأسئلة الجوهرية المتعلقة بها مثل ما المقصود بالعودة؟ ومن المقصود بالعودة، وماهي الغاية منها؟ هل المقصود عودة طوعية دائمة بكل ما يعنيه مفهوم العودة الطوعية الدائمة، أم عودة جزئية في شكل زيارات لبعض الوقت أو بعض الأهل بشكل مستمر مما يسمح بإعادة عرى الارتباط بالوطن والتي تكاد تكون قد تآكلت لدى الكثيرين بسبب تطاول الغياب؟ ثم من المقصود بالعودة؟ هل المقصود كوادر الصف الثاني أو الثالث لقوى التغيير الذين بالضرورة غير معروفين للنظام أو لا يشكلون خطراً عليه وبالتالي تقل درجات الخطر المترتبة على عودتهم؟ أم المقصود الذين يحلمون بالتغيير دون الانتماء الى عمل منظم مدنياً كان أو سياسياً، ولا يشاركون في أي نشاط من هذا النوع؟ ثم ما هي الغاية من العودة، هل المقصود الوجود على الأرض لأن ذلك يشكل منطلق أفضل لإحداث التغيير، أم لأهداف بعيدة المدى وهي الوجود على الأرض في حالة حدوث التغيير بفعل عوامل السنن الكونية، أم القيام بعمل طليعي يساعد من هم في الداخل على تنظيم أنفسهم؟ ثم ما هي المكاسب المتوقعة من مثل هذه الخطوات وما هي التضحيات المحتملة؟ وإذا كانت العودة شرط للتغيير فهل هنالك عدد محدد مطلوب عودته حتى يشكل أساساً لمشروع التغيير وتبدأ عجلته في الدوران، أم هو أمر مفتوح له بداية، ولكن لا نهاية له؟ كل تلك الأسئلة تظل عالقة دون إجابات واضحة.
بيد أن المأزق المنطقي الأكبر في منطق المقاربة مرتبط بتوقيتها، والذي تزامن مع الحرب الأهلية في إثيوبيا ودور إرتريا المُختلف عليه في هذه الحرب. ذلك أن المقاربة تكاد تكون بكاملها قد أتت من المعسكر الذي كان يرى أحقية إرتريا المشاركة في هذه الحرب بسبب أن الجبهة الشعبية لتحرير تغراى كانت تشكل تهديداً وجودياً لإرتريا وقد عدّ بعضهم إن هزيمة الجبهة الشعبية لتحرير تغراى هو بمثابة الاستقلال الثاني، وأن الرئيس أفورقي كان حكيماً وموفقا وإن تقديراته للمخاطر والوجودية كانت سليمة، والآن تأتي هذه المقاربة في هذا التوقيت بحكم إن ما أجل أفورقي بسببه الإصلاح السياسي قد انتفى، وفي هذا الإطار تأتي الضرورة بالعودة للمساهمة في مسار الإصلاح أو الضغط من أجله.
وإذا تركنا جانباً قضية أحقية إرتريا المشاركة في الحرب من عدمه، فإن المأزق المنطقي هنا يتجلى في الاعتراف الصريح للبعض والضمني للبعض الآخر من متبني مقاربة العودة بحكمة أسياس أفورقي في تقدير المخاطر الوجودية المحيطة بإرتريا، وهو ما برّر في نظرهم (صراحة أو ضمناً) تأجيل أي إصلاح، بل ويبرّر اتخاذ إجراءات استثنائية مثل الحكم بغير شرعية أو دستور أو مؤسسات، واختطاف الآلاف دون محاكمات. وهكذا تقدم المقاربة صك الغفران لإسياس على ماضيه بكل ما يحمل من جرائم وخطايا. وهنا يتجلى المأزق المنطقي في الآتي: إذا كنت تعتقد أن أسياس كان أكثر حكمة وصوابية طوال العقود الثلاثة الماضية، وإن تقديراته فيما يتهدد إرتريا من أخطار وجودية كانت دقيقة وهو ما يبرر جرائمه وممارساته التعسفية طوال الثلاثة عقود الماضية، وهو ما يعني ضمناً أن المعارضة بما فيها متبنو المقاربة كانت مخطئة في تقديراتها، فكيف يمكن التشكيك الآن في تقديرات أسياس للمستقبل؟ إن من كان حكيماً وصاحب تقديرات دقيقة طوال ثلاثة عقود أجدر بأن يكون الأقرب للصواب في تقديراته للواقع والمستقبل مقارنة بمن كان مخطئاً طوال ثلاثة عقود. وبالتالي أليس الأجدر أن تنتظر صاحب الحكمة والتقديرات الدقيقة أن يعلن الوقت المناسب للعودة والإصلاح السياسي؟ وإذا كنت مخطئاً طوال الثلاثة عقود الماضية فما الذي يضمن أنك الآن أيضا لست مخطئاً كما كنت في السابق، وبالتالي دعوتك للعودة والإصلاح السياسي هي دعوة متعجلّة في ظروف غير مناسبة كما كانت طوال الثلاثة عقود الماضية؟
المأزق التطبيقي
في مؤتمر الشباب في دبرزيت في مايو 2012، اقترح عدد من المشاركين أن يزحف عضوية المؤتمر بالكامل الى الحدود الإرترية وهم يرتدون ملابس بيضاء ويحملون شارات بيضاء في ظل تغطية إعلامية دولية. حينها لم يجد المقترح تأييد الغالبية حيث لم يأخذه الحضور مأخذ الجد، ولكن تذكرت الموقف وأنا أتابع نداءات العودة. موقف دبرزيت إذا كان قد تم الأخذ به على الأقل يتضمن رؤية عملية تكاد تكون ملموسة وهي تحدي النظام سليماً ووضعه أمام خيارات صعبة وهى الرد العنيف أو السماح بالمرور، وفي الحالتين سيكون أصحاب المبادرة قد حققوا بعض ما اعتقدوه مكاسب بغض النظر عن الخطورة التي تحيط بها والكلفة العالية المتوقعة. بالمقابل تفتقد مقاربة العودة الحالية أي تفاصيل عملية عن طبيعة مسار العودة وما يليها من خطوات. وتتوالد الأسئلة دون إجابات، أسئلة عن كيف تسهم مثل هذه العودة دائمة كانت أو جزئية في مقاربة التغيير؟ هل سوف يسهم العائدون بشكل مباشر في تنظيم حراك معارض، أم المقصود الأهداف بعيدة المدى التي تسعى للمحافظة على التوازن الاجتماعي الذي اختل نتيجة ممارسة النظام طوال الثلاثة عقود من حكمه العضوض؟ هل هنالك قوى تغيير في الداخل تحتاج إلى مساعدات نوعية مطلوب توفيرها من الخارج وهو ما يقتضي العودة؟ أم أنه لا يوجد أملاً في الداخل وبالتالي المسؤولية بكاملها مناطة بالعائدين لقيادة عجلة التغيير؟ وهل تأتي العودة كخيار فردي، أم ضمن عمل منظم؟ وإذا كانت خياراً فردياً كيف تسهم في عملية التغيير التي تتطلب جهداً جماعياً منسقاً، وإذا كانت خياراً ضمن عمل منظم فأين هو هذا التنظيم الذي يقسم الأدوار وينسق بينها؟
أن مما لا شك فيه الارتباط بالوطن عاطفياً كان أو بشكل نفعي مباشر هو أمر محمود ومطلوب، لكن من منظور عملي فإن جعل العودة شرط للتغيير لا تدعمه تجارب عملية مماثلة، فالعائد بعد انقطاع يظل نسبياً غريباً في المجتمع المضيف، محدود الإطار، مرصود الحركة، وهو ما يجعل تأثيره في دولة أمنية من الدرجة الأولى مثل إرتريا صعب للغاية إن لم يكن مستحيلًا، هذا غير ما يمكن أن يتسبب فيه في كشف أي قوى موجودة في الداخل تعمل أو تأمل في التغيير بحكم محدودية إطار تحركه وسهولة رصد خطواته. ولا تتوقف الإشكالات التطبيقية لشرط العودة على ذلك، بل أن التصور في جوهره يشير الى ضعف الإيمان والثقة في شعبنا في الداخل، وكأنه شعب مسلوب الإرادة في انتظار المسيح المخلص المتوقع وصوله من الخارج، فالمؤكد إن عددًا مقدرًا من الشعب الإرتري لا يزال في الداخل وهو المتضرر بشكل مباشر من الممارسات القمعية للنظام وبالتالي صاحب المصلحة الأولى في التغيير، وسينتفض في اللحظة المناسبة عندما تتكامل الشروط. وبالتالي فإن مقاربة العودة كشرط للتغيير رغم أنها بنيت على منطلقات سليمة وهي حتمية التغيير من الداخل، لكن البناء على عنصر الخارج الذي يفترض أن يعود ليكون عنصراً أساسياً في مقاربة التغيير من الداخل هي مقاربة غير متسقة منطقياً وليست قابلة للتطبيق عملياً.
المأزق الأخلاقي
ويظل أكبر مآزق مقاربة العودة هو مأزقها الأخلاقي، ليس المتمثل في صك الغفران لإسياس أفورقي عمّا اقترفت يداه من جرائم مقابل تحييد المخاطر الوجودية كما تبرر المقاربة تصريحاً أو تلميحاً، ولكن يأتي المأزق الأخلاقي في أنه لا أحد من متصدريها لديه الاستعداد لخوض التجربة بنفسه، وهو ما ينسف كليات المقاربة. والتبرير هنا إن متصدري المقاربة شخصيات معروفة بمواقفهم المعارضة وإن كانت حقيقة مسألة الخطورة على العائدين المحتملين هي قضية نسبية ونفسية في ذات الوقت. غني عن القول إن الحياة في كل جوانبها تحتمل درجة من الخطر تقل أو تكبر وفق ظروف محددة، وما يقلل خطر الاعتقال في بلد محدد أو يزيده هو وجود القانون ووضوح القانون والتساوي أمامه، بحيث يعرف الشخص إنه إذا خالف القانون بغض النظر إن كان هذا القانون عادلاً أو ظالماً فإن احتمال تعرّضه للعقوبة كبير، ولكن في إرتريا فإن مفهوم القانون نفسه نوع من الرفاهية بعيد المنال، ومن اختطف أو اعتقل أو قتل في إرتريا فقد تم ذلك من غير قانون معلن، وبالتالي من الصعب الجزم بمن الذي يحتمل اعتقاله ومن الذي يقل عنده هذا الاحتمال، لأنه لا توجد معايير للقياس هنا، وكثير من المختطفين في إرتريا لا يعرف بالضبط سبب اختطافهم. إن المأزق الأخلاقي أمام متصدري المقاربة يتعاظم عندما ينأون بأنفسهم بسبب عظم الخطر، وفي الوقت نفسه يرغبون أن يخوض الآخرون غمار الخطر وفق تقديراتهم هم حول تحديد من تشكل له العودة أكثر خطورة أو أقل خطورة. ثم يأتي السؤال، ماذا لو عاد شخص بعد اقتناعه بالمقاربة ثم تم اعتقاله لسبب أو لآخر هل سوف يغمض جفن لمتصدري المقاربة؟ وهل يستطيعون ممارسة حياتهم بشكل عادي بعد ذلك، وهل يمكنهم النظر في عيون أطفالهم وهم يعلمون أن هنالك من لا يعرف مكان وجوده أو ذنبه أو مصيره؟ قد يقول قائل إن النضال يتطلب التضحيات، هذا صحيح، ولكن الأوفق أن يكون صاحب الفكرة في الواجهة طالما هو مقتنع بها، أو أن تكون في إطار عمل منظم تتقاسم فيه التضحيات، والأدوار، والمسؤوليات، والمكاسب.
خاتمة
إن مما لا شك فيه، إن قوى التغيير في الخارج في أضعف مراحلها، وبالتالي محاولات تجاوز هذه الحالة وإحداث اختراق عبر مقاربات نظرية أو مبادرات عملية هو أمر مطلوب، ولكن المبادرات المدفوعة بعوامل اليأس في غالبها تؤدي إلى نتائج عكسية بغض النظر عن النوايا الحسنة التي تحيط بها. إن احتفاء بعض كوادر النظام بمقاربات العودة لا تعني بالضرورة حرصهم على عودة من هم بالخارج، لأنه إذا كان ذلك هو المقصود فالأوجب هو تشجيع من هم في الداخل على البقاء، ومن ثم خلق ظروف مواتية لعودة من هم في الخارج، ولكن هذا الاحتفاء يستبطن هذا الاعتراف الصريح أو الضمني الذي تتضمنه المقاربة فيما يتعلق بدقة تقديرات إسياس وتبرير جرائمه وخطاياه طوال ثلاثة عقود تحت ذريعة الأخطار الوجودية التي تحيط بإرتريا. بالمقابل المعارضة قد تكون ضعيفة، ولكنها تناضل من أجل قضايا عادلة بغض النظر عن حجم التقدم الذي حققته في تحقيق أهداف نضالها، وكما القول المأثور (إن كانت القوة معهم، فليكن الحق معك) فالضعف وغياب المقاربات البديلة لا يستدعي التنازل عن الحق، وبالتالي مثل هذا التشويش الذي تخلقه مثل هذه المبادرات لن يغير من موازين القوى في الساحة الحالية، ولكنه سوف يخصم من موقفك مع الحق وضد الظلم، وهو تشويش آخر لا تحتاجه ساحة المعارضة الإرترية الضعيفة أصلاً.