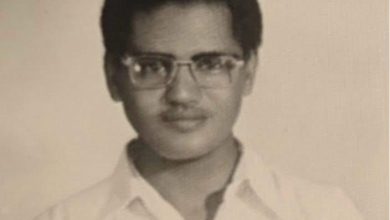رسالة ونداء الى مكونات المجلس الوطني.
من نجاح المؤتمر إلى مسؤولية ما بعده.
رسالة ونداء الى مكونات المجلس الوطني.

نكتب هذه الرسالة لا من موقع التنظير، ولا من مسافة مراقبة باردة، بل من موقع شاهد عيان حضر مجريات المؤتمر الثالث للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي كاملة؛ من جلسات التحضير الشاقة إلى ساعات النقاش الطويلة – إلى لحظات التوافق الصعب، وحتى إسدال الستار على مؤتمر نجح – سياسيًا وتنظيميًا – في أن ينعقد، وينهي أعماله، ويُقر وثائقه في ظرف وطني وإقليمي بالغ التعقيد.
نعم، نكتب هذا النداء في هذه الرسالة، وتمرّ قضيتنا الوطنية اليوم بلحظة فاصلة، لا تحتمل التباس الأولويات ولا ازدواج المرجعيات. وتأتي هذه الرسالة في سياق وطني إيجابي لا يجوز التفريط به، بعد النجاح الذي حققه المؤتمر الثالث للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي، سواء في مرحلته التحضيرية التي تطلبت جهدًا وتوافقًا ومسؤولية، أو في مجريات انعقاده، أو في ختام أعماله وإقرار وثائقه.
غير أنّ التجارب السياسية، وخصوصًا في مسارات التغيير الوطني، تُعلّمنا أن نجاح المؤتمرات لا يُقاس بانعقادها فحسب، ولا بإقرار وثائقها فقط، بل يُقاس أساسًا بقدرتنا على إدارة مرحلة ما بعد المؤتمر:
كيف نتعامل مع المخرجات؟ كيف نحوّل التوافق السياسي إلى التزام عملي؟ وكيف نمنع استنزاف الإنجاز في تكرار أنماط قديمة من الأداء؟
وهنا، تحديدًا، تفرض الأمانة السياسية قول الحقيقة كاملة، وإن أخطر ما يواجه أي مؤتمر ناجح ليس ما جرى داخله، بل ما قد يُفرَّغ من مضمونه بعد خروجه.
فمرحلة ما بعد المؤتمر ليست امتدادًا إداريًا شكليًا، بل هي الامتحان الحقيقي للجدية، والانضباط، والالتزام.
وهي المرحلة التي إما أن تُثبت أننا تعلمنا من تجاربنا، أو نعيد – بوعي أو بدونه – إنتاج إخفاقات سابقة بأسماء جديدة.
ومن هنا تنطلق هذه الرسالة، لتخاطب المؤشر الأهم لنجاح المؤتمر: القدرة على الالتفاف الجماعي ما بعد المؤتمر حول أولويات مرحلة التغيير الديمقراطي، والاحتكام الواعي لمرجعياتنا المشتركة، وترجمة ذلك إلى فعل مؤسسي منضبط يرصد الحقائق الأتية:
أولًا: لسنا في مرحلة تنافس على سلطة – أي علينا توصيف المرحلة السياسية الراهنة:
نحن، كمكونات سياسية ومدنية منضوية تحت مظلة المجلس الوطني، لسنا في طور التنافس على سلطة قائمة، ولا في مرحلة إدارة دولة بمؤسساتها، بل نحن في مرحلة تغيير وطني شامل.
ومن هذا المنطلق، فإنّ استدعاء الذاكرة البرامجية التنافسية، أو الاتكاء على التمايزات السياسية داخل المجلس، لا يخدم مقتضيات المرحلة، بل قد يخلق – ولو دون قصد – حالة من الترقب المتبادل، أو روح تنافس هلامية في ظل غياب الوطن والسلطة الشرعية للجميع.
إنّ التعدد البرامجي والسياسي هو ثراء طبيعي في أي فضاء ديمقراطي، لكنه يصبح عبئًا عندما يُستدعى في غير سياقه.
ففي مرحلة التغيير الديمقراطي، لا نحتاج إلى استحضار ذاكرة الاختلافات البرامجية، ولا الاستدعاء لدواعي ضرورة التعدد السياسي لتحرّك روح تنافس كامنة في فراغ وطني لا سلطة فيه ولا دولة.
من حضر كل الجلسات، واستمع لكل المداخلات، وعاين بدقة طبيعة النقاشات، يدرك حقيقة لا يجوز القفز فوقها، ألا وهي:
لسنا في لحظة ترف سياسي، ولا في ساحة تنافس برامج، ولا في سباق تموضع مبكر على سلطة غير موجودة أصلًا.
نحن في مرحلة تغيير وطني، عنوانها الواضح: إسقاط نظام أفورقي، وإنهاء الدولة المختطفة، وبناء دولة مدنية ديمقراطية دستورية.
وأي محاولة – ظاهرة أو مستترة – لإعادة استحضار التعدد البرامجي التنافسي داخل المجلس في هذه المرحلة، ليست اختلافًا صحيًا، بل خلل في قراءة المرحلة، وسوء تقدير لطبيعة اللحظة التاريخية.
ما نحتاجه اليوم هو تعليق التنافس المشروع، لا إلغاؤه، إلى حين اكتمال شروطه الطبيعية داخل دولة و حكومة شرعية منتخبة محمية بالدستور الوطني العام، ففي مرحلة التغيير يجب أن يُعلّق التنافس لصالح وحدة المرجعية التوافقية ميثاقية، لا أن يتحول إلى عبء على المسار المشترك.
ثانيًا: الميثاق السياسي هو مرجعية المرحلة:
لقد توافقنا، بإرادتنا الحرة، خلال هذا المؤتمر الثالث، على الميثاق السياسي بوصفه الوثيقة الجامعة التي تعبّر عن الحد الأدنى الوطني المشترك، وتحدد بوصلة مرحلة التغيير الديمقراطي وتشكل الإطار الناظم له.
وعليه، فإنّ الانتماء الحقيقي داخل المجلس في هذه المرحلة لا يُقاس بالبرامج التنظيمية أو الحزبية، بل بالالتزام الصادق بروح الميثاق ومقاصده، وبالعمل على تحويله إلى خطاب موحّد، وسلوك سياسي مسؤول، وممارسة يومية منضبطة.
الميثاق ليس نصًا للاستهلاك السياسي، بل عقدًا سياسيا وطنيًا مرحليًا، لا يستقيم العمل المشترك بدونه، و لذلك محن مطالبين أن نلتف متماسكين حوله و نكتفي به كمرجع تواثقي نهتدي به في هذه المرحلة – مرحلة التغيير الديمقراطي.
ثالثًا: النظام الأساسي… دستور العلاقة الداخلية
إنّ النظام الأساسي للمجلس ليس إجراءً إداريًا ولا لائحة شكلية، بل هو دستور العلاقة الداخلية بين المكونات والأفراد، وضامن التوازن المؤسسي، وآلية ضبط الأداء والصلاحيات والمساءلة.
والاحتكام إليه ليس خيارًا تكتيكيًا، بل واجبًا سياسيًا وأخلاقيًا، يحول دون الانزلاق إلى تشاكسات مصطنعة، أو إخلالات تنافرية عانت منها تجربتنا الوطنية في محطات سابقة، وأضعفت قدرتنا داخل هذا المجلس على تحويل التوافقات إلى إنجازات.
ومن موقع الشهادة المباشرة، نؤكد أن النظام الأساسي للمجلس لم يُقرّ ليكون حبرًا على ورق، ولا ليُستخدم انتقائيًا حسب موازين القوى أو مزاج اللحظة، هو دستور العلاقة الداخلية، وهو خط أحمر تنظيمي، وأي التفاف عليه، أو تعطيل لمقتضياته، أو قراءة انتقائية له، هو ضرب مباشر لفكرة العمل المؤسسي التي نرفعها شعارًا، فمن يريد العمل خارج النظام الأساسي، فليقل ذلك بوضوح، أما البقاء داخله ومخالفته عمليًا، فذلك أخطر من الخروج الصريح.
رابعًا: من القيادة التمثيلية إلى القيادة الفاعلة – أي ضرورة الانخراط الجماعي في العمل.
في هذا السياق، تتحمل القيادة المركزية للمجلس، المكوّنة من 61 عضوًا، مسؤولية خاصة ومضاعفة. فوجودها لا ينبغي أن يُختزل في الحضور الشكلي لاجتماعات القيادة، ولا في ممارسة التمثيل السياسي المجرد، بل في الانخراط العملي والحضوري داخل هياكل المكتب التنفيذي.
فالمطلوب هو الانتقال من التمثيل إلى الفعل – ومن الحضور إلى الأداء، ومن الموقع إلى المسؤولية، ولذلك علينا أن ندفع بالتكامل بين التنظيمي والحزبي وبين ما هو المشترك العام بيننا كمكونات للمجلس.
فكل من يعمل داخل تنظيمه أو حزبه في مجال العلاقات الخارجية على سبيل المثال، ينبغي أن يكون جزءًا فاعلًا في مكتب العلاقات الخارجية للمجلس. وكذلك من يعمل في الإعلام، أو الشؤون السياسية، أو التنظيمية، أو التخطيط، عليه أن يلتحم بدائرته المقابلة داخل هياكل المجلس، وهذا ينطبق على المنظمات الحقوقية والفئوية و المنابر الإعلامية .
بهذا النهج، يمكننا أنْ نحمي دوائر العمل من التهميش والارتجال، ونمنع الازدواجية بين العمل التنظيمي المنفرد أو الحزبي والعمل الوطني المشترك، وهذا هو ما جعلنا أنْ نوجد جميعا مشتركين تحت مظلة هذا المجلس، ونحن نعلم تماما ليس هناك تنظيم ارتري أو حزب مناوئ ومقاوم لنظام أفورقي يمكن أن يحدث هدف التغيير وتحقيق إسقاط هذا النظام بمفرده.
وعليه، دعونا نجعل الجميع مسؤولًا ومحاسبًا في آن واحد، بدل أن يتحول بعض أعضاء القيادة المركزية إلى مجرد جلساء تمثيل، وثم يتحولون إلى قضاة ومشرعين أو منتقدين فقط.
خامسًا: الكفاءة والتفرغ قبل الانتماء.
في مرحلة التحرر والتغيير الوطني، لا تُبنى القيادة على المحاصصة، ولا تُدار المؤسسات بمنطق التوازنات الشكلية، بل يجب أن نلتف حول الأصلح من حيث الجاهزية العملية، والتفرغ، والقدرة على الأداء، والاستعداد لتحمل المسؤولية، دون اعتبار لانتمائه التنظيمي أو الحزبي السياسي.
فالتكليف في هذه المرحلة ليس مكافأة سياسية، بل عبء وطني، لا يحتمله إلا من يملك الإخلاص والقدرة والاستعداد للتضحية.
ولذلك تعالوا نتصالح مع النفس ونعمل جميعا للتحرر من المعايير المتكلسة إذا كنا فعلًا أصحاب مشروع تغيير، فعلينا أن نتحرر من المعايير التقليدية المتبلدة التي تقيس الأدوار بالانتماء الجغرافي، أو الاجتماعي، أو الديني، فهذه المعايير لم تُسقط نظامًا، ولم تبنِ دولة، ولم تحمِ وطنًا.
ما نحتاجه اليوم هو إنسان عملي، صادق في التزامه، متفانٍ في أدائه، وفيٌّ لقضية التغيير، مستعد للعمل دون حسابات ضيقة، قادر للتضحية بإخلاص من أجل تحقيق مبتغى مرحلة التغيير الحالية التي نخوضها معا تحت مظلة المجلس الوطني.
خاتاما – من الشهادة إلى المسؤولية
هذه الرسالة ليست توبيخًا، وليست مزايدة سياسية، إنها شهادة مسؤولية من داخل التجربة، وتحذير هادئ لكن حازم من أن نجاح المؤتمر لا يُحصَّن إلا بالانضباط بعده – وعليه فلنحسم أمرنا بوضوح:
إما أن نرتقي إلى مستوى ما توافقنا عليه بوحدة الصف، أو نترك الباب مفتوحًا لتآكل الإنجاز من الداخل.
فوحدة الصف لا تُحمى بالصمت، بل بوحدة المرجعية، ووحدة المرجعية اليوم هي:
الميثاق السياسي، والنظام الأساسي، وهدف إسقاط النظام وبناء الدولة المؤسساتية و دولة العدالة الحريات – وذلك يتطلب منّا جميعا وضوح المسؤولية، وحسم السلوك – هذا هو معنى ما بعد المؤتمر – وهذا هو امتحاننا الحقيقي – فلنؤجل تنافس البرامج إلى زمن الدولة، ولنؤجل حسابات السلطة إلى زمن الشرعية، ولنحسم أمرنا الآن:
إما أن نكون أدوات تغيير حقيقية، أو شهودًا على إضاعته.