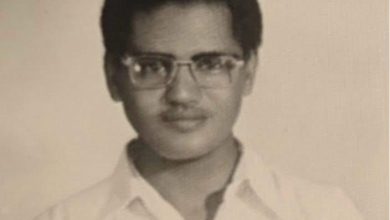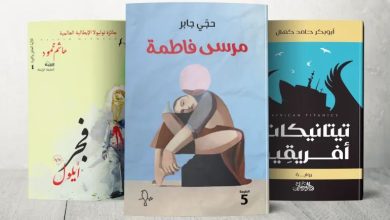مقالات
محاولة لفهم طبيعة النظام في إرتريا ..
عبدالرازق كرار

مرحلة التشريح:
- لا أعتقد أنها ستكون المرة الأخيرة التي يحتدم فيها النقاش في الساحة الإسفيرية الإرترية حول توصيف طبيعة النظام الإرتري، والذي طفا إلى السطح بشكل واضح عقب اختطاف النظام للشيخ آدم شعبان مدير معهد قندع الإسلامي وما تلاه من اعتقالات، وهو الحادث الذي أعاد إلى الأذهان سلسلة من ممارسات النظام ابتداءً من الاعتقالات التي طالت عددًا كبيرًا من العلماء والشيوخ في النصف الأول من تسعينات القرن الماضي، مروراً بمنح أراضي زراعية للكنيسة الأرثدوكسية في مناطق لا يزال معظم أهلها لاجئون في دول الجوار، هذا فضلًا عن بناء الكنائس في مناطق لم تعرف تواجد مسيحين ضمن سكانها الأصليين، وإذا أضفنا إلى ذلك تهميش اللغة العربية، ومصادرة الأراضي، وإعادة التوطين لبعض سكان المرتفعات في مناطق المسلمين، كلها ممارسات أوصلت البعض إلى التيقن بأن هذا النظام (طائفي) أي نظام (مسيحي أرثدوكسي) وهو استنتاج معقول ومقبول في شكله الظاهري، فهل فعلاً النظام يستهدف المسلمين، وهل في استهدافه للمسلمين ينطلق من خلفيته المسيحية الأرثدوكسية بما يجعله نظاماً طائفياً؟
- الإجابة المباشرة للجزء الأول من السؤال ودون مواربة هي نعم.. النظام يستهدف المسلمين، ولكن هل في استهدافه للمسلمين ينطلق من خلفيته المسيحية الأرثدوكسية؟ الإجابة ليس بالضرورة، وهذا ما يستدعي الغوص بشكل أعمق متجاوزين تمظهر السلوك إلى فهم الدوافع، وطبيعة ديناميكيات النظام، لأنه من غير فهم طبيعته بشكل جيّد، فإنه أيضًا يتعذّر مقاومته أو التخلّص منه.
- أولاً لابد أن ندرك أن استهداف النظام للمسلمين مفهوم، ويعود في جذوره إلى تصور أسياس أفورقي لمشروع الثورة والدولة في إرتريا، وهو ما يعيدنا إلى بدايات التحاقه بجبهة التحرير الإرترية، ومِن ثَّم تمرده عليها واعتكافه في عالا، وانتهاء بوثيقة (نحن وأهدافنا). أسياس كان يدرك جيّداَ إنّ المشروع الوطني الذي تتبناه جبهة التحرير الإرتري على الرغم من علمانيتها، أو ماركسيتها المعلنة، ولكنه في جوهره مشروع قاعدته الصلبة هي المسلمين الإرتريين، وإنّ محيطها الداعم هو المحيط العربي والاسلامي، ولهذا تبنى أسياس مشروع مغاير تماماً وهو مشروع تكون قاعدته الصلبة أو هويته الرائدة مسيحو الهضبة، وتتدرّج هذه القاعدة في صلابتها إلى المسيحيين الأرثوذكس إلى أن تصل في خطها الأفقي الأخير (مسيحي الهضبة الأرثوذكس الحماسين). ومشروع أسياس المغاير لمشروع جبهة التحرير الإرترية هو مشروع ذو بعدين متداخلين، البعد الأول يتعلّق بطموح أسياس الشخصي حيث أدرك إنّ فرصه في تحقيق طموحه الشخصي في القيادة لا يمكن أن يتحقّق ضمن مشروع جبهة التحرير الإرترية بقاعدتها الثقافية الاجتماعية، وحتى المعاملة التفضيلية التي وجدها من جبهة التحرير الإرترية كان متيقنًا تماماً، أنها هبة من الجبهة يمكن أن تعطيها وتسحبها متى ما أرادت، وأنها لا يمكن أن توصله إلى القيادة التي ظلّت حلمه منذ وقت مبكر، والبعد الآخر هو بعد قومي، ينطلق من تصوره للهوية القائدة لإرتريا سواء كانت دولة مستقلة، أو مرتبطة بإثيوبيا بشكل أو آخر. وتداخل البعدين المذكورين يتجلى في ضبابية أسياس التي تعمدها في تصوره لمستقبل إرتريا استقلالاً كاملاً، أو شكل من أشكال الوحدة من إثيوبيا، وهنا ظلّ تقديره لإمكانية تحقيق طموحه في نفوذ أكبر يتجاوز الدولة الوطنية الإرترية هو التير وموتر الذي حكم تصرّفاته، فعندما كان قوياً ومهيمناً في مطلع تسعينات القرن الماضي على نظيره في (الجبهة الشعبية لتحرير تغراي) طرح فكرة تشكيل الحكومة المشتركة بين التنظيمين والتي لو كانت قد تحقّقت فإن قيادة الحكومة المشتركة للدولتين ما كان يمكن أن تتجاوزه، وهو ما أدركه غريمه ملس زيناوي، وحاول إفشاله بشكل أو آخر، وقد ظهر ذلك مرة أخرى، في عام 2018م، عندما رأى عدم خبرة أبي أحمد، فعاد الحلم من جديد، طالبًا من أبي أحمد أن يقود الدولتين.
- إذن، ما كان لطموح أسياس ببعديه المذكورين أن يتحقّق في ظل وجود مشروع جبهة التحرير الإرترية، فكان لزاماً على أسياس أن يتخلّص من جبهة التحرير الإرترية ليس كتنظيم وحسب، ولكن أيضاً لابد من شل قدرات وتعطيل القاعدة الصلبة المساندة لمشروع جبهة التحرير الإرترية. إنّ إدراك هذه الحقيقة يجعلنا نفهم لماذا غدر أسياس مبكراً بالزعيم الراحل عثمان صالح سبي، حيث أدرك أن وجوده معه في ذات التنظيم ما كان سيسمح له بالوصول إلى موقع القيادة بالسلطات المطلقة التي تمتّع ولا يزال يتمتّع بها، وأيضاً نفهم لماذا فشلت كل محاولات الوحدة أو العمل المشترك بين الجبهة والشعبية، لأن أي مصالحة أو تنسيق مع الجبهة يعني عملياً تراجع مشروع أسياس، وابتعاده عن تحقيق طموحه، وهو ما يفسّر أيضاً وضع أسياس للعراقيل أمام عودة اللاجئين الإرتريين في السودان وصولاً إلى تصريحه، بأنه لا يوجد لاجئين إرتريين في السودان، وأن الموجودين في السودان موجودين في بلدهم، لأنه يدرك جيّداً إنّ استمراره في السلطة، واستمرار مشروعه المغاير لمشروع الجبهة لا يمكن أن يستمر إلا في ظل غلبة مسيحية أرثدوكسية في إرتريا، ليس بالضرورة من حيث العدد، ولكن من حيث الفاعلية.
- بعد أن حقّق أسياس طموحه ببعديه المذكورين عشية تحرير البلاد، كان لابد من أن يضمن الديناميكيات التي تسمح لهذا المشروع بالاستمرار، وتمثّل هذا في التقارب لدرجة طرح حكومة مشتركة من الجبهة الشعبية لتحرير تغراي والتي سبق وأن ساعدته في التخلّص من جبهة التحرير الإرترية وإخراجها من المعادلة من جهة، واستهداف المجتمع المسلم وذلك من خلال استهداف لغته وثقافته ورموزه وقياداته الدينية والمجتمعية، أي شل قدرات المجتمع المسلم، وجاء هذا متزامناً مع رفضه لأي مشروع للمصالحة ، أو الوحدة الوطنية، سواء كان ذلك النداء الوطني التي تقدّمت به عدة تنظيمات إرترية مطالبة أسياس بتجاوز مرارات مرحلة النضال وفتح صفحة جديدة تمكّن الجميع من الاسهام في بناء الوطن، أو تعطيل الحوار مع تنظيم جبهة التحرير الإرترية – المجلس الثوري الذي كان وفده يتأهب للسفر إلى أسمرا، عندما وصلتهم رسالة أسياس أفورقي أنهم غير مرحب بهم.
- إذن استهداف نظام أسياس للمجتمع المسلم، وكل القوى السياسية، أو الاجتماعية التي يشكّل هذا المجتمع قاعدتها الصلبة، ليس محل جدل، بل حقائق ماثلة، وإنكارها لا يعدو أن يكون كما يقول المثل (تغطية الشمس بالغربال)، ولكن هل هذه الحقيقة الساطعة تجعل النظام طائفياً؟ وهل وحدها كافية لتوصيف طبيعة النظام؟
- على اختلاف تعريفات النظام الطائفي، ولكن تبقى السمة الأساسية، أن السلطة الزمنية (السياسية) تكون فيه مسخّرة لخدمة السلطة الدينية، أي بمعنى أن مصالح الطائفة تكون مقدمة على مصالح الأفراد في السلطة السياسية، وأن القرار الحاسم والنهائي لتحديد هذه المصلحة، أو من يرعاها تكون إلى حدٍ كبيرٍ لدى السلطة الدينية أو سلطة الطائفة، أو بمباركتها على أقل تقدير، وأقرب مثال لذلك هو النظام السياسي في العراق خلال الأعوام الماضية، عندما كان القرار يتم اتخاذه في مكتب آية الله علي السيستاني أو بمباركته، أو النظام السياسي في لبنان حيث يكون القرار موزّع لدى القيادات الدينية خاصة لدى الطائفة المارونية حيث يصنع القرار أو تتم مباركته في (بكركي) أو الطائفة الشيعية حيث يتم طبخ القرار أو مباركته في الضاحية الجنوبية.
- بالمقابل عندما تكون السلطة الدينية في خدمة السلطة الزمنية (السياسية) فإن النظام يكون نظاماً دكتاتورياً يستخدم الطائفة في استمرار حكمه وتحقيق مصالحه، وفي هذا تقول البروفيسور (كونداليزا رايس) أستاذة العلوم السياسية في جامعة ستانفورد ووزيرة الخارجية الامريكية ومستشارة الأمن القومي في حكومة جورج بوش الابن في كتابها (الديمقراطية: قصص من الطريق الطويل نحو الحرية) (نادرًا ما يحكم الطغاة بالخوف فقط، بل لديهم طريقتهم الخاصة – المساومة التي تجعل من السهل السيطرة على السكان). أي إنّ الأنظمة السياسية الدكتاتورية وحتى تضمن استمرارها تصل إلى شكل من أشكال المساومة مع مكوّنٍ من مكونات المجتمع، سواء كان هذا المكوّن دينيًا أو اجتماعيًا أو طبقيًا ومقابل استمرار النظام الدكتاتوري في السلطة، فإن هذا المكوّن يتمتّع بامتيازات لا تتمتّع بها المكوّنات الأخرى.
- وفي السياق نفسه، فإن كل نظام دكتاتوري بالضرورة لديه تناقض جوهري مع مكوّن من مكوّنات المجتمع يعتبره تهديداً مباشراً لاستمراره في الحكم، والذي قد يكون مكوناً دينياً أو اجتماعياً او طبقياً، وبالتالي لضمان استمراره في السلطة، فإن النظام يستهدف هذا المكوّن بأكثر مما يستهدف أي مكوّن آخر سعياً منه لشل قدراته في التفكير والعمل المنظّم، عبر استهداف رموز المجتمع، وتفكيك مؤسساته الثقافية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية.
- وبتنزيل ذلك التصوّر على نظام أسياس؛ يأتي السؤال هل الطائفة (المسيحية الأرثدوكسية) في خدمة السلطة أم إنّ السلطة في خدمة الطائفة؟ قد تُشْكّل الإجابة على البعض، ويجادل أن السلطة في خدمة الطائفة أو الطائفة في خدمة السلطة، ولكن الإجابة تتضّح بطرح سؤال أكثر تفصيلاً، وهو: في حال تعارضت مصالح الطائفة مع مصالح النظام، هل الطائفة قادرة على استبدال النظام، أو إجباره على تعديل سلوكه أو تغيير سياساته بما يتوافق مع مصالحها، أم أنه في حالة تعارض مصلحة استمرار النظام مع مصلحة الطائفة فإن الأخير قادر على تحجيم الطائفة، وإعادة ترتيب قيادتها بما يضمن له السيطرة عليها وتسخيرها لخدمة مصالحة مقابل امتيازات لا تتعارض ومصلحة النظام؟
- أعتقد إنّ الإجابة على السؤال الأخير تكشف عن طبيعة النظام بشكل أكثر وضوحاً، فلم يكن في مصلحة الطائفة أو الكنيسة الأرثدوكسية في إرتريا الحرب التي خاضها النظام مع إثيوبيا في بين عامي 1998م وحتى عام 2000م، كما أنه لم يتردد في عزل البطريرك أنطونيوس وأوجد قيادة بديلة للطائفة ووضع البطريرك تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته في عام 2022م، وبالتالي واضح أنه في حال تعارضت مصلحة النظام مع مصلحة الكنيسة فإن السلطة الزمنية أكثر قدرة على فرض إرادتها على الكنيسة، وبالتالي هنا الكنيسة مسخّرة لخدمة السلطة السياسية وليس العكس، ونجد نماذج مماثلة لاستخدام الكنيسية من قبل السلطة الزمنية بدرجات متفاوتة كما هو في روسيا وعلاقة فلاديمير بوتين بالكنسية الأرثدوكسية ، ونظام فكتور أوربان في هنغاريا مع الكنيسية الكاثوليكية.
هل توجد مصلحة في توصيف النظام بـ (الطائفي)؟
- لا يمكن الإنكار أن توصيف النظام بالطائفي، يعفي الواصف والموصوف له، من العصف الذهني من خلال تبني هذا الوصف التبسيطي والذي يكون مخلاً في الغالب، ولكنّه في الوقت ذاته يجد هوىً ومناصرة من العديد من أصحاب القضية، إذ إنّ البعد الطائفي أو القبلي هو بعد عاطفي يثير لواعج النفس ويشعل فتيل الحماس ويدفع للثأر، ولكن في الغالب فإن أي حماس لا يحكمه العقل هو تهوّر وتكون عواقبه وخيمة، وكما ظل يردد الإمام الصادق المهدي عليه رحمة الله (من فشَّ غبينتو خرَّب مدينتو).
- توصيف النظام بالطائفي، ينقل المظالم السياسية والمجتمعية إلى مطالب طائفية، وهذا بدوره ينقلنا إلى شكل المعالجات المتصوّرة لهذه المظالم، فهل مثلاً إذا استجاب النظام للمطالب المرفوعة، وأطلق سراح العلماء، والشيوخ، وقيادات المجتمع المسلم كافة، وعالج قضية الأرض واللاجئين، هل هذا يكفي ليتصالح المجتمع المسلم مع النظام؟
- أو لو أنّ النظام تبنى سياسة العدل في الظلم، وقام باعتقال رموز المجتمع المسيحي الأرثدوكسي، ووفكّك مؤسساته بالقدر نفسه الذي يحدث مع المجتمع المسلم، فهل ذلك سوف يعالج القضية؟
- ثم إذا أطلق النظام سراح المخطوفين من هذا المجتمع أو ذاك، وأعاد الأرض مثلاً، ما الذي يمنعه من إعادة اعتقالهم وغيرهم، وسلب الأرض وتشريد المجتمع مرة أخرى؟ هل الأزمة في السلوك والإجراءات، أم في السلطة المطلقة التي لا يحدها دستور، أو يقيدها قانون أو تراقبها مؤسسات؟ والاجابة في تقديري هي إنّ جوهر الأزمة هي السطلة المطلقة التي تمكّن النظام من سلطة الخطف، والنهب، والسلب، والتشريد، وعطاء ما لا يملك لمن لا يستحق، وهذه السطلة المطلقة هي جوهر سمة النظام الدكتاتوري.
- النظام وإن كان المجتمع المسلم يعدّ في تناقض جوهري مع استمراره وبالتالي استهدفه ولايزال وسيستمر في استهدافه، لكن الحقيقة أنه لم يكن هو التناقض الوحيد وإن كان بدرجات متفاوتة، فشريحة الشباب بشكل عام تشكل خطر على استمراره، ولهذا جاء مشروع السخرة المتمثل في ساوا والخدمة القسرية التي لا نهاية لها، ومشروع تشريد الشباب في المنافي والبحار، كما أن شريحة المتعلمين من حملة الدرجات الأكاديمية العليا خاصة من أبناء الكبسا ظلّت تشكّل تهديدًا مباشرًا له، وقد استهدفها في الثورة والدولة، سواء على أساس إقليمي أو شخصي.
- توصيف النظام بأنه طائفي يخدم مصالح النظام أكثر مما يخدم مصالح المعارضين، فالنظام المستند على قاعدة المسيحيين الأرثوذكس إلى أن تصل في خطها الأفقي الأخير (مسيحي الهضبة الأرثوذكس الحماسين)، من مصلحته أن يصوّر لقاعدته إنّ مصالحهم في خطر من (الآخر) وعليهم التنادي للحفاظ على النظام من أجل الحفاظ على مصالحهم، ولهذا كان عشية محاولة (علي حجاي ورفاقه) في يناير 2013م وصف الحركة بأنهم حركة إسلاميين متطرفين.
ما هو رد الفعل المأمول من المجتمع المظلوم:
- على المسلمين فهم دوافع المظالم التي مستهم ولا تزال من قبل النظام، في ظل إطار فهم كلي لطبيعة النظام ثورة ودولة، وديناميكات استمراره في السلطة، ومِن ثَمَّ اختيار رد الفعل بناءً على فهم كلي وليس نظرة تجزيئية مدفوعة بمظاهر السلوك دون إدراك الدوافع الأساسية للسلوك والإجراءات.
- المأمول من المجتمع المسلم أن تكون مقاومته وتصديه للنظام بقدر المظالم التي وقعت ولا تزال على المجتمع، وبما أن المظالم أكبر والتأثير أعمق، ولكن بالمقابل تجد أن دور المجتمع المسلم في التصدي للنظام بشكل فعّال لا يتناسب وحجم المظالم الواقعة عليه، وهذا يحتاج إلى دراسة الأسباب والظروف التي أدّت إلى ذلك ومحاولة إيجاد مقاربات لتجاوز ذلك.
- بما أن المجتمع المسلم الأكثر تضرراً من استمرار النظام، فإن أي مسعىً من أي شريحة من شرائح المجتمع لتغيير النظام أو الضغط عليه لتعديل سلوكه، يجب أن تكون ليس محل ترحيب وحسب، بل ومحل تأييد ومناصرة، ويتعاطى معها المجتمع بشكل إيجابي، بدلاً من التشكيك في دوافعها، أو مطالبتها بالاعتراف بالمظالم، أو تأكيد الحقوق مقدّماً، وذلك لأن المجتمع المسلم صاحب مصلحة أكبر في زوال النظام، وهذا لا يعني بالضرورة أن الشريحة التي يمكن أن تتصدّر إسقاط النظام سوف تعترف بالمظالم، وتعيد الحقوق، ولكن بالتأكيد إسقاط النظام سيحدث شرخًا كبيرًا يساعد المجتمع المسلم على لملمة أطرافه، والدخول إلى ميدان الفعل، وحينها الاعتراف بالمظالم وإعادة الحقوق يكون أيسر مما هي عليه في ظل الظروف التي يعيشها المجتمع المسلم في الحالة الماثلة.
- إنّ أي شرخ في الكتلة الصلبة للنظام يجب أن تقابل بترحاب، سواء كان هذا الشرخ في الكتلة الاجتماعية، أو المؤسسات القمعية التي يقوم عليها النظام، ومعلوم إنّ الأنظمة الدكتاتورية لا تتهاوي طالما كتلتها الأساسية متماسكة، وبالمقابل، فإن تبني المطالب والخطاب الطائفي في توصيف المظالم وابتداع الحلول يسهم ولو بشكل غير مباشرٍ في تماسك هذه الكتلة، والتي تعتقد أن التغيير قد يكون مكلفاً لها ولمصالحها إن لم يكن مهدداً لوجودها.
- ابتداع الوسائل التي يمكن أن تساهم في خلخلة مفاصل النظام، بدلاً من اتباع الوسائل التقليدية نفسها مما درجت عليه المعارضة، فالمظاهرات في الخارج مثلاً على أهميتها، ولكنها غير كافيه، ذلك أن دورها في التأثير على النظام الإرتري محدوداً للغاية إن لم يكن معدومًا، والمظاهرات خاصة في الدول الغربية تتم من أجل لفت نظر المجتمع والدولة التي يعيش فيها المهاجرون لقضية بلادهم، والضغط على حكومة الدولة المعنية لاتخاذ بعض الإجراءات ضد النظام، وفي حال النظام الإرتري، العالم كله يعلم ما يحدث في إرتريا، ويدين ممارسات النظام كدول أو مؤسسات دولية، ولكن تأثير ذلك على النظام يكاد يكون غير محسوس بسبب أن النظام الإرتري اختار العزلة في محاولة لتحصين نفسه من أي ضغوطات دولية (خاصة الدول الغربية) وبالتالي تأثير هذه المظاهرات تجاه الضغط على النظام ضئيل للغاية إن لم يكن معدوماً.
- لقد ترسّخ في العقل الجمعي الإرتري إن إرتريا مستهدفة من الأعداء، وإنّ مدخل أعداء إرتريا لاستهدافها هو تقسيم المجتمع على أساس ديني أو قومي أو إقليمي (أغنية شاما للفنان القامة أبرار عثمان) نموذجاً، وقد استقل النظام هذه القناعة في العقل الجمعي الإرتري فبنى عليها استراتيجيته للاستمرار في السلطة، وقد تمكّن النظام عبر إعلامه وأذرعه السياسية من ترسيخ قناعة لدى المجتمع الإرتري خاصة في الداخل من أن المعارضة في الخارج لا تعدو أن تكون أداة بيد الأعداء ولهذا فهي موبوءة بجرثومة الطائفية أو القومية أو الاقليمية وأنها لا تؤتمن على إرتريا (أغنية علل بلا عدي– ودي تكابو – احتفالات الاستقلال لعام 2011م) نموذجاً. وعليه فإن رفع اللواء الطائفي في توصيف النظام أو توصيف المطالب يصب في استراتيجية النظام للاستمرار في السلطة، وإذا كانت هنالك أي قوى وطنية في الداخل تسعى أو تفكّر في التغيير ثم تنظر إلى خطاب المعارضة في الخارج فإنها سوف تتردد في الإقدام على أي خطوة من هذا القبيل، ولعل أحد الأسباب التي أخرّت التغيير في الداخل هو عدم وجود خطاب سياسي ورؤية سياسية متماسكة ومتوازنة للمعارضة في الخارج مبنية عل تقديرات واقعيه وتستصحب الظروف في الداخل.
خاتمة
- حاولت هذه المقالة تجاوز تمظهر سلوك وإجراءات النظام الى الدوافع والديناميكيات التي تبناها النظام لاستمراره في السلطة، وجعلت المكون المسلم في تناقض جوهري مع تصور أسياس وطموحاته، وهذه الظاهرة ليست حصراً على النظام الإرتري، بل هي سمة ثابتة في كل الأنظمة الدكتاتورية حيث تعتمد قاعدة صلبة عبر مساومة مجتمعية تسمح لها بالحصول على المكاسب مقابل الاستمرار في السلطة ولكن هذه القاعدة الصلبة قد تكون ثابتة أو متغيرة، ويكون لديها تناقض جوهري مع مكون آخر، والذي قد يكون دينياً كما هو في إرتريا، وقد يكون قوميا/قبلياً في نظام آخر، أو ايدلوجياً، أو طبقياً أو فئوياً في نظام آخر، ولكن تظل السمة الجامعة هي الدكتاتورية والحافز في السلوك والإجراءات المستخدمة هو تحييد التهديد والاستمرار في السلطة. ومع هذا لا يساورني شك في وطنية وإخلاص أغلب الذين يرون إنّ الخلاص من النظام يكمن في توصيف النظام كنظام طائفي، أو توصيف المظالم على ذات الأساس، وهو ما يحكم بالضرورة خطابهم السياسي وردود أفعالهم تجاه ممارسات وسلوك النظام، ولكن الأنظمة السياسية أعقد بكثير من النظرة التبسيطية، كما إنّ مواجهة الأنظمة التي يتطاول أمدها في الحكم في مجتمعات متعدّدة التصورات كالمجتمع الإرتري يتطلّب نظرة كلية شامله، تضع في الحسبان الوصول إلى الأهداف الكلية، وليس تحقيق انتصارات مؤقته لا تصب بالضرورة في مسار تراكم العمل النضالي الذي يسعى للوصول إلى غايات محددة، هذا إذا لم تساهم بشكل أو آخر في هزيمة الغاية الأساسية.