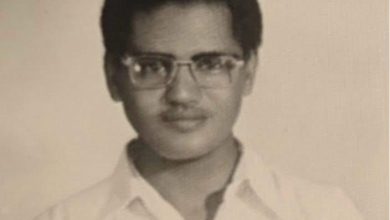نمائم…أسمرا و أيامها : خليفة دسوقي الجبرتي

22-Dec-2013
نقلاً عن الراكوبه
إشارة الريحان – فقال الريحان، قد آن حضوري وحان، فخذني خديماً، واتخذني نديما فرطيب خضرتي، تُخبر عن طيب حضرتي، فكيف تستريح روح بغير ريحان، أم كيف يلذ سماع بغير ألحان، أنا الموعود في الجنان، الساري بأنفاسي إلى صميم الجنان، فلوني أعدل الألوان، وكوني ألطف الأكوان، من جَناني في جِناني،
استنشق نشري المطوي في جَناني، فأنا أليف الأنهار، وحليف الأزهار، وجليس السُمار، وكاتم الأسرار، فإن سمعت في جنسي بالنمّام، فلا تكن له لوّام، فإنه ما نمّ إلاّ على عطره، وما باح إلاّ على سرّه، وما فاح إلاّ بنشره، وباح بسرّه أعلاماً، ونشر من نشره إعلاما، فلذلك سمي نمّاماً، وليس من نمّ على نفسه، كمن نم على غيره، ولا من جاد بخيره، كمن جاد بضيره، ولكن جفّت الأقلام، وجرت الأحكام، بأن النمّام مذموم بين الأنام، والسلام. (من كتاب كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار للعز بن عبدالسلام المقدسي)
(1)
نشأت في مدينة من أروع مدن الدنيا كلها، أو هكذا كانت ! مدينة يمكن اعتبارها الآن بمثابة الجنة المفقودة التي لن تعود فالزمن غير الزمن، ورائحة البارود والمدافع وهدير الطائرات وصرير وزمجرة الدبابات منذ أخذ بتلابيب الضمير الإنساني هناك، احترقت روح تلك المدينة الهادئه في عظمتها، وهوت من علياء البراءة ومن قمة الإقدام والشجاعة و المغامرة فتردت إلى ما تردت إليه من وضاعة، فمن حرب ركبت موجة الأمل والرجاء والتفاول التي سادت العالم في لحظة من لحظات القرن العشرين، فأطالت التفاؤل لثلاثين عاماً وانتصرت ، ثم عود على بدء – إلى حرب مدمرة مرة أخرى أين منها سوريالية سالفادور دالي أو عبثية كامو ، حرب أتت على أخضرها قبل اليابس، فلقد كان شباب الجيل الثاني، الغض، الذي لم يخبر أهوال الحرب الأولي وشدائدها ، والذي كان المأمول فيه أن يكون أول من يقطف ثمار ذلك النصر الأول، هذا الشباب كان هو وقود هذه الحرب والتي لم تضع أوارها حتى اليوم وإن بدت جبهات القتال ساكنه سكوناً وهدوءاً خادعاً لم يمنع من استمرار بل ومن نشؤ حروب داخلية مصغرة داخل حدود كل من طرفي الحرب الكبرى ، وهكذا غَادَرَتْ أسمرة عالمنا تاركة ورائها شبح يشبهها، لا روح فيه.
من عرفها تلك الأيام سيرى اليوم شبحها بوضوح وحتى بشرها تراهم يتحركون كالأشباح ويتصرفون مثلها فالحديت البرئ لا بد أن يكون همسا إن تؤثر السلامةً، والضحكة المقهقهه مجلبة لانتباه من تود بل وتتمنى أن تنساه.
مدينة أسمرة في حياتها القصيرة كانت مدينة من مدن ألف ليلة الأسطورية، متعددة الأعراق والثقافات والأديان والمشارب، ترى فيها العرب وجلهم من اليمنيين ذوي السطوة والجاه، وترى فيها الإيطاليين الذين كانوا يتمتعون بالثروه والنفوذ كحق مستمد من سيادتهم السابقة وكإرث استعماري متجذر في النفوس و العقول، وكان منهم من يمتلك أخصب الأراضي الزراعية ومنشآت لإنتاج الحليب و الفواكه والخضار للتصدير. و كان اليهود وأغلبهم من اليمنيين أصحاب ثروات وملاك أكبر وأجمل العقارات وكانوا هم حليفوا العرب في حربهم لسلطان الإيطاليين. وكان هناك الهنود وهم ايضاً كانوا من ميسوري المدينة وإن لم يكونوا من وجهائها لحبهم العزله والغرق في ذواتهم . وهناك في الأطراف الخارجيه من الدائرة وبعيداً في الهامش يقف المواطنون أصحاب الأرض كلها دون أن يكون لهم أي دور في إدارة عجلة الحياة والتأثير في مجرياتها ، فأرزاقهم لم تكن إلاّ من الفتات التي تتساقط من موائد الضيوف من عرب وإيطاليين وهنود ويهود ويونان وأرمن وغيرهم . كانت تلك الفترة من حياة تلك المدينة ، الفترة التي تلت الحرب العالمية ، فترة انتصرت فيها البراءه والقبول بالواقع والقناعة، فضائل- أو ربما رذائل حسب رأي آخر- زرعها المستعمر لتيسير تسلطه وكان من هذا ومن هنا يتسلل الخدر اللذيذ المسمى بالإطمئنان بهتاناً، وإلاّ فقل لي إذن أي اطمئنان في تاريخ بني الإنسان ظل كذللك، أوليس الإطمئنان طريقاً رحباً مفروشاً بالورود يؤدي إلى قلق أعظم؟
أسمرة في تلك الأيام كان فيها من الأسواق ما يدير رأسك و يخطف عينيك، وكل سوق تحمل بصمات عرق ما أو ثقافة شعب من الشعوب. فالسوق العامة التي تحمل طابع سوق روماني في مظهرها وعمارتها واشية بذلك عن مزاج مصممها الذي قدم إلى هذه البلاد وفي يده فأس حادة وفي الأخرى أعواده المحزمه وهو يبشر بإمبراطوريته التي ستعمر ألف سنة وحتى حين أسمى السوق لم يسعفه خياله إلا بتسميته سوق تورينو Piazza Torino. هذه هي السوق العامة للمواطنين وهناك ترى صف طويل من الدكاكين و الحوانيت الصغيره الرشيقة والتي تبيعك ما يخطر ولا يخطر على بالك من البهارات، وكانت تلك صناعة يتوارثها الإبن عن الأب ولقد كانت فيما يبدو تجارة محصوره بالجبرت وهم المسلمون من أهل تلك البلاد و بعض اليمنيين العرب، وفي هذا بعض من المنطق لأن مستوردي مواد تجارتهم ، والتي كانوا يجلبونها من الحبشة وميناء عدن الحر والهند، كانوا من اليمنيين أيضاً. ولم يكن هذا يعني أنه لم يكن هناك من المواطنين الأُخر من كان يعمل في هذه التجاره- التي كان ظاهرها ينبئ بأنها كانت تدر الربح الوفير- لا ، بل كان هناك كثر منهم ، ولكن لم يسموا بتجارتهم لمستوى مابلغه حتى الجبرت من أبناء تلك البلاد ناهيك عن اليمنيين من صغار التجار. وربما كان تفوق الجبرت على مواطنيهم من الفئات الأخرى هو أنهم كانوا حتى من قبل أن يأتي الإيطاليين بمشروعهم الإستيطاني وقبل أن يكون هناك لكل تلك الأقليات أي وجود كانوا هم تجار الحبشة لأن الأباطرة الأحباش وخاصة في عهد الإمبراطور يوحنا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر منعوا المسلمون الجبرت من تملك الأرض الزراعية بل أنه في نهاية الأمر طالب المسلمين واليهود بالرحيل عن بلادهم اويتنصروا وقطعت رأسه بعد هزيمته على يد تحالف من جيش المهديه السوداني و جيش الأحباش المسلمين في موقعة المتمة في غرب إثيوببا. إضافة على ذلك فإنه كان يمنع الإشتغال بالجندية للمسلم فلم يكن أمامهم سوى التجارة التي كان الأحباش يتعـفـفون منها ، لذا ترى على مدار العصور الوسطى سفراء ملك الحبشة لحكام مصر واليمن والحجاز من هؤلاء الجبرت. وفي هذا السوق كنت لتجد المحلاّت الصغيرة التي تبيع الخرز والأقراط والحلوق والحنه والتمر والنبق والدوم كما أنه كنت ستجد في الجانب الآخر سوق لشراء الدجاج التي يأتي بها الفلاحون مع أشياء أخرى من قراهم والشراء بثمنها ما تيسر من البهارات والشطه والخرز وما إلى ذلك. وفي جانب آخر تجد قسماً من السوق يبيع مشغولات السعف الجميلة الملونه والفخاريات المزينه المنقوشة التي يسمونها هناك بـ”الجبنه” وهي شبيهة ِبَدَّلة القهوة ومثلها تستعمل في صب القهوة على الفنجان ، وهناك مفارش الخضار التي تبيع مختلف الأصناف من خس وبطاطا وكوسا والشطة الخضراء و التوم والبامية وغيره. وعبر الشارع المسفلت مقابل هذه كانت تقوم سوق ضخمة أخرى تبيع الفواكه المنتجة محليا وكانت الجوافة برائحتها الزكية هي القاسم المشترك الأعظم لتوافرها دائماً ورخص ثمنها . و في الجانب الغربي من هذه السوق العملاقة عبر الشارع الجانبي المسفلت كان صفين طويلين من الحوانيت التي تبيع بودرة الشطة الحمراء وفي بعض من هذه الحوانيت تقف في وسطها شامخة كالطود طاحونة كهربائية أو إثتتين وربما أكثر كلها مخصصة لطحن الشطة التي يأتي بها المواطنين الذين كانوا يعالجونها في منازلهم بإزالة ساق قرن الفلفل وإضافة شتى أنواع البهارات إليها قبل حملها لأحد هذه الطواحين، وكانت الشطة من مكونات الطعام الأساسيه في تلك المدينة . وفي الجنوب الأقصى من السوقين تصطف الخمارات التي يغشاها القرويون بعد أن يكون قد باعوا ما أتوا به ثم يتبضعوا وما تبقى يذهب على كأس المريسا كأساً بعد كأس وبوتيرة متسارعة، و قليل الحظ منهم من يذهب لخمارة من هذه الخمارات قبل أن يتبضع لأنه إن فعل ذلك فإنه لن يجد ما يتبضع به في نهاية الأمر. ولا تنسى أن هذه الحانات تستعمل بعض الفتيات- والحق يقال أنهن كن حلوات التقاطيع بعيون سوداء وقوام ممشوق كمعظم فتيات تلك البلاد – لسحب نقود المترددين ، زد على ذلك ما تتلقاه الواحدة منهن من الدروس من معلِّمتها في كيفية التعامل مع مختلف الشنبات. ومن عرف أسمرا تلك الأيام قليلاً، لعرف أن هذا كان أقل من القليل مما كان يدور فيها.كانت هناك القاعدة الأمريكية المتجددة الشباب تأخذ على عاتقها إعاشة وكفالة بيوت الدعارة في أقصى الجهة الشمالية القريبة من معسكرهم بالتردد المستمر على تلك الحانات التي لم تكن في متناول المواطن العادي في نهاية الأمر. وأما أولئك الشباب الأمريكان فإنهم لم يكونوا ليفعلون أكثر مما يفعله أكثرية بني البشر حين يجدون النقود في أيديهم بمقادير تجعل كل من يقترب منهم لا يعاملهم إلا معاملته للبقرة الحلوب ولا يسمعون إلاّ كلمة “يس” تقال لدولارتهم ثم لهم لأن تلك الدولارات لم تزل تقبع في جيوبهم. ولكن الحق يجب أن يقال في أن أولئك الشباب كانوا من المثاليين الذين تنقصهم الثقافة اللازمة للوصول إلى ما كانوا يطمحون لتحقيقه كأفراد يرون في عسكرتهم فرصة لتوسيع الآفاق. لقد سعد كاتب هذه السطور بولوجه لصفحة أولئك الشباب-شباب الأمس- في الشبكة العالمية وعجب من إخلاصهم لبلد(وربما لأنفسهم في فترة شباب جميلة سابقة) لم يعرفوا فيه سوى القوادين و المومسات بل أعجب أكثر لأنهم لم يقطعوا علاقتهم بذلك البلد بل إن السنين وقوة الإرادة قد زادتهم حنكة ودراية وأدركوا اليوم عن بعد ما لم يدركوه بالأمس شهوداً فسبحان مقلب القلوب. وما فهمه كاتب هذه السطور من صفحة هذه الجماعة الحية، هي أنهم يوفدون نفراً من أولئك الذين سبق وأن قضوا فترة خدمتهم في تلك القاعده- يرسلونهم هناك لفترة قد تصل شهراً أو تزيد ، يقضي هؤلاء تلك الفترة في التردد على أماكن سبق وتردد عليها هو أو زملاء له فيسجل ما طرأ علي تلك الأماكن من تغير منذ أوائل السبعينيات وعن شخصيات عرفوها بل أن الكاتب تابع في موقعهم ذلك قصة فتاة تعيش في فاقة في مدينة أسمرة وكانت هذه بنت فتاه من فتيات الحانة في ذلك الزمن توفت عنها وهي بعد فتاة صغيره فما كان من أحد الموفدين أن كتب عنها وأتوا بها إلى أمريكا بل تكفلوا بإيجاد عمل لها وهي الآن تعمل في إحدى الولايات . ولقد جمعت تلك الصفحة كل الذين خدموا بلادهم، الولايات المتحدة في إريتريا منذ الحرب العالمية الثانية ومنذ إنشاء قاعدة للحلفاء في وادي “قوراع” وهو نفس ذلك الوادي الذي انكسر فيه الجيش المصري لدى محاولة الخديوي اسماعيل غزو الحبشة وإتشاء إمبراطورية نيلية تمتد حتى منابع النيل في منطقة البحيرات في وسط إفريقيا وكان قد جييّش لهذا الأمر ضباطاً مرتزقه من الأوروبيين والأمريكان ليقودوا حملته البائسة المضحكة المبكيه تلك، والتي أدت إلى وقوع إبنه أسيراً في يد طاغية الحبشه الإمبراطور يوحنا الرابع الذي وشم رسغ الأمير الصغير بصليب أزرق صغير لا يمحى قبل أن يفرج عنه لقاء وزنه ذهباً. كانت إذاعة وتلفزيون ” راديو مارينا” التي كانت القاعدة الأمريكية ( قاعدة كاجنيو Kagnew Station ( تمتلكهما وتديرهما أول محطة تلفزيونيه في إريتريا وربما في إفريقيا والشرق الأوسط ولكن اهتماماتهما كانت أمريكية بحته و يبدو أن المجتمع خارج المعسكر لم يكن موجوداً بالنسبة لهذه الإذاعة فحتى تدهور الأمن وإعلان تمرد بعض الفئات على الدولة وسقوط العديد من الرجال لم يكن ليحظى باهتمام تلك الإذاعة ورأت أن سطوا على بنك في حي من أحياء شيكاغو الخلفيه كان هو الخبر الجدير بنشره أكثر من تلك المعركه الشرسة التي وقعت في ضاحية من ضواحي أسمره وسقط فيها من سقط من الأبرياء ورجال الشرطه وبعض الثوار والذين أخذت الحكومة بشنق جثثهم في اليوم التالي لترويع الناس وردعهم من الإقتداء بهم.
وفي شمال السوق العملاقة وعبر شارع اسفلتي متوسط السعة تقع سوق العرب التي كانت تبيع القمصان والفساتين والبدل والأحذية والعطور محلات كبرى تأتي بضائعها من المستورد اليهودي والذي لن يبيع لمن هب ودب من ممن يملكون ثمنها فالمسأله ليست إعتباطيه لأن من يشتري منه لا بد وأن يكون أحد ملاك هذه المحلات من اليمنيين وكأنه مستورد بصفة حصرية لؤلئك . وكانت المحلات مصطفة على جانبي الشارع وإن حدث وأن مررت بهذا الشارع في صباح ما مبكراً فسوف تحسب أنك قد انتقلت سحراً إلى سوق الموسكي بالقاهرة ببخوره وعطوره وصوت عبد الباسط عبد الصمد أو الحصري يرتل القرآن بصوت شجي غير أن العود والند هنا عود هندي حقيقي و اللبان عدني اصلي. وكان أغرب ما يحدث في هذا السوق أنه حين الأحتياج لعامل من العمال في هذه المحلات فإن صاحبه لم يكن لينظر نحو السوق المحليه التي كان يمكن أن توفر له ما أراد بأجر زهيد ولكنه كان يجلب صبياً من بلاده يعمل في هذ المحل ليكون لهذا الصبي محلا تماماً كالمحل الذي يمتلكه ولي نعمته بعد بضع سنين وترى من ذلك أن العملية لم تكن سايبة كما يقولون بل كانت أيضاً محكمة بين التاجر اليمني و الدولة بموظفيها (المخلصون). كان للعرب مدرسة خاصة بهم وكانت الحكومة المصرية تساهم بنصيب ما وبالمناهج والكتب وبعض المدرسين. كان العرب يعيشون بترفع مثل كل الأجانب الذي أتى بهم الإستعمار الإيطالي حيث كانت الناس تصنف حسب الأعراق وفي أدني السلم كان يصنف أصحاب الأرض.
(2)
لم يكن وجود العرب محصوراً بذلك السوق فقط وإن كان هو مركز الكثير منهم. وكانوا يكسبون من أعمالهم في هذا السوق الذي لم يكن هناك فيه من ينافسهم غير ذواتهم وضميرهم التجاري، هذا، إن كان للضمير ثمة وجود في عالم التجارة . كانت الصلة بين العرب و المواطنين في ذلك الزمن صلة يصعب تحديدها، فمن ناحية كان العرب لا يرون في المواطنين إلا مستهلكين لبضاعتهم، يقلون عنهم في ادراك الأمور وتقديرها ، فاليمنيون شمالييهم وجنوبييهم والحجازيين عندما وصلوها كان المستعمر الإستيطاني الفاشي هو الذي أتى بهم ليعملوا في مشروعاته لإنشاء الطرق والجسور استعداداً لحربه القادمه التي كانت لتثأر له على هزيمته المذله أمام الأحباش (البدائيون) في موقعه عدوا الشهيرة في العام 1896 وهي الموقعة التي كانت أول هزيمة تتجرعها قوة أوروبية حديثة على يد قوة إفريقيه لا تكافئها عتادا وعدة ً. لم يكن الفاشي ليجلب هؤلاء إلاّ ليتجنب استعمال المواطنين من أهل ذلك البلد لأنه كان يختزن لهم مصيرا في ضميره يشتمل على دفعهم نحو الجنوب كمرحلة أولى بل إن بعض خططه لهم كانت تشمل الإفناء باستخدام السموم، ولم يكن ليتورع عن ذلك حقاً، فهو الذي قصف عاصمة الحبشة بطائراته واستخدم غاز الخردل لحرق البشر و الحجر حين استعصى عليه تركيعها في منتصف ثلاثينيات القرن العشرين. ولقد جعل القيصر الغازي، القادم من روما، احتقار المواطن من ابجديات التعامل معه من قِبَل كل من يقيم من الأجانب في تلك البلاد. ولمّا خارت قوى الفاشية واندحرت جيوشها وأفُلَت شمسها، حـّلت محـّلها قوات الحلفاء من الإنجليز والتي حولت نفسها من قوة احتلال إلى قوة مفوضه بإدارة البلاد من قبل لجنة الأمم المتّحدة لتصفية ممتلكات دول المحور في إفريقيا . ولم تكن قوة الإحتلال الجديدة حريصة حرص القوة القديمة في البقاء وممارسة السياده، بل كان أكبر همها هو المحافظة على الأمن والإستيلاء علي المغانم من المنشآت والمصادر التي كانت تدير عجلة اقتصاد الفاشيه في تلك البلاد وكان ذلك كل شيئ هناك تقريباً، فهناك مصانع للإسمنت وهناك كابلات وعربات التليفريك التي كانت تمتد مابين العاصمة والميناء بطول ما يقرب من مائة كيلومتر و كانت العربات وكل شيئ قابل للإستعمال، و كتابات السيدة الإنجليزيه ” سيلفيا بانكهرست ” التي راعتها عملية النهب تلك، خير شاهد على ذلك ولقد نصبت الكنيسه الحبشية تلك السيدة قديسة حين وفاتها بالحبشة في ستينيات القرن الماضي وكانت قد هجرت بلدها انجلترا انتصاراً للحبشه واستوطنت فيها حتى ماتت. وقد تبعها ابنها ريتشارد بانكهرست إلى تلك البلاد واستوطنها هو أيضاً بل وأصبح أستاذاً لتاريخ الحبشة في جامعة أديس أبابا حيث ألّف وأخرج فيها عشرات البحوث والكتب، ويبدو أن إبن ريتشارد، ألولا بانكهرست، يتتبّع خطوات أبيه، إذ أنه هو أيضاً أصبح أستاذاً للأنثروبولوجيا الإجتماعية في جامعة أدّيس أبابا.
كان المواطنون يدينون بالمسيحيه والإسلام مناصفة. لذلك كنت ترى أنه بينما كان المسلمون يكنون وداً غير متبادل نحوالعرب يرون فيهم إخواناً فإن الجانب المسيحي لم يكن ليراهم أكثر من طفيليين يقتاتون على دماء المواطن مثلهم مثل غيرهم من الذين أتى بهم المستعمر الفاشي، ثم جاء الحلفاء وبريطانيا، فكرسوا ما سنه الفاشيون من قوانين تحمي ثروات الأغراب الذين لم يأتوا إلاّ مفلسين لدعم قبضة الفاشي، لا ليضيفوا شيئاً للبلاد، وانتهوا بأن اصبحوا هم سادة البلاد. ومن هذه الزاوية يبدوا أن نظرة الجانب المسيحي كانت أكثر موضوعية من مواقف الجانب المسلم العاطفيه الذي خلط الحابل بالنابل، ولكن كان له العذر كل العذر في ذلك. فالمسلمون الجبرت وما تعرضوا له من اضطهاد وتمييز خلال القرون جعلهم يرون العالم شطرين: عالم مسيحي وآخر إسلامي. و لقد كانوا من السذاجه في اعتقادهم ذلك لأن العرب في بلادهم، وإن كانوا مسلمين، فإنهم لم يكونوا هناك ليؤدوا فروض الأخوه الإسلامية، بل جاءوا عونا للمستعمر الفاشي ويد تعينه على تشديد قبضته على ما لايمتلكه .
كان معظم المسلمين المقيمين في أسمره في تلك الفترة ينتمون لفئة الجبرت التي يقول المؤرخ المصري الشهير عبد الرحمن الجبرتي مؤرخ غزو نابليون لمصر، وصاحب كتاب ” عجائب الآثار في التراجم والأخبار” ، أنه ينحدر منهم. والجبرت من أعجب المجموعات العرقيه التي أخذت هذه البلاد موطناً لها، وربما كان من غير الدقيق توصيف هذه المجموعة بالعرقية لأنها وبكل بساطة ليست كذلك، ولأن اللحمة التي تربطهم ليست رابطة عرقية أو قبلية، وربما كان أفضل توصيف لها هو ذلك الذي يجعل منها رابطة ثقافية. فالجبرت ليسو عرقاً واحداً بالرغم مما قاله الكثيرون من علماء الأجناس ومن كتب عن الحبشه من الغربيين عن أنهم قبيلة عربيه هاجرت إلى الحبشة في زمن قديم. ومن المهم هنا التنبيه أن هناك فرقاً شاسعاً بين كلمتي الحبشه و إثيوبيا. فالأولى مصطلح جغرافي بينما الثانيه مصطلح جيوسياسي. والحبشه يقع الجزء الأكبر منها في إيثيوبيا بينما يقع الجزء الباقي في إريتريا التي يتكون نصفها من الأحباش. يشترك الجبرت مع الأحباش في اللغه وإن كانت اللغة العربيه هي لغة تفاهمهم مع العناصر الإريتريه الأخرى.
كان للعرب في أسمرا مدرسة تضارع المدارس الإيطاليه في روعتها وثرائها وكانت تلك المدرسة من الضخامة والوسع أن كانت تضم المراحل التعليميه الثلاث حتى الثانوية العامة وقسماً للبنات بفصول واسعة لا أثر للإزدحام الذي كان من الصفات اللصيقه بالمدارس المحلية الفقيره البائسة. وكانت تلك المدرسة مقفلة تقريباً على أبناء العرب ليس بحكم اللوائح ولكن بحكم مصاريفها الباهظه التي لا يستطيع المواطنون من أبناء تلك البلاد توفيرها.
وبجابب مدرستهم تلك كان هناك المعهد الديني الإسلامي الذي كان الأزهر يسيطر عليه بطريقة غير مباشرة نظراً لأن المدرسين في ذلك المعهد كانوا من المبعوثين من الأزهر وكان أشهر من رأس هذه البعثة و أطولهم مده في ذلك هو الشيخ الأستاذ محمد سعيد الدمرداش. وكان الشيخ الدمرداش خطيباً مفوهاً قادراً على تعليق انتباه المستمعين لأي وقت يشاء و كانت أكثر خطبه ترقباً من الناس تلك التي كان يلقيها يوم عاشوراء بعد صلاة العشاء و يوم 17 رمضان ذكرى مقتل الإمام علي بعد انتهاء صلاة التراويح في مسجد أسمرا الأكبر المسمى جامع الخلفاء الراشدين. كان موضوعي الخطبتين ثابتتين فهما يوم شدائد كربلاء ووصفه و الآخر وصف مفصل لمقتل الإمام علي مع ذكر جانب من تاريخ بني أميه شاملاً التحكيم وانشقاق الخوارج وحروبهم على الإمام علي وكل ذلك في خطبة واحده تدر الدموع من المستمعين كل سنه- سنة وراء سنة، كان المتغير الوحيد فيها هو المعالجة الدرامية الماهره من ذلك المبعوث الأزهري ، كان أديباً بكل معنى الكلمة وإن كان أيضاً لا يخلوا من عيوب ظاهرة تقلل من قيمة علمه و أدبه. وربما كان ذلك لأن الشيخ الأستاذ يتناسى أو أنه لم يكن يعلم أن مجتمع المسلمين هنا، مجتمع محافظ، شديد المحافظه ربما لدرجة الجمود، بينما كان هو مثالاً للتحرّر والليبراليه لدرجة لم يكن عندها ليرى أي غضاضة في أن يشعل سيجارته على أول درجات السلم المؤدي للخروج من المسجد، وكأنه لم يكن يعلم أن وضع سيجارة على شفتيه حتى ولو كان على بعد مائة كيلومتر من المسجد يشين وضعه المتخيل في أذهان العامة من المسلمين الذين كثيراً ما يصلّون خلفه. ولقد استجمع بعض الأشقياء من شجاعتهم فراحوا يسألون الأستاذ عما يمكن أن يقوله من إشعال لفافته ليس بعيداً عن المسجد، أو حتى خارجه، بل على سلمه المؤدي للخروج وكأن لسان حاله يقول بأنه كان داخل المسجد يخطب في المؤمنين على كره منه، أو كأن وصوله لسلم الخروج كان بعدها إفراجاً بعد طول انتظار. فماذا كان جواب الأستاذ؟ أصاب الأستاذ في إجابته مقتلاً لمصداقيته بعد أن قال إن على الناس إتباع علم العالِم وليس عمله. وهذا موقف فلسفي لا أظن أن الأستاذ كان يعي مضمونه الذي لاينسجم مع رسالته في تلك البعثه، و هو كذلك موقف ظالم لأولئك الذين يعظهم بعد كل صلاة، فكيف بالله يمكن لهؤلاء أن يضبطوا أنفسهم إذا كان مولانا نفسه لا يستطيع أن يصبر على إشعال لفافته عشر دقائق أخرى ريثما يغادر حرم المسجد! وربما كان الشيخ الأستاذ قد نسي أو أنه لا يرى في قولة الشيخ المتصوف محمد بن عبد الجبار النفّري هذه أية قيمة أو دلالة:
“العلم يدعو الي العمل …والعمل يذكر برب العلم، فمن علم ولم يعمل فارقه العلم، ومن علم وعمل لزمه العلم”
(3)
لم يكن الشيخ الأستاذ محمد سعيد الدمرداش الواعظ الوحيد في أسمرة في ذلك الوقت، ولم يكن جامع الخلفاء الراشدين هو المسجد الوحيد ذو السعة الكبيره، فبجانب الأستاذ الدمرداش كان هناك وعاظ آخرون وبجانب عشرات المساجد الصغيره المنتشرة في أحياء المدينه كان هناك جامع أبي بكر الصديق في حي “أكريا” الذي كان معقل الجبرت وموطنهم في أسمره. ولقد كان واعظ مسجد أبي بكر الصديق الشيخ ” غوث الدين الأفغاني ” واعظاً ومبشراً بكل ما تحمله الكلمة من معني . كان ذلك الشيخ نقيض الشيخ الدمرداش في كل شيئ ، فهو بالرغم من عربيته الصحيحه كان ذي لكنة ثقيله ولم يكن في فصاحة الأستاذ مبعوث الأزهر ولا في قدراته الدرامية ولكنه مع ذلك كان أعمق أثراً فيمن حوله وأكثر حضوراً بينهم. ولم يكن وراء الشيخ غوث الدين مؤسسة كبرى كما كان الأزهر وراء الأستاذ ، و لم يكن هناك من يدفع له راتباً على جهوده بل كان يعيش على القليل الذي تقدمه له دار الأوقاف التي كانت في حاجة لمن يقدم لها هي نفسها المعونه. كان الشيخ يعيش بين من يعظهم ظهر كل جمعه وبعد صلاة كل مغرب بل إنه تزوج منهم ورزق بالبنين والبنات وخلافاً لجميع الأجانب الذين كانوا يقيمون في أسمرة في ذللك الوقت وبينهم العرب، فإن الشيخ غوث الدين أقام صلة الرحم بينه و بين من حوله وزوج بناته لرجال من المواطنين الجبرت بينما كان الأستاذ الدمرداش يعيش في حي من أحياء الإيطاليين ، أسياد الأمس، غافلاً عن حياة من يعظهم، فلا تتعدى علاقته بهم سوي أنه إمامهم في الصلاة بعض الأحيان وسوى أنهم كانوا يعجبون وينجذبون لخطبه الدرامية البليغه .
ويذكرنا الشيخ غوث الدين هذا بأولئك الأجانب من بلاد السويد الذين أقاموا إرساليتهم الإنجيلية في وسط حي ” أكريا ” ذو الغالبيه الجبرتيه المسلمة ، رجال ونساء يحذقون مختلف الحرف ، فترى منهم من يتقن النجارة وآخر الحداده وثالث يتقن التمريض بل كان هناك من الأطباء منهم، يأتون في فترات معلومة لوصف الأدوية للمرضى ويهبون لهم هذه الأدوية دون مقابل في أحيان كثيرة. وأعجب ما كان من أمر أولئك الرجال والنساء أنهم كانوا يتقنون اللغات المحليه وآدابها وتاريخها بمدى يزيد كثيراً عما يدركه متوسط الثقافة من بين المواطنين. ولا تحسب أبداً أن ذلك كان سيقعدهم عن طلب المزيد من العلم عما حولهم، لأنك أبداً كنت ستراهم كثيري السؤال دون تطفل ، ومعرفتهم بالثقافة المحليه كان يزيد من تأدبهم ولطفهم، فيزدادوا قرباً من قلوب الناس. وكان هناك سبب كان يقرِّبهم من قلوب الناس هو حقيقة أن أعضاء الإرسالية يبقون هم هم لا يعود أحدهم إلى بلده بقدوم آخر جديد بل يبقون كأنه إلتزام بطول الحياة، ويا لها من بطولة حقة. ولقد سعد كاتب هذه السطور أن التقي برجل الماني منذ زمن غير بعيد. كان بعد أن عاد إلى بلاده بعد غيبة طالت الإثنين والثلاثين عاما بين القبائل الرحل في غرب إريتريا فخدمهم وعلمهم ما أمكنه تعليمهم وتعلم منهم كذلك ، رأيته يتحرق شوقاً للعوده إلى هناك يمارس حياته بطريقتهم ليؤثر فيها بعد أن تأثر بها من حيث لا يدري.
كان أفراد الإرسالية على علاقة مع كامل المجتمع من حولهم، والنساء منهن كنا يزرن الحوامل في منازلهن للفحص وإسداء النصح وربما لمنح ما وصفه الطبيب في يوم سابق . وكان الأطفال مهوسون ومفتونون بالإرسالية وما فيها، وخاصة أيام خميسها ، ففي ذلك اليوم تعقد الإرسالية حفلا تعرض فيه فيلماً يتضمن عرضاًإضافياً لفيلم كرتون يذهب بقلوب الأطفال فيطيرون فرحاً. وكانت هناك فصول النساء أقامتها الإرسالية لتدريب الفتيات علي التطريز والحياكة والإسعافات الأولية.
كان الآباء يخشون على صغارهم من الإرساليات التي كانت منتشرة ليس في المدينه فحسب بل و في طول البلاد وعرضها، غير أن هذه الإرسالية التي أقامت بين ظهرانيهم لوقت طويل أظهرت لهم عبث طرائق تفكيرهم وخطـلها بشأن أولئك الرجال وتلك النسوة .
كانوا في بداية الأمر يظنون أن أفراد الإرساليه سوف يعبئون صغارهم بكلمات الإنجيل وبما يهدد هويتهم كمسلمين ولكن الأمر الواقع الذي تكشّف لهم بمرور الوقت هو أن أفراد الإرسالية لم يكن يهمهم صناعة وإحلال مسيحيين صغار مكان المسلمين الصغار، أبناء المواطنون ، لم يكن يهم هؤلاء إلاّ أن يظهروا بمظهر الأصدقاء والإخوة، جاؤا عوناً للمواطن علي جهله وفقره والجميع رآهم وهم يضعون ذلك موضع التنفيذ بلا كلل أو ملل. قالوا في البدء، أنهم لا ينتظرون ولا يتوقعون ولا يريدون من المواطنين ثمن خدماتهم فأسّر المواطن في نفسه أنهم إنما يريدون الثمن من عقيدته ولكن ذلك أيضاً لم يكن، فلم يحدث أن فردا من أفراد الإرسالية حاول الوعظ أو تلقين المسيحيه أو إغراء أحد على الدخول فيها بل أنه لم يكن هناك ما يدل على مسيحيتهم غير ذلك الصليب الذي كنت ستراه علي أعناق النساء والرجال منهم متدليا على صدورهم. وعليه فإنه لا يمكن القول إلا أن السكان المحليين قد جنوا الخير العميم من هذه الإرسالية وفي المقابل لم تجني الإرسالية منهم سوي الذكري الجميلة العطرة ، بل إن أحد مدرسي مدرسة أكريا الإسلاميه (والتي سنتحدث عنها في حلقة لاحقة) ذهب إلى القول إن وجود تلك الإرسالية في ذللك الوسط الإسلامي إنما كان رسالة من الله يرينا من خلالها كيف تكون الأخلاق الإسلاميه التي كانوا يرونها في أفراد الإرسالية ، يتحلون بها دون المسلمين ، وكأنهم كانوا تذكرة لهم بما يجب أن يكونوا عليه. وفي رأي كاتب هذه السطور فإن العلاقة بين هذه الإرسالية الصغيرة الحجم ، العظيمة الطموح، وبين المجتمع الذي المحيط بها، كانت قائمة على سوء فهم حميد من كلا الطرفين أو ربما قلنا أنه عدم فهم الآخر كما يليق وإحلال ما يترائى لك عنه محل الحقيقه وإهمال تصور الآخر لنفسه و عدم إدخال ذلك في الحسبان وإلغاءه، فيغيب كمال الحقيقة في تصورات لا تملك إلاّ نصف الحقيقة على أحسن الفروض. ورجال الإرسالية ربما أتوا وفي ظنهم أنه كان بإمكانهم إيقاظ الوعي المسيحي في وجدان المجتمع المحيط بهم وفي عقولهم التي افترضوا أنها بيضاء بياض الصفحة الناصعة، ليس بالوعظ وخطب الإرشاد بل بضرب المثل الحي بأنفسهم في معاملاتهم النزيهة وكرمهم الفياض وأعمالهم النبيلة. ومن الناحية الأخرى لم يتوسم المواطنون خيراً في هؤلاء الأغراب ، وفي البداية كانوا يظنون أنهم سرعان ما سينقلبون للوعظ السافر، و الذي لن يفيدهم في شيئ علي أية حال، إذ كيف بالله يمكن لهم أن يخرجوهم من عقيدتهم، أوليسوا هم من عاش ألف عام من الإضطهاد والتنكيل وهم من قال فيهم ووصفهم المهندس فتحي غيث صاحب كتاب ” الحبشة والإسلام عبر القرون ” بـ” القابضون على الجمر “؟ وهكذا سارت الأيام دون أن يحل التبديل المنتظر من كلا الجانبين. فصار الكرم والخلق الكريم من الإرسالية جزءاً من ترتيب الأشياء كما يراه المواطنون. و في الحقيقة فإن الإرسالية كانت تنجح كثيراً في إيقاظ الوعي الديني ولكن ليس ذلك الوعي الذي كانت تقصده أو تسعى إليه فلقد كان كل مَن حولها ذو وعي سابق علي اللحظة بما يزيد على الألف من السنين وعليها بضع مئات أُخر، وعرفوا رجلاً بأخلاق تفوق أخلاقياتهم وتتسامى عليها، رجل دعا إلي ما يفوق أخلاقيات الإرسالية، عرفوه وقبلوه حتى عندما أنكره قومه من قريش! كان الوعي بالخير والأخلاق الفاضلة عند الجبرت هو رديف الوعي بالمصطفى و بأخلاق المصطفى فذكر الخير وكمال الأخلاق عندهم لا تثير إلاّ ذكرى المصطفي والمصطفي يثير الأخلاق الكريمه ومعاني الرحمه في نفوسهم، وهكذا كان، فعمل الإرساليه الجميل كان دائماً يثير ذكرى السيرة النبوية العطره في نفوس الكثيرين من أهل ذلك الحي ، وكان أفراد الإرسالية يعون ذللك فيزداد احساسهم بالمسؤلية الثقيلة التي أخذوا على عاتقهم إنجازها، فتزداد إثارة الذكرى وتزداد قوتها مره أخري كنتيجة آلية وحتميه ولقد استمرت هذه الجدلية حتى منتصف سبعينيات القرن الماضي حين أقفلت الإرسالية وذهبت ولم تأخذ من ذلك الحي شيئاً ولكنها تركت سيرة حسنة لاتنسى.
كان هناك أيضاً ذلك الواعظ من عرب حضرموت، ” الشيخ عمر الحدّاد”، واعظ وشخصية مثيرة لجدل متواصل واختلافات حادة بين الأهلين. كان للشيخ حلقة دروس يحاضر فيها كل يوم في الوقت ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب في أكبر مساجد المدينه، مسجد الخلفاء الراشدين. ولم يكن للشيخ تلاميذ كُثر ولكن من كان منهم،فإنه كان صاحب إخلاص للشيخ و تعاليمه المتشدّدة، قولاً وععلاً، بالرغم من أن كثيراً من تلك التعاليم التي كان يبشِّر بها هذا الشيخ تُصنِّف كثيراً من عادات الأهلين ونشاطاتهم الدينيه والإجتماعية من بين أفعال الضّلال. ولم يكن هناك (ظاهرياً على الأقل ) من يقف خلف الشيخ ويسانده، فلم يكن الرجل مبعوثاً للأزهر كما كان الشيخ الأستاذ الدِّمرداش ولم يكن من منسوبي دار الأوقاف المحلية مثل الشيخ غوث الدين، ولكن حضوره وتأثيره والإحترام الذي يفرضه على الجاليه العربيه وأثرياءها كان واضحاً وضوح الشمس ولا لبس فيه. كان تلاميذه ومن يحاضر فيهم، بلهجة عربية عسيرة على الفهم إلاّ على من تعوّد عليها من خلال الحضور المستمر لدروسه، في غالبيتهم من الشباب من المتعلّمين والموظفين ومنهم عددُ ترك وظيفته الحكومية لأن الشيخ كان يرى أن قبض راتب من حكومة يندرج الربا تحت أعمالها، محرّم شرعاً حرمة الربا ذاته. ولم يكن هذا فقط ما يبث الرّعب في قلوب الأهلين بل إن بعضهم كان يرى أن ما يقوله الشيخ في عدد من عاداتهم قد يُسبِّب انشقاق مجتمعهم إلى أتباع ومخالفين له. فزيارة الأضرحة والقبور والتبرك بأولياء الله الصالحين والإحتفال بالمولد النبوي وبيوم عاشوراء، مراسم وطقوس عبر القرون، كانت كل منها في نظر الشيخ وتلامذته بدعة وضلاله حين كانت في نفس الوقت على النقيض من ذلك عند الأهلين، وكان اعتقاد الولاية في شيوخ الصوفية رجس من عمل الشيطان عند الشيخ الجليل في حين أن ذلك كان في عقائد هؤلاء الناس يشكل جزأً ليس من دينهم فحسب بل جزءا من شخصية مجتمعهم وعاطفة شوق تجمعهم حوله. وأما حفلات الزار التي كانت منتشرة ليس في مجتمعات أسمرا فحسب بل وعلى امتدا كل الحبشه فإنها كانت عنده عبادة واضحة للشيطان، ولم يكن له فيما يبدو خيالا يجمح ليهمس في أذنه أن الزار وطقوسه ربما كايا يقضيان حاجات اجتماعيه لازمة.
ولقد ترك الشيخ عمر أسمرأ عند اشتداد الأحوال السياسية وتعقدها، وبروز عنف الدوله، ليسافر ويستقر في بلد يشبهه ويقدر مواهبه، استقر في السعودية في أوج فوران أسعار النفط وبدء الطفرة الماليه لذلك البلد عند بدء النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي.
كان جيل الأباء هو جيل المراتب والطرق الصوفية المختلفه وحفلات الذكر و النفاحات الروحية التي تتخللها. كان هناك أتباع للطريقه الشاذليه القادريه والختميه وطرق أخرى وكانت الأضرحه والمزارات والمقامات لأولياء الله الصالحين منتشرة في طول البلاد وعرضها ومن أشهرها ضريح النجاشي الذي يتقاطر عليه الكثيرون من الحبشة في يوم معلوم من أيام السنة، في منطقة تجراي في شمال إثيوبيا، و هو ضريح قديم ذكر عرب فقيه صاحب كتاب ” فتوح الحبشة” أنه زار ذلك الضريح ( في النصف الأول من القرن الخامس عشر الميلادي) بمعية الإمام أحمد ابن ابراهيم ذلك الأمير الذي ثار على الطغيان الإمبراطوري الحبشي فهزم الأمبراطور وجيشه المرة تلو الأخري ففر من أمام الثائر طريدا حتى مات من الجوع في أحد الكهوف قبل أن يتدخل البرتغاليين فيهزموا الإمام بدورهم ويقتلونه ليستعيد ولي عهد الإمبراطور الطريد عرشه الذي كان قد أصبح أثراً بعد عين وتُـْنـَقذ المملكة الحبشية وكنيستها من قبضة كانت قد أطبقت عليها فكادت أن تقضي عليها. وإذا كان للتاريخ أن يكون عبرة ومتحفاً للأخطاء ماثلا ً لعياننا يستخلص منه العقل المتأمل دروسه ، فإن الدرس الوحيد الذي نستخلصه من قصة الجبرت وتاريخهم و من قصة الحبشة التي أنشئت قومية وإمبراطورية تلتزم بمعتقد الكنيسة الأرثودوكسية، فاقصت بذلك سائر الفئات- والمحاولة الجريئةالمحزنة للأمير الثائر الإمام أحمد بن إبراهيم توحيد الحبشه في القرن السادس عشر على أساس من فرض الإسلام قهراً على الجميع ، ومطاردة أباطرة الحبشة لمسلميهم والجبرت منهم بصفة خاصة والذي لم يتوقف طوال الألف سنة الماضية – كل هذه إنما كانت محاولات عبثيه استمدت حياتها من ضيق الرؤية و الأفق والتعصب. ولقد هوت تللك الإمبراطوريه العتيقه وهوت معها مؤسساتها وطرائقها ذات صباح في الربع الأخير من القرن العشرين حين استولى ضباط وعسكر شيوعييون على مقاليد الأمور فألغوا الملكية و بدلوا أو أنهم ألغوا دور الكنيسه والدين في شؤون الدولة وإلى الأبد، إن شاء الله، وبذلك تغير شرط المواطنة الذي كان مضمراً في النظام البالي، ومن هنا فقط ومن بعض الإعتبارات يمكن القول أنه كانت هناك اسهامات خالدة للشيوعية والشيوعيين في الحبشة، إسهامات تتعدى فترة حكمهم القصيرة في تأثيرها بمئات المرات ، ومن هذا الباب فقط يتحتّم دخلوهم التاريخ من أوسع أبوابه مُنْصِفين مُنْصَفين حتى وإن كانت أيديهم ، ويا للأسف، تقطر دماً. إن قصّة الشيوعين الأحباش هنا ليست في حقيقة أمرها إلاّ تكراراً لقصة القيصر الروسي “إيفان الرهيب” في سياق حبشي حديث، فكلاهما أراد حرق المراحل ودفع أمته لدخول مضمار التقدم بالقوة الجبرية والعنف، وإراقة الدماء، والجريمة التي لا تبرير لها سوى نفسها، ولكن حكم التاريخ فيما يبدو وفي أغلب الأحيان يُظْهِر ودّا وحرارة في وجه إيفان مبرّرا إسهاماته في ميادين الإقتصاد والعلوم والفنون وإتاحة الفرصة لروسيا بالتجارة والتأثر بأوروبا من خلال غزوه بولندا،وإيقافه تقدم العثمانيين وتحديد أثرهم في البلقان فقط، فهل يُستغرب إذن لو برّر التاريخ الدماء التي سالت في إريتريا وإيثيوبيا مقابل تلك الضربة العظيمة في ليلة فَصلت فيه الدوله نفسها عن توأمها السيامي، الكنيسه، والذي لازمها منذ عام 1272مع قيام مُلك الأسرة السليمانية؟ لقد كانت تلك مغامرة ومخاطرة ولكنهم ركبوها ومازال المبدأ منذ ليلتهم تلك هو نفس المبدأ: الدين لله والوطن للجميع! هذا على الأقل من الناحية الدستورية النظريه وهي ناحية لها أهمية حيويه يدركها كل من عاش يقظاً لأربعين عاماً، وما قيمة أربعين عاماً في عمر الأمم في ظنّك؟!!.. عبرة أخرى هي أن الجبرت عاشوا كما اختاروا وذهب من حاول تطويع ضمائرهم مذهب الريح، وصدق من قال “لا إكراه في الدين”.
وبجانب ضريح النجاشي هذا كانت هناك أضرحة شيوخ الصوفية الأخر، هناك ضريح “الشيخ أدم الِكناني” في قرية تبعد حوالي المئة كيلومتر من مدينة أسمرة. وأحفاد الشيخ الكناني الذين يؤلفون عائلة ” قسم الله ” من أعيان أسمرة ووجهائها. ويخصص يوم معلوم من السنة للزيارة العامة للضريح وقراءة القرآن وإنشاد المدائح النبويه المكتوبه احياناً باللغة المحليه و هذه عادة ما تكون أشجاها وأكثرها فصاحة عند مخاطبتها الوجدان . ولكن أعجب الأضرحة في أسمرة وضواحيها كانت أضرحة أولياء لم يُعرَف عنهم أنهم وطئوا تلك الأرض، مثال ذلك هو الشيخ عبدالقادر الجيلاني الذي أقيم له ضريح عند مسجد من أكبر مساجد أسمرة والمسمي باسمه. ولقد سأل الشيخ عمر الحداد، الواعظ الحضرمي والذي كان يميل إلى التشدد، سأل جمعاً من الجبرت عن كيف تأتّى أن يكون هنا مرقد وضريح للشيخ الجيلاني وهو لم يطأ مدينتكم أبداً؟ ولم يجد رداً على سؤاله منهم لأن الرد كان هناك في العمل نفسه. إقامة الضريح كان تحقيق جزء من أمنية ترقد في الأعماق، فكثيراً ما تمنوا لو كان الشيخ قد عاش ومشى ومات بينهم وأقصى ما كان بوسعهم أن يفعلوا لتحقيق ذلك في عالم الواقع والشهود كان إقامة ضريح له حتى ولو لم يكن يحوي رفاته. إن الضريح كان تعبيراً عن رغبة وأمنيه وهوى، فهل هناك تعبير عن الحب أبلغ من هذا؟
ويتبقّى الكثير!فإلى اللقاء
desouki.k@gmail.com