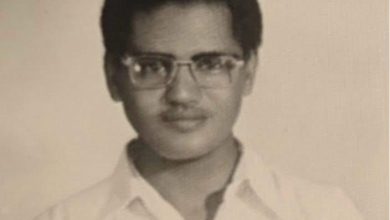الحراك الشبابي الارتري وحراس المعبد القديم بقلم / محمد قناد
14-May-2014
عدوليس
عندما يدخل الشاب في جلباب الكهنوت، تفقد قوته حداثتها وتنتهي للشيخوخة المبكرة، وعندما ينعزل الشاب في جزيرته الشبابية، يفقد الروية الواضحة وتقديره لعمق المحيط، وذلك لغياب خرائط الماضي عنه، وبين فلسفة التحرر من أفكار السابقين، و اخذ الخبرة والعظات ومسارات التاريخ من السابقين، تنزوي فلسفة الإرادة، وتسقط بين حدين أو تتقاطع بين تيارين، المحافظ القديم والجديد الصاعد، وأي محاولة للالتئام بين الاثنين، ستنتهي بانتصار احدهم علي الآخر، غالباً ما يكون المنتصر هو التاريخ، ما يعني سقوط القوة الشبابية في المستنقع الاثن ليعيش الحالة الدوغماتية، والتي لا ترقب في أي تفكيك لحالتها، وهنا تولد اللحظة التاريخية التي يعاني منها المجتمع الارتري الآن، وما يعني قبول الشاب إن يكون قناع جديد للتاريخ القديم، إذ تعبر عبره كل الأمراض السابقة، لتتربع في الحاضر، ومن ثم تتسلل للمستقبل، لتقتل كل الطموحات في وطن يسع الجميع، ليلم حوله ما تبقى من عبق إنسانه، ورموزه المتناثرة حول العالم.
والشاب الارتري رغم التجارب، يزل هو ابن التاريخ، الذي لا يريد أن ينفك عن قيود الكهنوت السياسي، والعكس تماماً، وبين إمكانية خلق واقع مختلف نظرياً، تظهر عدم إمكانية تطبيق كل النظريات التي عانقت أشواق الحلم (لنا حلم)، وبقت حبيسة الإدراج، وقاعات التفلسف، وأحيانا منطقة تحور للمبادئ كما هو في حالة الحراك الشبابي الوطني، فالمجتمع الشبابي الذي أصبح كطائر مهيض الجناح، اذ تصطاده اضعف صفحات التاريخ، والذي تدخله في نفقها، لأبد لنا أن نستوقف فيه، وندرس علله، وتتم عملية تحليل لمنجزاته، لان منجزاته حسب التخيل الذي ابتدعه لنفسه -الحراك الشبابي- كظاهرة، والمعايير التي افترض علي أساسها بأنه قد أصاب بعض الأهداف الوطنية، أو ما يدعى بالنجاح الأولي، ذلك بتحريك البركة الراكدة، التي قد ينتفع من تحريكها الآخر المراد تغيره، لذا قد تعتبر منجزات افتراضية، والمصيبة لو لم تستطع حتى في افتراضها بناء صرح مجتمعي متماسك، أو فكرة تتجاوز علل الماضي التي أقعدتنا في مقاهي الغربة، ومعسكرات اللجوء. فقد حدثتني نفسي ذات يوم إجراء مفاضلة او مقارنة، بين الاجتماع الارتري ما قبل بروز الشبكة العنكبوتية وما بعدها، ما يعني بديهياً التوقف بين علم الاجتماع السابق الطبيعي، وعلم الاجتماع الالكتروني، وحاولت ابتداع آليات ومعايير تفضي بي إلي نتائج أولية في استكشاف ما طراء من جديد، وما تحول من قديم، واستنطاق الحراك بين الأمس الوجودي والحاضر الالكتروني، وكانت أسبابي فيه محدده، ودواعي البحث كانت مجهولة في الدقة لكنها معلومة في العموم، لعموم نشوء البحث علي قاعدة الشك قبل اليقين، التيقن الذي حددته الطبيعة بان كل يوم تشرق فيه الشمس لأبد من إضافة وجديد فيه، وهذا يعني لأبد من تطور الحركة الشبابية الوطنية فكرياً، قبل ان يكون لها واقع ذات يوم، في مصيرنا التاريخي ومسيرتنا الوطنية، لتكون المقارنة بين الأمس واليوم، بين الحاضر الوجودي والغائب الافتراضي، بين أن تكون الفكرة حبيسة المواقع والصفحات، وبين أن تعيش اللافكرة واقع الوجود الحسي الذي يمارسه النظام الحاكم والذي يقوم علي عدم وجود الفكرة أو قتلها، وبين المعارضة المتجمعة في منطقة وسطى بين الفكرة الوطنية والتاريخ المختلط بالمرارات الشخصية والمناطقية.لذلك تعتبر اللحظة التاريخية للدولة الارترية غامضة وجنينها القادم غير مكتمل الملامح حتى الآن، وهنا تقتدي اللحظة فكرا جديد، يستوعب عللها وأزماتها، ويحللها ويفكك ما تراكم بشكل خاطئ في مسيرتها، مصحوباً بأدوات تنفيذ طبيعية، أو تحديث لبنية الفكر الوطني، وتقوية مرتكزا ته، بحيث لا تعسف به أي هبة وطنية قادمة حتماً لا محال، وذلك وفق صيرورة الزمان وما حدثنا ويحدثنا به التاريخ، ولان كثير من التفاسير والاستقراءات السياسية للحالة الارترية تذهب لتخيل سيناريو مخيف، ونحن نقف هنا نحذر من استمرار التفكير الأحادي، لأنه معلوم أن أي عمل تغيري يكون عماده الشباب المعجون بحكمة الشياب، وذلك حتى يكون تغير طبيعي وحقيقي، والسياسة الارترية تحتاج ثورة فكرية قبل الشروع في أي عمل تغيري، حتى لا ندخل في نفق جديد بعد التغير لا نستطيع وصفه كيف سيكون، لكن بالتأكيد إذا ما دخله الوطن علي هذا الوضع للمعارضة الارترية شيبها وشبابها، سيكون وبال علي الوطن أكثر مما عليه الآن.وأننا هنا لا نفترض أو نصنع حالة توهان، أو مفاضلة بين الوضع القائم في الوطن، والوضع القادم للمعارضة إن نجحت وفق واقعها الحالي، ولا يمكن إبدأ وإظهار ذلك حتى إيحائيا، لان المفاضلة بين القاتل والمقتول، أو السارق والمسروق جريمة فكرية، وعدم مسؤولية كتابية، لكننا هنا نرسم الواقع بين نظرتين، بين الشباب الذي يبحث عن صناعة اللحظة الفارقة، والشياب الذين يريدون احتواء الشباب في ذات القوالب القديمة، ما يعني ضياع الحركة الشبابية الوطنية، ودخلوها في نفق اجترار التاريخ وتوقف مدها، وعنفوان طاقتها، لتنتهي داخل جلباب الماضي الكلي، ليفضي لتمظهر اجتماعي حداثي الشكل، قديم الفكر، وبينهم دائماً تتكون هوة وتصدع، لا يردمها سوأ المخربين وأصحاب الأطماع اللأوطنية، أو ما يسمى بالانتهازيين، فالمقارنة الطبيعية هي بين الحراك الشبابي والخطاب المعارض، لان النظام خرج من الحركة التاريخية والكل يتخلص منه حتى أنصاره، إن لم يحدث تغيرات جذرية ومحاكمات عادلة، وتجديد لخطابة السياسي بحيث يتقبل الآخر ويتضمنه في النص السياسي والقانوني، وهو ما يصعب حدوثه. لذلك الشباب الارتري عودنا بأنه يبدأ عمله الوطني علي هاجس الآخر، هكذا فهمنا من متابعتنا للحركة الوطنية الشبابية عموماً مع حفظ الاستثناء، والآخر دائماً عندما يكون مفترض في نشوء الفكرة الأساسية يعني ظهور الثغرة القاتلة للفكرة، ومواتها السريع، لان الفكر الوطني لا يقبل كلمة الآخر، فالكل فيه واحد وللكل فيه نصيب، ولأنه يجب ان يتأسس علي مقدار مساحة الوطن الكاملة، دون إنقاص أو إقصاء أو تقليص لمنطقة أو جغرافية بشرية محددة، وهذه الأزمة التي يعيشها الفكر الشبابي أو الحراك الشبابي الوطني، توجد بشكل كبير في فكر السابقين في المجال الوطني، وهم سبب من أسباب استمرار الوضع القائم في الوطن، ذلك لعدم توصلهم لوثيقة مشتركة، تشخص القضية بشكل حقيقي، وتساعد في تدويلها تدويل تستحقه بخطاب وطني جامع، يحس فيه العالم بمرارة قضيتنا الوطنية والإنسانية، وخلع الستار الذي تختفي خلفه مشكلتنا، والتي هي إنسانية كاملة المعايير التي وفقها تحدد وتعبر عن انتهاك حقوق الإنسان. فالكهنوت السياسي الذي يتجمع الآن وفق مساحيق جديدة، وفي محاولة جديدة لبناء طروادة يخترق به حصن الشباب المتصدع في الأصل، نتيجة لحمله تناقض الخطاب السياسي الذي اعتدناه في الساحة الارترية، وذلك في تناوله وتحليله للقضية بشكل عام، وهنا يجب إن نعلم ونتعلم الفرق الواضح بين الأبوية التوجيهية، والأبوية الأستحكامية أو ديكتاتورية حضور الماضي القديم، فالأولى هي مجرد نصيحة وتراكم خبرة للشباب الخيار في اخذها أو تركها، والثانية تجعل من الشباب مجرد اداءة او آلة تنفذ أحقاد الماضي السحيق، وتعيش المستقبل تحت نير استبداد التاريخ، وذلك بين الاتجاهات المعارضة لبعضها قبل أن تعارض عصبة اسمرا، وحقيقة هذا الوضع الشبابي يتمثل جلياً في الحركة الاحتجاجية، التي لم تستطيع حتى الآن تنظيم حدث تاريخي موحد، رغم ما لها من أدوات تواصل اجتماعي واتصالي، ويعزى ذلك لتنافرها القادم من الماضي المتحكم فيه الكهنوت السياسي، فالكهنوت علمنا بأنه دائما يحمل خطابين، احدهم للاستهلاك السياسي والآخر في الأطر الضيقة، وهو ما افقد الثقة فيهم، وقد حاول الشباب التكون الجنيني والانطلاق بغيرهم او بعيد عنهم، لكن لحق بهم و أوقع الشباب في شباك الخطابيين، والذي ينتهي للتناقض والتنافر، لأنه لا يستمر في إخفاء الخطاب الحقيقي بمساحيق الخطاب السياسي الاستهلاكي، ولأنه في عالم السياسة عندما تأتي لحظة تتطلب موقف سياسي معلن، يظهر النفاق السياسي وكذب الخطاب الاستهلاكي مما يعجل بظهور الخطاب الخاص او ما يسمى بالأجندة الخاصة التي تتعارض مع الخطاب السياسي للمنظومة القائمة.وهكذا قبل أن ندخل في أي تحليل لأسباب عدم تطور هذا العمل، منذ لحظة نشوء الحركة الوطنية الشبابية الحالية، ما بعد التحرير، وما تطور بعد الحراك الشبابي في الشبكة العنكبوتية، رغم ما أتيح لها من أدوات خلق نسيج شبابي قوي، وكذلك في مواقع التواصل الذي كان يمكن استخدامها بطرق امثل في تشجيع العملية الثورية، أو الحالة السياسي المعارضة للنظام قبل السقوط في مستنقع استعداء الآخر، الذي يعاني من ذات ما يعاني الأخر المفترض لعداوة الآخر الأول، لأنهم يعيشون ذات الظروف التي يعاني منها الوطن جميعاً، وهنا نجد أنفسنا من هامش الأشكال نتعرف علي علل الواقع الشبابي، دون الدخول لمركزية المشكلة المتسببة في فقدان البوصلة للخطاب الشبابي، التي تنطلق من التاريخ الذي يفرض نفسه أو ما يسمى بديكتاتورية الماضي، أإما ما خلقة وابتدعه الاجتماع الالكتروني من إمكانية حركة افتراضية، قد تتطور يوما ما إلي واقع ماثل أمام العيان، يثبت جدية طرحة لكنه -أي الافتراض- أصبح في الانتظار زمن طويل وعمرا مديد، والأشكال انه يحاول كل مره الإسقاط الماضوي في حاضر الشباب ومستقبلهم، وينجح في ذلك، لنأتي من جديد في كل صباح نبدأ من الأول باسم وشعار جديد وننتهي إلي ما انتهينا له سابقاً، ما يعني تحميل الأجيال جينات التنافر والبعد عن الآخر (إن وجد آخر) وهنا بالطبع ستتعمق حالة الاستلاب ثقافياً وسياسياً، نتيجة لإفرازات حتمية التفرقة الاجتماعية. فان ما يعرف بثقافة الجموع الشبابية العنكبوتية الآن، وبأدوات علم الاجتماع الالكتروني، لتحليل هذا الحراك، نجد الشباب الارتري يعاني من صناعة آخر وعدم تقبله للأخر الذي تخيله، وابتداع خطابين داخلي -أجندة- وخارجي للاستهلاك السياسي، وذلك في رحلته الثورية وحراكه الوطني، ولا يبتدع ما يطمر هذه التصدعات الاجتماعية التي ينجبها حالة وجود الخطابين، بقدر ما يساهم في تعميق الهوة الوطنية، وابتداع تشققات جديدة، لا يمكن رأبها إلا بتكلفة عالية، من البحث الشاق في إظهار ما يجمع الشعب، لتتم معالجة هذه الحالات أو التمظهرات، وكذلك معالجة الأفكار الانطباعية في زمن طويل، لان الأفكار التي تفرق، بالطبع لا تتجانس مع مفهوم الدولة القطرية التي تستوعب الجميع تحت سقف الوطن الواحد، وهكذا يخرج الشاب الثوري الوطني دون أن يحس من حركة التاريخ الحقيقية، إلي حركة هلامية افتراضية تنعزل به عن حقيقة الأرض وما يحدث فيها، لينتهي فكره إلي تبني ما هو أقصى شذوذا عن الحالة الوطنية.وذلك بتبني خيارات طائفية، أو مناطقية، انتصاراً لذاته التي مرضت في انتظار اللحظة التاريخية، التي مفترض أن يتوج فيها بطل قومي، ولا يعلم أن بدايته الخاطئة، هي التي جعلت منه هكذا ينتهي إلي صحراء الرمال المتحركة، وسراب خداع، ليأتي مصرخاً وسط كثوب الرمال اللاوطنية، الموحلة لحركته، وهنا ينتهي صارخا، وهنا يلعن كل الذين وثق فيهم، وفي فكرهم، وطريقتهم ذات يوم، و اودوا به إلي التهلكة الوطنية، ثم يصبح هو ذاته، دليلً جديد سيتوه خلفه جيل آخر، وجيل اثر جيل ينتهي إلي ذات الصحراء، وهنا يسخر القدر، عندما تتجمع الأجيال التي تجتر بعضها إلي ذات المكان في صفحات التاريخ متسائلا، ألم يتعلم هؤلاء من السابقين، ودون إن يكون بينهم جيل يقول لا لن نسمح للقادمين، أن ينتهوا لذات ما انتهينا نحن إليه، وهناك يتوقف التاريخ فوق ركام الانهزامية يحدثهم عن الخيبة، وعن عدم استيعاب و استوعاب الواقع، ويرسم لوحتهم الباهتة، وصورتهم الممسوخة، وتستمر المسرحية، ستار وراء ستار فصل من بعد فصل، جرح من بعد جرح، ولا احد يتعلم أو يريد أن يبحث عن أصل الداء، فندور جميعاً حول المعبد القديم، ونصبح دون أن نعي من حراسه، نتجدد في حراسته وحمايته من التجديد الذي يعالج تشققه وتصدعاته ورأب ما يقوم عليه من تل، فننتهي جميعاً للعدمية الوطنية، ونصبح كالثور الهائج نتخبط يميناً ويساراً، بين المناطقية والطائفية والقبلية والحزبية، ولا احد يقول يريد أن يذهب للحقيقة ليعود منها بفكرة صحيحة.