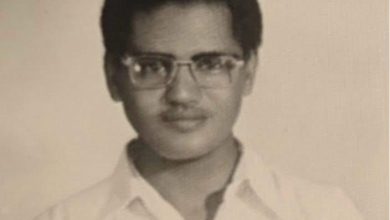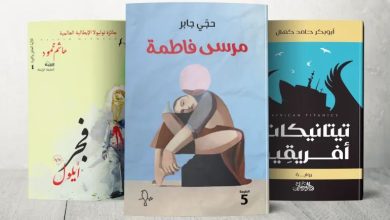القرن الافريقي .. منطق التاريخ وتقاطع المصالح : بقلم / علي الغامدي
25-Mar-2007
المركز
صحيفة الأتحاد الظبيانية :17/3/2007م
جغرافيا تعرف المنطقة النافرة من شرق القارة السمراء ، بمنطقة القرن الافريقي التي تضم سياسيا الصومال واثيوبيا وارتريا وجيبوتي وكينيا ، والى حدما اوغندا . اما القرن الافريقي جيو استراتيجيا فله تشعبات كثيرة تضم اليمن وبلدان جنوب الجزيرة والخليج ،
وهي حيوية جدا على تماس مع الأمن القومي العربي الذي تعد امتدادا له ، خاصة ان هذه المنطقة تمسك بعصب الحياة في أهم وأكبر دولتين في عربيتين في افريقيا مصر والسودان ، فمن اثيوبيا وأوغندا تجري مياه النيل شريان الحياة في الوادي الذي يحمل الاسم ذاته ، وهو كذلك بالنسبة لكل الاراضي التي يمر بها من المنبع الى المصب ، ورغم هذه الاهمية الجيوسياسية للمنطقة ، الا نصيبها من الاهتمام العربي لم يكن بالقدر الذي ينبغي ان يكون عليه ، وقد كان لهذه المنطقة اتصال حضاري بالعرب منذ حقب التاريخ المبكرة ، وكذلك بالاسلام الذي دخل هذه البقاع مع بدايات الدعوة الاسلامية ، وقد تعاظمت الاهمية الاستراتيجية للمنطقة مع ظهور النفط كعامل حاسم في المصالح الدولية باعتبارها تقع بالقرب من منابعه وموانىء تصديره ، كما أنها منطقة مضطربة تضم مسلمين ومسيحيين وقوميات عربية وغير عربية بل إن عدد القوميات في اثيوبيا وحدها لايعد ولايحصى . يقول الكاتب والمؤرخ الارتري محمد سعيد ناود في معرض حديثه عن الارتباط التاريخي بين العرب وهذه الأجزاء من القارة الافريقية إن ارتباط هذا الجزء من القارة الافريقية بالعالم العربي ارتباط قديم موغل في القدم ، وهي تختلف كليا في الكثير من اوجهها عن باقي الهجرات التي عرفتها البشرية في مناطق عدة من الكرة الارضية . وقدم هذا التواصل ينعكس اليوم في التأثير والتأثر الواضح والترابط والوجدان واللغة والثقافة والسمات البشرية . ويقول ناود ان العوامل الرئيسية وراء اسباب هذه الهجرات متنوعة ولكن في مقدمتها الظروف الطبيعية القاسية في ارض العرب ، ويذهب بعيدا للقول ان بعض المؤرخين يعتقدون ان العنصر المعروف باسم كوش بن حام بن سيدنا نوح هم أول من سكن سواحل البحر الأحمر الغربية ، ويرجحون أن يكونوا الأصول الأولى للقدماء المصريين ، كما يشيرون الى الهجرة السبئية من جنوب الجزيرة العربية التي تركت بصماتها وآثارها بشكل واضح من خلال موجات متتالية للقبائل السبئية القادمة مما يعرف حاليا باليمن وحضرموت . وقال ناود إن الكتب لاتحدد لنا الكيفية التي جاءت بها هذه الموجات أو أعدادها ، ولكن من الثابت انها جرت قبل ميلاد السيد المسيح بآلاف السنين ، البعض يذهب الى ما لايقل عن عشرة الاف عام ، وقال إن النقوش الحجرية المكتشفة تشير الى قبائل سبئية وحميرية عبرت البحر الاحمر عن طريق باب المندب وجزر دهلك باتجاه مرتفعات ارتريا والحبشة ، وكان على رأس هذه القبائل النازحة من الجنوب العربي قبيلة تدعى الأجاعز اختارت الاستيطان في الاقسام الجنوبية من المرتفعات الارترية ، ومنها انتشرت لغتها الجئزية وهي لغة سامية مكتوبة ومعروفة بين سكان الهضبة ، وهناك قبيلة أخرى عبرت البحر الاحمر تدعى قبيلة حبشات استقرت الى الجنوب من موطن القبيلة الاولى ، فيما يعرف حاليا باقليم تجراي في الحبشة ، والذي في ربوعه قامت مملكة اكسوم التاريخية ، وبمرور الايام أطلق اسم الحبشة على سائر البلاد . ويقول ناود إن الاحباش مدينون للجنوب العربي من ناحيتين : الأسم الذي عرفت به بلادهم ، ومن ناحية اكتسابهم اللغة المكتوبة التي كانت مفتاح حضارتهم وكتبوا بها تاريخهم وتراثهم . ويواصل مستطردا اتجه جزء من المهاجرين العرب كذلك الى هضبة هرر في القسم الشرقي من المرتفعات ، معهم ومن خلالهم دخلت لهجاتهم السامية وحضارتهم السبئية ، بما في ذلك الحرف السبئي في الكتابة ومهاراتهم العمرانية والزراعية . ويقول ناود لقد حطت هذه القبائل رحالها فوق الهضبة الارترية والحبشية ومعها كنوز لاتقدر من التراث الأصيل ومعالم حضارة عريقة متمثلة في اللغة المكتوبة والمهارات الزراعية والأساليب الجديدة في التحكم في مياه الامطار من خلال انشاء المدرجات والمسطحات الزراعية على سفوح الجبال وزراعتها بالمحاصيل الغذائية ، وكذلك بناء السدود استنادا لخبرتهم في بناء سد مأرب . ويقول ناود ان اول لغة سبئية دخلت البلاد هي اللغة الجئزية التي سرعان ما اندثرت بتأثير اللهجات المحلية التي تغلبت عليها اللهجات الكوشية حتى انحصر استخدامها في الطقوس الدينية ومدونات الكنيسة بعد ان اعتنق الاحباش المسيحية في القرن الرابع الميلادي ، كما تشير الكتب ايضا الى وصول اعداد كبيرة من عرب جنوب الجزيرة في القرنين السابقين للميلاد استقر بعضهم في الحبشة ، بينما اتجه البعض الآخر مع النيل الى بلاد النوبة . ويقول ناود ان ابن خلدون أشار الى استقرار اعداد كبيرة من عرب اليمن في بلاد النوبة والسودان حوالي القرن الأول قبل الميلاد ، كما أن مجموعات أخرى من القبائل العربية جاءت الى اراضي البجة في القرن السادس الميلادي أي قبل ظهور الاسلام ، وقد ضمت هذه المجموعات بطونا من قبائل حمير . وقال ناود ان الظاهرة البارزة لهجرة القبائل العربية في ذلك الوقت اتجاههم للعمل في المناجم لاستخراج الذهب والمعادن النفيسة في اقليم البجة الذي كان يمتد من جنوب اسوان حتى الهضبة الشمالية من ارتريا . واختلطت قبيلة بلي اليمنية بالبجة ايام حكم البطالمة لمصر ، والذين كانوا يعتمدون عليهم كثيرا في تجارتهم عبر البحر الاحمر وحراسة قوافل هذه التجارة ، ويبدو ان عددا من قبيلة بلي تركت التجارة وآثرت الاستقرار في بلاد البجة واصبحت الطبقة الحاكمة فيها . ويختم ناود هذا السرد التاريخي بالوصول الى مرحلة ظهور الاسلام وهجرة بعض صحابة رسول الله ( ص ) ، وقال إن الدفعة الأولى من هؤلاء المهاجرين كانت تزيد عن العشرة أشخاص من بينهم عثمان بن عفان ( رض ) وزوجته ام كلثوم ابنة النبي ( ص ) . وقال إن الميناء الذي رست فيه سفينة المهاجرين من المسلمين الأوائل كان ميناء ( معدر ) على الشاطىء الأرتري حاليا ومن ثم ساروا الى مملكة اكسوم ، حيث أكرم النجاشي وفادتهم . وقال إن التواصل الإسلامي استمر حتى عهد الدولة العباسية التي كانت لها حروب مع عظيم البجة مكنون بن عبد العزيز في اسوان الذي اعترفت بعد ذلك بمملكته وأبرمت معاهدة معه مقابل أداء الخراج . ويقول المؤرخ الأرتري محمد سعيد ناود إن الشاطئين الشرقي والغربي للبحر الاحمر مرتبطان تاريخيا ومصيريا ثقافيا وحضاريا ودينيا ومصالح مشتركة منذ القدم ، بحكم الهجرات المتتالية من جزيرة العرب باتجاه منطقة القرن الافريقي ، وقد اخذت مسلك وممرات مختلفة باتجاه موانىء لعبت ادوارا هامة في تاريخ هذه المنطقة مثل عيذاب وسواكن ومصوع وزيلع وبربرة ومقديشو ، او الهجرات الاخرى التي تمت عبر باب المندب واتجهت شمالا أو تلك التي تمت عبر مصر واتجهت جنوبا . ويضيف ، ومن هنا يجىء ايضا التأثير الأبرز الذي يتضح من خلال انتقال الاديان كما هي في الجزيرة العربية الى هذه المنطقة ، فاليهودية والمسيحية والاسلام كلها نزحت مباشرة الى المنطقة من الجزيرة العربية . وقبلها كانت الوثنية التي كانت سائدة في ممالك سبأ وحمير والحجاز من بعدهما . وعلى الرغم من بعض الحروب التي كانت تنشب بين الدويلات الإسلامية وملك الحبشة المسيحية ، الا ان ذلك لم يمنع من تعايش الأديان والشعوب والقوميات في أتون الحضارات المتلاحقة في هذه المنطقة في اجواء من التسامح . القوى الاستعمارية .. واثارة الشعوب : يقول الكاتب والمؤرخ الارتري محمد سعيد ناود في كتابه العروبة والاسلام في القرن الافريقي : ان شعوب هذا الجزء من القارة الإفريقية عاشت في حالة من التسامح والعلاقات الطيبة رغم اختلاف معتقداتهم الدينية حتى وصول القوى الخارجية بدءا من الحملات الصليبية وحتى الاستعمار الحديث . وقال ان تلك القوى التي كان يحركها الدافع الاستعماري حاولت تغليف دوافعها بطابع ديني من خلال غرس مخاوف وحساسيات وسط الحبشة التي يقول إنها استسلمت لهذه الطروحات بأنها القطر المسيحي الوحيد في افريقيا يحيط به بحر من الاسلام والوثنية . وقال ناود إن هذه الطروحات أثمرت عن سياسة خاطئة في الحبشة دائمة التطلع والاستنجاد بما وراء البحار ولاسيما نحو اوروبا .وقال : نلاحظ في الحروب الصليبية عندما ظهرت فكرة اقامة حلف تشترك فيه الحبشة للإطباق على مصر من الشمال والجنوب ، وكذلك ظهرت فكرة تحويل مجرى النيل لحرمان مصر منه فقد نشأت فكرة التحالف الأوربي الحبشي عام 1222م . بعد فشل الحملة الصليبية الخامسة عندما ارسل أسقف عكا ( جلك دي متري ) رسالة الى ملك الحبشة يدعوه للإنضمام الى هذا الحلف من اجل انقاذ الأماكن المسيحية المقدسة من يد المسلمين ، واتفق معه على حملة مزدوجة للإطباق على مصر من الشمال والجنوب . ولم يتم تنفيذ مثل هذا الحلف لصعوبته كما ان داؤود بن يوسف ملك الحبشة ( 1381 _ 1411م ) هدد بتحويل مجرى النيل ، وقام بشن هجوم على حدود مصر وبلغ اسوان مستغلا حالة الفوضى التي كانت تضرب مصر في عصر السلطان برفوق المملوكي . وهذه الاطماع الاستعمارية لم تمنع ايطاليا المسيحية من محاولة اجتياح اثيوبيا المسيحية ايضا بعد ان احتلت ارتريا بالكامل واعلنتها مستعمرة تابعة لها في العام 1890م ، لأن الامبراطور الاثيوبي منليك نجح في التصدي لها والحق هزيمة نكراء بالقوات الايطالية في معركة عدوا الشهيرة . وبعد سنوات من تلك الهزيمة قامت ايطاليا الفاشية بقيادة موسوليني باجتياح اثيوبيا واستعمرتها بالكامل حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ، وهرب الامبراطور هيلاسيلاسي ولم يعد الى بلاده ويسترد عرشه إلا بعد تحرير قوات الحلفاء لها . ومن امثلة المصالح قبل العقائد يضرب ناود مثالا آخر عندما انطلقت المقاتلات البريطانية من قواعدها في عدن لقصف اكسوم في قلب تجراي التي تعد عاصمة الكنائس الاثيوبية وساعدت هيلاسيلاسي على سحق تمرد اهلها الذين بلغ التنافس بينهم وبين الامهرا أشده ، وثار شعب التجراي بقيادة منظمته ( وياني ) على هيلاسيلاسي وتمكن من السيطرة على اقليم تجراي بأسره ، إلا ان تحالف بريطانيا مع الامبراطور اجهض تلك الثورة . ويختم ناود أراه بالقول : ان الاطماع مازالت قائمة وكذلك الادوار وإن اختلفت الوجوه . وبعد هذه الجرعة من التاريخ ، خرجت بصحبة الرجل الثمانيني _ امده الله بالصحة والعافية _ من ذلك المبنى المقام على ربوة على الطراز الايطالي ويضم عدة دوائر حكومية لنتمشى باتجاه اسمرا التي كانت كعادتها في العصاري هادئة بانتظار سكون الليل ورغم سنوات الكد والكفاح المثقل بالذكريات كان الرجل مفعما بالنشاط وهو يقودني عبر الطرق التي تحف بها الاشجار نحو مكتبة أنيقة ، حيث تعرض مؤلفاته . وما لايعرفه الكثيرون منا ان ناود أسس وقاد في نوفمبر من العام 1958م حركة تحرير ارتريا ، وظل مواكبا للعمل السياسي حتى تحقق حلمه باستقلال بلاده في 24 مايو 1991م والى جانب تفرغه للكتابة الصحفية يعمل مستشارا في قسم الدراسات التابع لمكتب الرئيس في اسمرا .