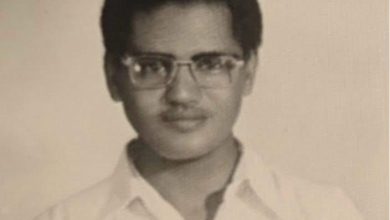عرفتُ لماذا كان وجه تشي جيفارا بتلك النصاعة ….. وعبد القادر حكيم يكتب عن هنقلا !

20-Sep-2020
عدوليس
على قلة الأيام التي كان الشهيد يقضيها في منزله؛ والتي قد تقتصر أحياناً على يومين إثنين، فإنه كان عادة، وافر النشاط، يستيقظ باكراً، يتناول شاهي الصباح والذي كان يفضله أسوداً مع نصف رغيف من خبز، مع أولاده أو مع الضيوف الذين نادراً ما تخلو الدار عن تواجدهم، يقرأ قليلاً ويجلس إلى الكتابة لنحو ساعة أو أقل، ثم يخرج في مهمات عمل إلى بعض أنحاء المدينة. يعود في الظهيرة، غالباً مع موعد أوبتنا من المدرسة أو بعده بقليل.. يرتدي إزاراً أو ما يعرف بالفوطة، مع قميص قطني – على عادة المناضلين الإرتريين في أوقات راحتهم – ويبدأ فى مراجعة كراسات أبنائه واحداً تلو الآخر، مدققاً ومنتبهاً إلى تلك التفاصيل
الصغيرة، ثم قد يصدر تعليماته إلينا أنا وإبنه الأكبر صلاح بضرورة مساعدة من يلحظ ضعفاً في الإملاء أو الحساب وحتى الخط في كراساتهم، ويضع لنا جدولاً لذلك، ويحدد لنا زمناً لإنجاز ذلك لا يتعدى الساعة.
يصعب عليّ كتابة شهادتي؛ ربما كان الأمر سيكون مختلفاً لو كانت عن زميل/ صديق / شخصٌ ما عابر كسحابة أو كطائر موسميّ يلتقيك/ تتقاطع طرقكما عند محطة ما قد تكون للإياب أو للمضي قدماً نحو مسارات مختلفة أو مؤتلفة.. بيد أنني هنا، أكتب عن رجلٍ كان لي أباً وأخاً وقائد. بعد أعوام طويلة على رحيله الفاجع، تسنّى لي معرفة نتف من سلوكه العسكري المنضبط جداً، عبر حكايا بعض رفاقه المناضلين، إلتقيتُ بعضهم في إريتريا أبان تواجدي هناك في الأعوام بين 1990 و2000.. ذهلتُ لما سمعت عن صرامته وعدم تساهله مع كل ما من شأنه الإخلال بالعقيدة العسكرية الثورية المنضبطة، فعرفتُ بعد حين أنه، أي الشهيد، كان في الميدان يدخل المعركة كي ينتصر أو يموت بشرف، ويعدّ في سبيل ذلك ما استطاع من العتاد، وفي داره بكسلا كان يدخل معركة أخرى هي معركة التربية والتي هي مسؤولية من نوع آخر سلاحها العطف والحنان والرأفة، والشدة إذا اقتضت الضرورة… يفعل ذلك بوجه يحمل من آثار معاركه التي خاضها في سهول وجبال الوطن بعضاً من غبارها وجديتها.. ولذا كان لحضوره ذلك المزيج بين الأب التقليدي كمعظم الآباء في تلك الحقبة، ذي شخصية جادة، قليل الكلام، تقاطيع وجهه تشي بالكثير دون أن يقول شيئاً، مما يجعلك تنتقي كلماتك التي تقولها في حضرته وتحرص على حسن قولك وسلوكك، وبين الأخ الأكبر من جهة أخرى، والذي معه يتبسط معك في القول دون تكلف، ويحاول معرفة أحوالك، إهتماماتك، أداؤك في الدرس، هواياتك. كان الشهيد في بيته حريصاً كل الحرص على تنشئة أبنائه وبناء شخصياتهم، ولذلك لم يحدث قط أن رأيته يصرخ في وجه أحدنا مهما كان الذنب المقترف من ذلك النوع الذي يتأرجح بين شقاوة الأطفال وعناد سن المراهقة والسنين التي تليها.. بل لم أره غاضباً إلاّ في مرة واحدة سيأتي ذكرها لاحقاً.
في ذلك الزمن البعيد كنّا أنا وصلاح نداوم على الذهاب بشكل يومي إلى مكتبة وزارة الإعلام بالمدينة، تلك المكتبة التي كانت تزخر بأمهات الكتب، قرأنا سوياً كل مجلدات ألف ليلة وليلة من الألف إلى الياء وعبقريات العقاد، ثم أخذ كل منا يقرأ على نحو مستقل، عكفتُ أنا على قراءة المعلقات السبع وروايات يوسف السباعي وقصص يوسف إدريس، وإهتم صلاح بقراءة كتب التاريخ والفلسفة.. حين إكتشف الشهيد ذلك، وكان عائداً من الميدان أشعث أغبر، وكنا نهمّ بالخروج، سألنا : ” ماشين وين؟ ” أجبنا : ” إلى المكتبة العامة.. في وزارة الإعلام. طلب منّا الإنتظار قليلاً وسيوصلنا بسيارته.. في الطريق حدثنا بإقتضاب عن أهمية ما نقوم به من قراءة للكتب، وبدا في ملامحه رضا وارتياح. وهنالك تجربة تكشف بجلاء مدى حرصه على نمو شخصياتنا كي نكون أشخاصاً مسؤولين- أتحدث هنا كإبن له رغم أنه كان صهري – وهو أنّ أخي الأصغر تمرد على الدراسة وذهب إلى حلفا الجديدة، حدث ذلك في غياب الشهيد إذ كان حينذاك في الميدان، ولم يمض يومان على ذهاب أخي حتى عاد، وكان في عجلة من أمره، وللتو عقد معنا إجتماعاً أنا وصلاح، في غرفة الجلوس.. بادر بالقول: ” أنتما الآن رجال، يُعتمد عليكما، ستسافران غداً إلى حلفا وتأتيان بعبد اللطيف – إسم أخي الأصغر – بأسرع وقت. سافرنا وأنجزنا المهمة بنجاح. وبعد أن حقق الشهيد مع أخي، عرف أنه لا يحب الدراسة الأكاديمية بل يميل إلى الأخرى الفنية، فألحقه بالمدرسة الصناعية بكسلا.
في تلك الأيام وأنا لم أكمل بعد عقدي الثاني، تنامت لديّ عادة القراءة بنهم وشغف، كنتُ أعود من المكتبة العامة، أتناول غدائي ثم أدخل غرفة الجلوس وبها مكتبة الشهيد، إذ كانت قيادات جبهة التحرير الإرترية تحرص على اقتناء المكتبات في منازلهم، في محاولة حثيثة ودؤوبة لتثقيف ذواتهم. كانت تلك مكتبة تتوفر على كتب غير موجودة بالمكتبة العامة، مثل كتب الفلسفة الماركسية وروايات من الأدب الروسي وكتب عن الاستخبارات العسكرية، مثل كتب سعيد الجزائري. بالنسبة لي كان ذلك كنز ضخم، كنت أقرأ كل ما تصل إليه يدي، لا أفرغ من كتاب إلا أدخل في آخر غيره. ولمّا عاد شقيق الشهيد الأكبر من القاهرة، وهو المناضل محمد نور هنقلا، محملاً بكتب ومجلدات ضخمة عن تاريخ الحروب الأهلية في أوروبا وتاريخ إفريقيا والعالم الإسلامي وأدب الرحلات وأدب المهجر، وكتب المستشرقين، حينها توقفت عن الذهاب الى المكتبة العامة، كذلك هجرتُ كرة القدم التي كانت تمارينها تضيع لي وقتاً كان من الممكن قضاءه بين تلك الفضاءات الرحيبة التي كانت تتيحها لي القراءة. ذات نهار، وكنت منهمكاً في قراءة ( المادية التاريخية) دخل الشهيد غرفة الجلوس وتوجه نحوي، قلّب صفحات الكتاب الذي كان بين يدي، وقرأ عنوانه، ثم بادرني بالسؤال : ” هل قرأتَ رأس المال؟ ” .. أجبته : ” كلاّ” ، قال لي: ” إذن عليك التوقف عن قراءة هذا الكتاب وأبدأ في قراءة رأس المال، أولاً. بعد سنوات قليلة وبعد تلك الخبرات التراكمية، وكان الشهيد قد صعد إلى بارئه، عرفتُ السبب وراء طلبه ذلك، وتعلمتُ من ذلك أهمية التسلسل الموضوعي في القراءة، في كل دروب المعرفة بلا استثناء. عموماً بعد فترة صارت كتب الفلسفة تصيبني بالملل وكنت أحياناً أحسها عصية على الفهم، فتوجهت إلى قراءة كتب الأدب، التي تعلمت منها الكثير وأثرت لاحقاً في تكويني الإبداعي ككاتب.حدث ذلك منذ زمن بعيد.. كنت حينها في سنتي الأولى في المرحلة المتوسطة، وكنتُ لم أنتقل بعد إلى كسلا لمواصلة تعليمي بها؛ وكنا في زيارة إلى أسرة الشهيد، في مناسبة عائلية، ولسوء حظي شهدتُ بأم عيني ملمحاً من ملامح النكسة، حين تآمرت الجبهة الشعبية مع (وياني تقراي) وحدث ذلك الحدث التاريخي، أي دخول جيش التحرير الإرتري إلى الأراضي السودانية مندحراً مهزوماً.. مع ساعات الصباح الأولى صحونا على صوت سيارة الشهيد نصف نقل، تويوتا دفع رباعي، كان على متنها الشهيد وثلة من المقاتلين ومقاتلتين إثنتين، إحداهما تدعى ألماز، وهي ممرضة كتيبة، والأخرى لا أذكر إسمها كانت تحمل جهاز لاسلكي في يدها اليمنى وبيسراها حقيبة عسكرية صغيرة الحجم، وكان يقود السيارة المناضل دنباي. كان الشهيد في قمة غضبه وإن ظل محتفظاً برباطة جأشه. المقاتلة التي بيدها اللاسلكي أمرها الشهيد بالإتصال بجهة ما، ولكن جهازها لم يلتقط أي إشارة، وعلى الفور أمرها الشهيد بالصعود إلى أعلى الحجرة، صعدت بنشاط لا يتناسب وحالتها التي كانت عليها من الإعياء والتعب الشديد. ذلك الحدث ما يزال عالقاً بذاكرتي رغم مرور أربعة عقود على حدوثه، رأيتُ كيف كان الغضب المكبوت يعتمل في دواخل أولئك المقاتلين كبركان في طريقه إلى الانفجار.
في المشرحة، وبعد كتابة التقرير، سُمح لي بعد إلحاح شديد حتى بُح صوتي بالدخول إليه.. جاء أيضاً المناضل القائد حامد محمود وطلب الدخول، لم يؤذن له في البداية، لكنه صرخ فيهم بحنق وغيظ فسمحوا له بالانضمام إليّ. كنتُ حتى تلك اللحظة غير مقتنع بأنّ رصاصات غادرة جبانة أطلقها إرهابي من مسدس كاتم للصوت، من شأنها أن تنزع الحياة عن ذاك الباسل الذي صال وجال في أنحاء البلاد مقاتلاً شرساً، مقداماً، يقود المعارك ويحرر المدن في سهول القاش بركة والساحل وسمهر ويشارك مع رفاقه في تحرير مندفرا ويحاصر العاصمة أسمرا بعزم وإرادة من حديد. جلستُ، أقعيتُ، وقفت على مقربة من ذلك الجسد المسجيّ داخل غلالة من جلال الموت، أحدّق إليه موتوراً بسيف الغدر، وفي سرّي أدعو الله أن يلهمنا بمعجزة تجعل تلك العينين المسبلتين في صمت مهيب، تنفضان عنهما ذاك السكون الثقيل الموحش، نظرتُ إلى جانب وجهه الأيسر حيث اخترقتهما تينك الرصاصتين الجبانتين، ولكنّ وجهه كان مضيئاً، فعرفتُ لماذا كان وجه تشي غيفارا بتلك النصاعة حين استشهاده.