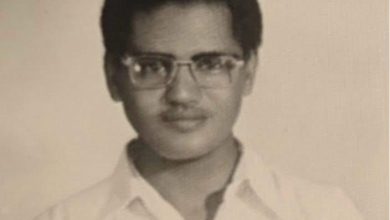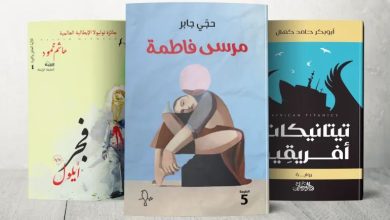فهم نظام الدولة الإرترية وجذور السيادة.
فهم نظام الدولة الإرترية وجذور السيادة مقال مقارن لبناء الثقة
بقلم/ الأستاذ بيان نجاش
ترجمة/ الأستاذ زين العابدين شوكاي
مقدمة:
تواجه إرتريا اليوم أزمة أعمق من مجرد أزمة حدودية أو سياسية، إنها أزمة ثقة. فما كان يومًا ما رابطًا هشًّا بين المناطق والأديان، أصبح اليوم أكثر هشاشة، ممزقًا ليس فقط بفعل سيطرة الدولة غير المنضبط بالقانون، بل أيضًا بفعل الإساءات اليومية بين جيل الشباب. فعلى منصات الـ”تيك توك” وغيرها من المنصات، يتبادل الشباب الإساءات باسم الدين، محولين الجروح التي تصيب كافة الإرتريين من قبل أجهزة الدولة إلى مادة لصراع طائفي. وما كان ينبغي أن يكون نضالًا مشتركًا بين الإرتريين من أجل استرداد كرامتهم، أصبح يُهددهم بالانحدار إلى تبادل الشكوك فيما بينهم.
في ظل هذه الخلفية، جاءت مقالة عبد الرازق كرار “محاولة لفهم طبيعة النظام في إرتريا” إلى الساحة الفكرية الإرترية، وبنى تحليله، في المقال المكتوب باللغة العربية، والذي أثار جدالًا واسع النطاق، بأن استهداف نظام الدولة الإرترية للمسلمين ينبع من قرار إسياس أفورقي المبكر لبناء مشروع مضاد متجذر في ثقافة المرتفعات الأرثوذكسية، وهو مشروع اختزل الدين إلى خادم للديكتاتورية. وبالنسبة لكرار، فإن نظام الإرتري ليس طائفيًّا في عقيدته، بل ديكتاتوريًّا بطبيعته، يستغل الرداء الطائفي.
ومع ذلك، هناك غيره من يقرأُ تاريخ إرتريا بشكل مختلف. وهؤلاء يجادلون بأن الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا، التي خرج عنها نظام الدولة الحالي، رفضًا للسردية الإقطاعية الإثيوبية الأكسومية وجاذبية الهوية الإقليمية للشرق الأوسط، صاغوا بدلاً من ذلك مشروع سيادة متجذر في تجربة إرتريا تحت الحكم الاستعماري الإيطالي والبريطاني. في هذا السياق، قاومت كلٌّ من الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا وجبهة التحرير الإرترية (مسلمين ومسيحيين) معًا الذوبان في الهويات الخارجية، وأسسوا، رغم كل الصعاب، دولةً ذات سيادة. ومهما كانت تصرفات النظام اللاحقة، فإن اللحظة التأسيسية للاستقلال كانت لحظة تضامن وليس الإقصاء.
لا تسعى هذه المقالة إلى استبعاد أيٍّ من القراءتين. بل على العكس من ذلك، تضع القراءتين جنبًا إلى جنب، غير متشاكستين بل متحاورتين. فمستقبل إرتريا يعتمد على إدراك الإرتريين واقع كلتا الحقيقتين، أكثر من اعتماده على أيهما “الأصح”، والحقيقتين هما المعاناة من القمع، والاعتزاز بتحقيق السيادة الوطنية بجهودهم المشتركة. وذلك يعني ضمنًا مقاومة الطائفية الرخيصة التي تُروج لها إساءات الـ “تيك توك”، واستعادة المهمة الأسمى والأكثر نبلًا، ألا وهي قضية بناء الثقة بين الإرتريين.
ملاحظة: يُستخدم مصطلح “نظام الدولة الإرترية-Eritrean State System ” هنا بدلًا من مصطلح “النظام الاريتري -Eritrean Regime” الأكثر شيوعًا. لقد أصبح هذا الأخير وصفًا فظًّا ومُفرَطًا في الاستخدام، ويُخفي أكثر مما يكشف. إن واقع إرتريا اليوم ليس مجرد سيطرة استبدادية، بل هو أيضًا جهاز دولة حافظ على السيادة، وعزز نفوذه في منطقة البحر الأحمر، ووُضِع في مقارنة مع جيران الذين يواجهون إما الانهيار أو الفوضى. ويُجسّد نظام الدولة الإرترية هذه المفارقة على نحو أفضل: هيكله قمعي ومرن في آن واحد، مُدمّر في الداخل، إلا أنه متماسك ظاهريًّا.
قراءة عبد الرازق كرار لنظام الدولة الإرترية:
تبدأ أطروحة كرار بجبهة التحرير الإرترية، فرغم أنها كانت ماركسية وعلمانية رسميًّا، إلا أن تركيبتها كانت ذات صبغة عربية-إسلامية بلا شك. واستمدت قوتها من المجتمعات المسلمة داخل إرتريا، كما تلقت الدعم من المنطقة العربية الإسلامية. وأدرك إسياس أفورقي، الشاب الطموح، مبكرًا أن صعوده في هذا الإطار ستتم عرقلته. إذ كانت قيادة جبهة التحرير الإرترية تتشكل من أغلبية مسلمة، وكان من السهل اعتبار أي تقدم يحصل عليه إسياس كما لو أنه كان منحة منها.
وفي هذا الإطار لم يكن الحل الذي اختاره التكيف، بل التمرد. ففي بيانه الصادر في سبعينيات القرن الماضي بعنوان “نحن وأهدافنا”، طرح إسياس ورفاقه مشروعًا مضادًّا، فإذا كانت جبهة التحرير الإرترية قد تم تعريفها بطابعها الماركسي والعلماني مع وجود عدد كبير من المسلمين الإرتريين فيها، فإن المشروع الجديدة لا بد وأن يكون مسيحيًّا أرثوذكسيًّا، ومرتكزًا على المرتفعات الإرترية. وبهذه الطريقة، أصبحا إرتريا ذات رؤيتين وطنيتين متنافستين، واحدة متجذرة في المحيط الإسلامي في المنخفضات الإرترية، والأخرى في المحيط المسيحي في المرتفعات.
ويرى كرار أن هذا يُفسر لماذا تحمّل المسلمون، منذ البداية، وطأة القمع. ولم تكن اعتقالات رجال الدين والعلماء، ومصادرة الأراضي، وإعادة توطين سكان المرتفعات في المناطق ذات الأغلبية المسلمة، وتهميش اللغة العربية، ومنع عودة اللاجئين، وليدة الصدفة، بل كانت مُدبَّرة. وسعى نظام الدولة الإرترية إلى شلّ القاعدة السابقة لجبهة التحرير الإرترية، لضمان عدم قدرة المسلمين على تشكيل قطب بديل للشرعية التي يمثلها النظام، مرة أخرى.
ومع ذلك، يُشدد كرار على أنه لا ينبغي الخلط بين النظام والثيوقراطية. فعلى عكس لبنان، حيث يُقرّ القادة الدينيون القرارات السياسية، أو العراق، حيث يُبارك رجال الدين السلطة، قلبت إرتريا هذا النموذج، وأصبح الدين في خدمة السياسة. والدليل الأوضح هو مصير البطريرك أنطونيوس، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية. فعندما قاوم تدخل الدولة، عُزل من منصبه عام 2006، واحتُجز حتى وفاته عام 2022، واستُبدل بشخصية أخرى مُطيعة. هكذا تم إخضاع الكنيسة الأرثوذكسية للديكتاتورية.
الدرس الذي يستخلصه كرار جليّ: إرتريا لا تحكمها عقيدة معينة بل الخوف، والقناع الطائفي حقيقي، لكن وراءه يكمن وجه الاستبداد. إن وصف النظام بالطائفي أمرٌ مرضٍ عاطفيًّا، لكنه مُضلِّلٌ سياسيًّا. وهنا تكمن خطورة تحويل المظالم السياسية إلى مظالم دينية، يستغلها النظام بعد ذلك لكسب ولاء قاعدته الأرثوذكسية. أما الحقيقة الأعمق فهي أن إرتريا يحكمها ديكتاتور، يتستر بالقناع الطائفي، إلا أن عقيدته الوحيدة هي البقاء في السلطة.
مكانة “نحنان علامانان” في أصول نظام الدولة:
أي محاولة لفهم أصول النظام الحالي يجب أن تأخذ في الاعتبار “نحنان علامانان” (نحن وأهدافنا)، وهو بيان صدر في سبعينيات القرن الماضي، وينسب إلى إسياس أفورقي وحاشيته. ويرى عبد الرازق كرار أن هذه الفكرة بمثابة نموذج أيديولوجي حاسم: ففي اللحظة التي انفصل فيها أسياس عن جبهة التحرير الإرترية، رسم مشروعًا مضادًّا أصبح لاحقًا جوهر الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا. ويرى كرار أن النص لا يشير فقط إلى تنظيم جديد، بل إلى هوية جديدة، هوية مهدت الطريق لتهميش المسلمين.
ومع ذلك، يتذكر العديد من المقاتلين المخضرمين هذه الوثيقة بشكل مختلف. فبالنسبة لهم، كانت “نحنان علامانان” وثيقة ظرفية، كُتبت عندما كان إسياس ورفاقه أقل عددًا وعتادًا، ولم يكن المقصود منها بيانًا فلسفيًّا بقدر ما كانت دعاية لتحفيز الطلاب الإرتريين في الخارج. وكان تأثيرها فوريًّا وعمليًّا. فقد أقنعت الإرتريين الذين كانوا يدرسون في الولايات المتحدة الأمريكية، وأماكن أخرى في العالم، بترك حياتهم المريحة ووظائفهم الواعدة للانضمام إلى النضال التحرري. وبهذا المعنى، كان محورها الحقيقي هو التجنيد، وليس التعبئة الطائفية.
كما أن الواقع الديموغرافي الأوسع مهم أيضًا. فبحلول أواخر سبعينيات القرن الماضي، ومع انسحاب جبهة التحرير الإرترية إلى القرب من كسلا، كان المقاتلون من ابناء المرتفعات المسيحيين يُشكلون ما يُقدر بثلثي مقاتلي الجبهة. ولم ينشأ هذا التحول في التوازن ببيان، بل نتج عن تطورات الحرب (الإرترية الإثيوبية) نفسها، حيث انضم الإرتريون من مختلف المناطق والخلفيات بالثورة.
في ضوء ذلك، لا تكمن أهمية بيان “نحنان علامانان” في إعلاء مكانة مجتمع ما على حساب الآخر، بل في رفضها للإقطاع الإثيوبي وتقديم بديل إرتري بامتياز، والذي منح التماسك لحركة الثورة التي كانت منقسمة على نفسها، وساعد في استدامة التجنيد في مرحلة حرجة. وسواءً قُرئ النص كمخطط للدعاية أو الاستقطاب، فإنه يظل مرآةً للتوترات التي كانت ولا تزال تُلاحق الإرتريين، وهو التجاذب بين الهوية والوجود من جهة، والأيديولوجيا والضرورة من جهة أخرى.
دحض السيادة – واستبدالها بمفهوم الدولة :
لا يتفق الجميع مع تفسير كرار، إذ تُعارضه بعض الأصوات الإرترية التي تؤكد على أن الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا (EPLF)، التي نتج عنها نظام الدولة الحالي، كانت في جوهرها تُركّز على الاستقلال لا على الطائفية. ولم يكن إنجازها تهميش المسلمين، بل رفض استقطاب عاملين خارجيين قويين.
العامل الأول: هو ادعاء إثيوبيا الاستعماري، المتجذر في أساطير أكسوم والملكية الإقطاعية التي صوّرت لعقود وكأن إرتريا هي جزء من محيطها الحضاري. رفضت الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا هذه الرواية، مُستندةً في تاريخها الاستعماري الحديث، حيث رسم الاستعمار الإيطالي، ثم البريطاني، حدودًا وشكّلا كيانًا متميزًا لا يمكن ببساطة إعادة دمجه في إثيوبيا.
العامل الثاني: هو جاذبية الهوية الإقليمية العربية الإسلامية. وجادل البعض بأن إرتريا، بأغلبيتها المسلمة في أراضي المنخفضات والأغلبية المسيحية في المرتفعات، وروابطهما الثقافية عبر البحر الأحمر، لا ينبغي دمجها في العالم العربي الأوسع. وقاومت الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا وجبهة التحرير الإرترية هذا أيضًا، مُصرّتين على أن هوية إرتريا ليست إثيوبية ولا عربية، بل هي إرترية بامتياز.
ومن خلال هذين الرفضين، صاغت الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا هوية مدنية. حيث قاتل المسلمون والمسيحيون جنبًا إلى جنب، ليس لمحو الخلاف الطائفي، بل لأن كلا الطرفين رأى استمرارية وجوده في الاستقلال. لذا، شرعية السيادة الإرترية لم تأت من الإقصاء الطائفي، بل من التضحيات المشتركة.
ووفقًا لهذا المنظور، لا يمكن تفسير نظام الدولة الإرترية الحالي على أنه استمرار منطقي لمشروع طائفي. بل يجب النظر إليه على أنه تشويه مأساوي لمشروع السيادة. لقد استهلك نظام الدولة الإرترية ما بُني يومًا ما من خلال الروح الرفاقية. والمشكلة ليست في أن الاستقلال كان إنجازًا طائفيًّا في أصله، بل أن مفهوم السيادة قد أُفرغ من محتواه بعد أن تحقق الانتصار.
اختلافات في قراءة نظام الدولة الإرترية
يختلف المنظوران في نقاط رئيسية:
- حول الأصول: يرى كرار أن تهميش المسلمين جوهري، بينما يرى المدافعون عن السيادة أن السيادة المشتركة هي الأساس.
- حول الشرعية: يُشدد كرار على مشروع إسياس المُضاد، وتُشدد أصوات أخرى على تاريخ إرتريا كمستعمرة، ونضال شعبها المُشترك.
- حول تفسير القمع: يُفسر كرار استهداف المسلمين على أنه هيكلي، بينما تفسر أصوات أخرى القمع على أنه نظام دولة يستهدف جميع الفئات.
وكل رأي من هذه الآراء له مخاطره، إن الإطار الذي وضعه كرار، إن لم يكن مُقيّدًا/مشروطًا، يُمكن أن يُعمّق الشكوك الطائفية. أما الإطار الذي وضعه دعاة السيادة، إن لم يكن نقديًّا، فقد يُغفل المعاناة المتفاوتة التي تتعرض لها جميع الفئات الإرترية.
التقاربات: ما يكشفه نظام الدولة
ومع ذلك، تتفق كلتا النظرتين على الحقائق الجوهرية التالية:
- من يحكم إرتريا اليوم هو نظام دولة، وليس نظامًا عقائديًّا.
- لقد عانت جميع المجتمعات الإرترية، حتى وإن كان ذلك بشكل غير مُتكافئ.
- الوحدة لا غنى عنها لمواجهة أي نظام دولة يضطهد ويقمع الجميع.
ولا يدور الخلاف حول ما إذا كان الإرتريون يتعرضون للقمع والاضطهاد، بل في كيفية سرد ماضيهم وتشخيص حاضرهم. ويشكل هذا التقارب أساسًا ممكنًا لإعادة بناء الثقة.
نحو بناء الثقة داخل نظام الدولة الإرتري:
إذا أردنا إعادة بناء الثقة، يجب على الإرتريين أن يتعلموا التمسك بكلتا الحقيقتين. يجب احترام رواية القمع والقهر، إذ لم يسلم أي مجتمع من وطأتها. واجه المسلمون والمسيحيون، وسكان المرتفعات والمنخفضات، الأقليات والأغلبيات على حد سواء، مصادرة الأراضي والتجنيد الإجباري والسجن والنفي وتكميم الأفواه. وفي الوقت نفسه، يجب ترسيخ رواية السيادة المشتركة، لأن الإرتريين من جميع الخلفيات قاوموا إثيوبيا معًا من أجل إقامة دولة مستقلة.
وتولد الثقة عندما يدرك الإرتريون كلتا هاتين الحقيقتين. تكمن الوحدة في إدراك أن الجميع دفعوا ثمن الاستقلال، وأن الجميع يعانون في ظل نظام الدولة القائم. إن الاعتراف بهذا لا يعني محو الاختلافات، بل هو نبذ للشكوك والتوجه نحو المهمة الأصعب، والمتمثلة في إعادة بناء الثقة بين الأديان والمناطق والأجيال.
كما تقاوم هذه التوليفة الخطاب السام المتفشي الآن بين الشباب. وعلى الـ”تيك توك”، تنتشر الإساءات بناءً على أنصاف الحقائق: مثل “أنتم المسلمون المشكلة” أو “أنتم المسيحيون المشكلة”. كلا الطرحين يمحوان تعقيد التاريخ، ويختزلان مأساة وطنية مشتركة إلى مجرد توصيفات طائفية. وفي المقابل، تُزود القراءة المقارنة التي قام بها كرار ومنتقديه بمفردات أكثر صدقًا، مفردات تُقر بالإقصاء والتضامن، والانكسارات والانتصارات، وتُشير إلى العدو المشترك، وهو نظام الدولة الإرتري نفسه.
الخلاصة – مستقبل نظام الدولة الإرتري:
التحليل المقارن للأزمة الإرترية لا يحلها، إلا أنه يُلقي الضوء على أبرز معالمها. ويُذكِّرنا كرار بأن الاستبداد في إرتريا بُني على تهميش القاعدة المسلمة، والتدثر برداء الطائفية. بينما تُذكِّرنا الأصوات الأخرى بأن السيادة تحققت من خلال التضامن الإسلامي والمسيحي، وأنها راسخة في الواقع الذي عاشه الإرتريون معًا إبان الحقبة الاستعمارية الإيطالية والبريطانية. تكشف هذه الحقائق مجتمعةً أن مأزق إريتريا الحالي ليس طائفيًا بحتًا ولا مدنيًّا بحتًا، بل هو حطام مشروع السيادة الذي أزهقه نظام الدولة الإرترية.
فالمهمة الآن ليست الخوض في المناقشات القديمة مجددًا أو إعادة تدويرها، بل استخدامها كمرآة عاكسة. ويجب على الإرتريين أن يروا في رواية كرار ألم الإقصاء، وفي دحض دعاة السيادة الاعتزاز بالاستقلال. وستنمو الثقة عندما يحتضن كلاهما الآخر كجزء من رواية واحدة.
ولا يمكن لإرتريا أن تسمح لشبابها بأن يرثوا الشك فحسب، بل يجب أن يكون الهدف البعيد المدى بناء الثقة. ثقة تُقر بالجروح، وتُؤكد على الاعتزاز، وتقوي وحدتنا في وجه أي نظام دولة يضطهد ويقمع. ثقة ترفض التفرقة الطائفية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتستعيد بدلًا من ذلك المهمة الأصعب وهي المصالحة الوطنية. ثقة تُذكِّرنا بأن إرتريا لم تولد من الانقسامات، بل من الروح الرفاقية، وأن تجديد هذه الروح يعتمد على النضال المشترك.
النص باللغة الإنجليزية