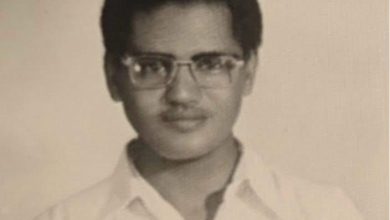لعبة القرن.. كيف خططت الإمارات وواشنطن لقتل جيبوتي؟ بقلم /محمد السعيد

7-Sep-2018
عدوليس ـنقلا عن الجزيرة نت
ليس من الشائع أن يخلع وزراء الخارجية على وجه الخصوص أقنعة الدبلوماسية الوقورة حتى في جلساتهم المغلقة، ولكن وزير خارجية جيبوتي “محمود علي يوسف” قرر أن يخلع رداء الدبلوماسية كاملا في رسالته المكونة من ست صفحات والتي وجهها لسفرائه الشهر الماضي على خلفية التقارب المفاجئ بين الجارين اللدودين لبلاده، إثيوبيا وإريتريا.منذ اللحظة الأولى، كان من الواضح أن جيبوتي الصغيرة -ولأسباب متفهمة تماما- تشعر بقلق غير مسبوق من ذلك التقارب غير المنتظر، لذا فإن وزير خارجيتها اختار التعبير عن قلق حكومته بعبارات مباشرة تماما ودون أدنى قدر من المواربات الدبلوماسية المعتادة، واصفا(1) في رسالته رئيس وزراء إثيوبيا الجديد “أبي أحمد” بأنه شخص “متسرع وطائش”، وأنه يستخدم وضع بلاده كعضو غير دائم في مجلس الأمن لضمان رفع العقوبات عن إريتريا، دون التفكير في التأثير المحتمل لمثل تلك الخطوة على جيبوتي، الشريك الأهم لإثيوبيا على مدار أكثر من عقدين فائتين.
وزير خارجية جيبوتي “محمود علي يوسف” (يمين) ورئيس وزراء إثيوبيا الجديد “أبي أحمد” (الجزيرة).
لطالما عُرفت إريتريا في الأوساط الدبلوماسية على أنها كوريا الشمالية الخاصة بأفريقيا، وهي بلد كان يمكن نعته(2) حتى وقت قريب بأنه عدو الجميع بلا جدال، فبخلاف الصراع طويل الأمد الذي خاضته مع إثيوبيا قبيل وبعيد استقلالها عنها مطلع التسعينيات، تاركة جارتها الكبيرة كدولة حبيسة بلا أي منافذ على البحر، بخلاف ذلك فقد انخرطت إريتريا مطلع العقد الحالي في نزاع حدودي مع جارتها الصغيرة، جيبوتي، أيضا بعدما قامت القوات الإريترية بنشر قواتها في مثلث دميرة إلى داخل الحدود الجيبوتية، مما أدى إلى نشوب معارك محدودة وأزمة لم يتم حلها إلا مع تدخل الدوحة للوساطة بين البلدين، وإبرام اتفاق للمصالحة تضمن نشر قوات قطرية على الحدود بينهما، ومنذ ذلك الحين وفرت إريتريا الملاذ والدعم لمعارضي الحكومة في جيبوتي وأبرزهم فصيل مسلح معارض يُعرف باسم “جيش الخوف”.
وعلى قاعدة ذلك العداء المشترك مع إريتريا، وعلى الرغم من المشاكل التاريخية الكامنة بينهما أيضا، دفع موقف إثيوبيا الجيوسياسي المهتز بعد انفصال إريتريا، دفعها للارتماء في أحضان جارتها الصغيرة، مبرمة بروتوكولا(3) للتعاون العسكري مع جيبوتي عام 1999، ومنذ ذلك الحين أصبحت الجارة الصغيرة منفذ إثيوبيا الوحيد إلى البحر، حيث اعتمدت أديس أبابا على ميناء جيبوتي في التعامل مع حصة تبلغ 95% من واردتها، بينما اعتمدت جيبوتي على جارتها الأكبر في الحصول على المياه العذبة والكهرباء.
ظلت علاقة الاعتماد المتبادل صامدة على مدار عقدين من الزمان، تغذيها حقائق الجغرافيا ووقائع السياسة وفي القلب منها العلاقات المضطربة لأديس أبابا مع إريتريا والصومال، وهو اضطراب عزز موقع جيبوتي كمتنفس وحيد لإثيوبيا على البحر، قبل أن يغير صعود “أبي أحمد”، وجهوده للتصالح مع إريتريا والصومال، من تلك الدينامية المستقرة، تغييرا قلب موازين الأمور رأسا على عقب، وهو تحول لا ترى جيبوتي أن “أبي أحمد” يقوده بمفرده، ولكنها ترى أن قوة إقليمية تقف وراءه ساعية لإعادة تشكيل التحالفات في منطقة القرن الأفريقي بما يلائم مصالحها، قوة هي دولة “الإمارات العربية المتحدة”.
من أجل ذلك، كان للإمارات نصيبها من السخط أيضا في رسالة وزير خارجية جيبوتي التي كسرت كل قواعد الدبلوماسية الرصينة، حيث حرص الوزير على التصريح بقلقه حول تدخل الإمارات لإعادة تشكيل المنطقة، واصفا الدولة الخليجية بأنها الجناح العسكري والمالي لإستراتيجية الإدارة الأميركية الجديدة، ومشيرا إلى تعهد ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” بتقديم مليارات الدولارات من الودائع لإثيوبيا مقابل تمديدها لجذور صداقة غير مألوفة مع إريتريا، في صفقة ترى جيبوتي أن الإمارات قامت بهندستها في المقام الأول ليس لتعزيز مصالحها البحتة فحسب، ولكن لإظهار قدرتها على الانتقام والنكاية في مواجهة جيبوتي بفعل الخلاف المحتدم بين البلدين منذ عام 2015 حول ملفات عدة أهمها الدور الإماراتي المثير للجدل في إدارة ميناء جيبوتي الحيوي.
صعود وأفول جيبوتي :
مع كونها دولة خالية من الأنهار التي يمكن أن تدعم الزراعة، وفقيرة في الوقت نفسه في جميع المعادن القابلة للاستخراج، لا تنتج(4) جيبوتي شيئا يُذكر يمكن أن يضعها على خارطة الاقتصاد والتجارة العالمية، لذا فإن موقع البلاد الحيوي كان دائما أثمن مورد لها مع امتلاكها مفاتيح البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وقناة السويس، وهي واحدة من أهم ممرات الشحن في العالم.
في الوقت نفسه، انتخبت الجغرافيا جيبوتي الصغيرة لموقع مميز قرب مضيق باب المندب الذي يتحكم في قرابة 8-10% من تجارة النفط العالمية، وهناك أكثر من 20 ألف سفينة على الأقل تمر عبر ميناء جيبوتي سنويا، وعلى الرغم من وجود العديد من الموانئ المنافسة في المنطقة: في السودان، وأرض الصومال، وإريتريا، فإن استثمار جيبوتي في تشييد مرافق متقدمة والاستقرار السياسي النسبي الذي تتمتع به البلاد جعلاها أكثر جاذبية من الناحية الاستثمارية مقارنة بمنافسيها في جميع أنحاء المنطقة.
رئيس جيبوتي “إسماعيل غيلة” (رويترز)
وبخلاف ذلك، فإن جيبوتي وحكومتها التي يقودها الرئيس “إسماعيل عمر غيلة” منذ أكثر من عقدين من الزمان فطنت منذ وقت بعيد إلى حجم الفوائد التي يمكن أن يجلبها الموقع الجغرافي المتميز، وهي فوائد ليست لاقتصاد البلاد فحسب ولكن لبقاء النظام السياسي الذي يسيطر سيطرة صارمة عليها، لذا قرر “غيلة” منذ وقت مبكر أن يفتح بلده الصغير أمام الوجود العسكري الأجنبي مقابل المال والحماية، محولا بلده إلى ملتقى عسكري لجيوش الشرق والغرب الراغبة في دفع المال مقابل امتلاك منشآت وقواعد عسكرية، ابتداء من المحتل السابق لجيبوتي “فرنسا”، التي تملك قاعدة تحمل اسم “فورس فرانسيس جيبوتي” وهي أهم قواعد فرنسا في القارة السمراء، جالبة فوائد ملحوظة على اقتصاد جيبوتي المحلي في صورة إيجارات ومساعدات ومصروفات تشغيلية مختلفة.
ويبدو أن إغراء القوة والمال دفعا “غيلة” إلى عدم الاكتفاء بالوجود العسكري الفرنسي، مستغلا حاجة الولايات المتحدة إلى فرض وجود عسكري في أفريقيا إبان الحرب على العراق، ليعرض(5) استضافة القوات الأميركية في معسكر “ليمونيه” قرب مطار جيبوتي الدولي، حيث تم نشر 900 جندي أميركي في القاعدة عام 2002 قبل أن يرتفع الوجود الأميركي في القاعدة تدريجيا وصولا إلى 4500 جندي، لتستضيف القاعدة في نهاية المطاف مقر القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا المعروفة باسم “أفريكوم”، فضلا عن مهامها في مراقبة المجالات الجوية والبحرية لعدة دول أفريقية أهمها الصومال والسودان وكينيا واليمن وإريتريا وجيبوتي نفسها.
ويبدو أن لعبة استضافة الجيوش واصلت إغراء “غيلة” الذي شرع عام 2009 في استضافة قاعدة للبحرية اليابانية تضم نحو 400 جندي إضافة إلى قاعدة أخرى للجيش الإيطالي، وهما جيشان نادرا ما يمتلكان اليوم وجودا عسكريا خارج حدودهما، كما اتفق مع المملكة العربية السعودية على استضافة قاعدة أخرى لها، كان من المقرر أن تكون هي الأخرى أول قاعدة عسكرية للدولة الخليجية خارج حدودها.
كان تحويل أراضي البلاد إلى مسرح للارتزاق من جيوش العالم لعبة صممها نظام “غيلة” بعناية لإيجاد توازن دقيق بين العديد من الرعاة الأمنيين المحتملين، وبخلاف لعبة التوازن الكامنة خلف الإيجارات العسكرية المتنوعة، فإن المكاسب المالية التي تجنيها السلطات الجيبوتية مقابل إيجار القواعد الأجنبية الرئيسة لم تكن هينة أيضا وتقدر بمئات الملايين من الدولارات، حيث تدفع الحكومة الفرنسية نحو 30 مليون دولار سنويا مقابل قاعدتها العسكرية هناك، أما قيمة إيجار القاعدة العسكرية اليابانية فيُقدّر بنحو 33 مليون دولار أميركي سنويا، في حين تدفع الولايات المتحدة 63 مليون دولار مقابل قاعدتها، فضلا عن الفوائد الاقتصادية الأخرى لتشغيل هذه القواعد واستضافة الجنود وحركة الطيران والموانئ التي تبلغ أضعاف ذلك الرقم.
ولكن في عام 2015، بدا أن لعبة “غيلة” بدأت تثير غضب رعاته الغربيين وفي مقدمتهم واشنطن، مع ميله لاستخراج الإيجارات المكلفة من أكبر عدد ممكن من الجيوش الأجنبية بغض النظر عن المصالح العسكرية المتضاربة لهذه القوى، وكانت خطوته الأكثر إثارة للجدل هي السماح بقاعدة عسكرية للصينيين على بُعد كيلومترات فقط من القاعدة الأميركية، تم افتتاحها في أغسطس/آب من العام الماضي، قاعدة عسكرية رأتها واشنطن تتويجا لطموحات التوسع العسكري الصيني في آسيا وأفريقيا من ناحية، وللعلاقة المتنامية بين بكين وجيبوتي من ناحية أخرى، حيث تمول(6) الصين مشاريع إنمائية بقيمة 14 مليار دولار في البلاد لتطوير شبكات الطرق، وتحسين الموانئ والمطارات الجيبوتية التي تشهد ازدحاما كبيرا بسبب النزاع في البلدان الساحلية بالمنطقة مثل اليمن والصومال، فضلا عن بناء 6 موانئ جديدة بخلاف الموانئ الجيبوتية الفاعلة في الوقت الراهن.
ومع مرور الوقت، كان القلق في واشنطن يتنامى من الوتيرة السريعة التي يتطور بها النفوذ الاقتصادي للصين في القارة السمراء متحولا إلى وجود عسكري، وفي جيبوتي على وجه الخصوص، كانت واشنطن تشعر بالقلق من أن يؤثر وجود القاعدة الصينية على بُعد 6 أميال فقط من القاعدة العسكرية الأميركية على مصالح الولايات المتحدة الأمنية بما في ذلك عملياتها السرية في الصومال واليمن، خاصة مع سقوط حكومة جيبوتي في فخ الديون(7) الصينية، ووصول الدين العام إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو دين تمتلك الصين حصة الأسد منه ويمنحها رافعة على القرارات الاقتصادية والسياسية لنظام “غيلة”.
وفي الواقع، يبدو أن جيبوتي نجحت في إثارة مخاوف واشنطن في وقت مبكر حين طلبت الحكومة، في أغسطس/آب 2015، من الولايات المتحدة إخلاء الميناء والمرافق التي تسيطر عليها في مدينة أوبوك الساحلية، بعد أن استثمرت الولايات المتحدة قرابة 14 مليون دولار لترقية رصيف الميناء في عام 2009، وجاءت مطالبة الحكومة الجيبوتية بالانسحاب الأميركي من أجل منح الميناء للجيش الصيني الذي بدأ في تشييد منشآت هناك منذ عام 2006، فضلا عن توقيع اتفاقية تسمح للصين باستخدام الميناء حتى عام 2026.
كانت مناورة جيبوتي المفتوحة مع الصين هي الأخرى أشبه بمغامرة محسوبة من الرئيس غيلة، من بدا راغبا على السطح في التحرر من الاعتماد على الولايات المتحدة والغرب، أو على الأقل اكتساب هامش مناورة مع قوة لا تهتم بالطنطنات التقليدية للغربيين حول قضايا حقوق الإنسان، لكن مغامرات “غيلة” يبدو أنها جاوزت الحد المسموح به إلى درجة أن واشنطن حاولت استخدام نفوذها الدبلوماسي لمنع انتخاب “غيلة” لفترة رابعة في انتخابات عام 2016، في محاولة لتصعيد زعيم لجيبوتي أكثر معقولية وتوافقا مع المصالح الأميركية.
ولكن “غيلة” ربح الانتخابات في نهاية المطاف، وبالطريقة المعتادة ذاتها، ليضع العلاقات بين بلاده والغرب على مفترق طرق، وللمفارقة فإن هذا الاضطراب في العلاقات بين واشنطن وبين البلد الصغير المطل على مضيق باب المندب جاء متزامنا مع التدخل السعودي الإماراتي في اليمن مطلع عام 2015، والذي جلب في نهاية المطاف دول الخليج بكامل عتادها إلى ساحة المنافسة في القرن الأفريقي.
كانت الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص مبادرة في الالتحاق بسباق الهيمنة على البحر، فبعد أن رسخت وجودها العسكري في عدن وموانئ اليمن، سعت أبو ظبي لعسكرة الأنشطة الاقتصادية لشركة “موانئ دبي” في القرن الأفريقي، وأهمها محطة حاويات “ديواليه” الجيبوتية التي تمتلك موانئ دبي حصة تقدر بـ33% فيها، إضافة إلى عقد طويل الأمد لتشغيل المحطة لمدة 50 عاما تم توقيعه عام 2006.
ومع بدء الغزو السعودي الإماراتي لليمن، قدمت(8) الإمارات طلبا لجيبوتي لإنشاء قاعدة عسكرية لمتابعة الأوضاع في عدن، طلب قوبل بالرفض في جيبوتي التي اكتفت بمنح القوات السعودية والإماراتية حق استخدام منشأة عسكرية صغيرة في منطقة هاراموس بالقرب من معسكر ليمونيه الذي تشغله القوات الأميركية، ولكن هذا لم يكن كافيا لتلبية طموحات الإمارات التي اخترقت طائراتها العسكرية تصاريح الهبوط في المطارات الجيبوتية أكثر من مرة، مما أدى إلى نشوب مشادات دبلوماسية وصلت حد الاشتباك بالأيدي بين قائد القوات الجيبوتية وبين نائب القنصل الإماراتي في جيبوتي في إحدى المناسبات.
وردا على ذلك سعت الإمارات لمعاقبة جيبوتي عبر تأجير الموانئ المنافسة لها وتقديم عروض مخفضة لاستخدامها، بما في ذلك عرض قدمته الإمارات لإثيوبيا لاستخدام ميناء في أرض الصومال برسوم مخفضة جدا، ما أدى إلى اتساع هوة الخلاف حول نزاهة تشغيل شركة “موانئ دبي” لمحطة الحاويات الرئيسة في جيبوتي، خاصة مع اتهام “غيلة” للإمارات بتسهيل الصفقة عبر الرشاوى المالية لمسؤول حكومي سابق يُدعى “عبد الرحمن بوري”، وهو معارض لنظام “غيلة” الحالي ومقيم في الإمارات، ونتيجة لذلك تفجرت الأزمات الكامنة في العلاقات بين جيبوتي والإمارات حول ميناء الحاويات، وتصاعدت تدريجيا لتصل ذروتها مع قيام جيبوتي بإعادة السيطرة على المحطة من “موانئ دبي” العالمية في فبراير/شباط الماضي.
إعادة التأهيل :
في الوقت الذي بدا فيه أن العلاقات بين جيبوتي والإمارات في طريقها للانحدار، كانت أبوظبي تبحث عن موطئ قدم بديل لممارسة الهيمنة في القرن الأفريقي، وفي توجه لم يخل من النكاية في دوافعه الأولى اختارت الإمارات التوجه إلى إريتريا، خصم جيبوتي التاريخي، وكانت البداية عام 2015 بعقد أبرمته موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء عصب البدائي على البحر الأحمر، قبل أن تشرع الإمارات على مدار الأشهر التالية في تثبيت بنية تحتية عسكرية مؤسسة أول قاعدة عسكرية خارج حدودها حول الميناء، قاعدة تشمل أصولا جوية مجهزة لنشر سرب كامل من طائرات “ميراج 2000” الفرنسية الصنع، أو طائرات “سي-17″ و”سي-130” التابعة لسلاح الجو الإماراتي، إضافة إلى وحدة أرضية كبيرة بحجم كتيبة مدرعة مجهزة بدبابات “ليكريك” الفرنسية، فضلا عن منشآت تدريب للمليشيات التي توظفها الإمارات في اليمن وغيرها.
وفي العاصمة أسمرة، تولت الإمارات مهمة تطوير المطار المتهالك ليصبح قادرا على استقبال مروحيات هجومية من طراز “أباتشي” تابعة لـ “قيادة الطيران المشتركة الإماراتية”، بالإضافة إلى مروحيات “تشينوك” و”بلاك هوك” المملوكة للحرس الرئاسي الإماراتي، وبالفعل قامت هذه الطائرات بتنفيذ طلعات هجومية فوق “مضيق باب المندب” انطلاقا من “عصب”، وجرى تدريب الطيارين الجدد في سلاح الجو اليمني في “عصب” أيضا، قبل نقلهم إلى قاعدة “العند” الجوية في عدن، والخاضعة بدورها للسيطرة الإماراتية، كما قامت إريتريا بإرسال 400 من جنودها لدعم القوات الإماراتية في عدن، وفي المقابل ساعدت الإمارات والسعودية في تحديث شبكة الكهرباء في إريتريا، وقدمتا مساعدات نفطية ومالية، ولكن رؤية الإمارات لم تكن تقتصر على استخدام إريتريا كقاعدة للعمليات العسكرية في اليمن، ولكنها هدفت في المقام الأول إلى إعادة تأهيل أحد أكثر الأنظمة انعزالا حول العالم وتحويله إلى قبلة للقوى الطامحة في المنطقة، وكان مفتاح ذلك التأهيل قابعا ببساطة في إثيوبيا المجاورة.
خلال الحرب الباردة وعبر التسعينيات، كانت علاقات إثيوبيا سيئة مع دول الخليج، حيث اعتقد(9) القادة الأحباش أن هذه الدول دعمت بشكل مستمر مصر وإريتريا والسودان والصومال ضدهم، ونتيجة لذلك، كان من الطبيعي أن تولد علاقة إريتريا الناشئة مع أبوظبي رد فعل مخيفا في أديس أبابا دافعة المسؤولين الإثيوبيين للتوجه إلى العاصمة الإماراتية لإجراء محادثات، ورغم أن الحوارات الأولى بين الجانبين بدت جامدة بشكل واضح، فإنه سرعان ما توصلت أبوظبي وحكومة ديسالين إلى طريقة للعمل بعدما تعهدت الإمارات بعدم تشجيع أي جهود من إريتريا أو حتى من القاهرة لتقويض أديس أبابا، بما في ذلك عدم الانحياز بشكل كامل إلى مصر بخصوص ملف سد النهضة الإثيوبي الكبير وحصص مياه النيل.
شيئا فشيئا، نما التعاون بين البلدين ليصبح أكثر إستراتيجية، حيث دخلا في شراكة لتطوير ميناء بربرة في أرض الصومال، ووقعت إثيوبيا اتفاقية مع إقليم “صوماليلاند” في فبراير/شباط عام 2015 لتطوير ميناء بربرة، قبل شهر من بدء شركة تابعة لشركة موانئ دبي العالمية مناقشات مع الحكومة في هرغيسا انتهت بتوقيع اتفاقية بقيمة 442 مليون دولار لتطوير الميناء عام 2016، وبعد عام آخر، حصلت إثيوبيا على 19% من الميناء، ووافقت على إنفاق 80 مليون دولار لتطوير البنية التحتية اللازمة لربط البلاد مع الميناء.
كان استثمار الإمارات في بربرة بادئ الأمر يهدف(10) أكثر ما يهدف إلى منح أبوظبي موقعا يسمح لها بالسيطرة على توريد السلع والخدمات للسوق الإثيوبية بخلاف جيبوتي، وهو هدف داعب طموحات إستراتيجية طويلة الأمد لدى أديس أبابا التي كانت تشعر بالقلق من عواقب اعتمادها الحصري في تجارتها على جيبوتي، وفي الوقت نفسه بدا ملائما بشدة لرغبة الإمارات في معاقبة جيبوتي بسبب الخلاف حول محطة الحاويات وطرد القوات الإماراتية في جيبوتي عام 2015، غير أن منافع الاتفاق لم تقتصر على ذلك فحسب، فمع مرور الوقت كان التفاهم بين أبوظبي وإثيوبيا حول التعامل مع إريتريا يتنامى(11) بشكل ملحوظ، حيث دعمت أديس أبابا جهود أبوظبي لتشييد قاعدة بحرية في بربرة من أجل تخفيف أهمية قاعدة “عصب”، قبل أن تغير إثيوبيا نظرتها إلى الوجود الإماراتي في عصب بشكل ملحوظ خاصة مع تطور علاقتها بأبوظبي، حيث رأت إثيوبيا أن شغل الإمارات للقواعد العسكرية يمنع -في أدنى الأحوال- من احتمالية قيام إريتريا بتأجيرها إلى مصر.
ومع صعود “أبي أحمد” إلى السلطة في مارس/آذار الماضي، أخذت العلاقات بين أبوظبي وأديس أبابا قفزة جديدة(12) وبخاصة مع الأجندة التصالحية التي حملها رئيس الوزراء الجديد، وفي القلب منها تصفير المشاكل مع خصوم بلاده التاريخيين وعلى رأسهم إريتريا، ففي 15 يونيو/حزيران، وبعد 10 أيام فقط من إعلان “أبي أحمد” أن إثيوبيا ستفي باتفاق الجزائر الذي تم توقيعه عام 2002 وأنها ستقبل السيادة الإريترية على قرية بادمي، زار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أديس أبابا للقاء أبي، حيث أعلن البلدان أن الإمارات ستضخ مليار دولار في النظام المصرفي لجلب الاستقرار إلى احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، ناهيك بتقديم ملياري دولار من المساعدات الإضافية لدعم الاقتصاد الإثيوبي.
وفي أعقاب رحلة ابن زايد الإثيوبية، سافر وفد إريتري إلى أديس أبابا لإجراء محادثات مستقلا طائرة مملوكة لشركة طيران الإمارات، وبعد ذلك بأيام فقط زار الرئيس الإريتري “أسياس أفورقي” أبو ظبي حيث التقى بابن زايد الذي تعهد باستثمارات كبرى في الزراعة والبنية التحتية في إريتريا، ليتم تتويج الجولات المكوكية في نهاية المطاف في 9 يوليو/تموز بمشهد احتضان أبي أحمد وأسياس أفورقي في أسمرة معلنين الوصول إلى اتفاق سلام تاريخي، برعاية إماراتية.
لعبة القرن :
في أبريل/نيسان، كان ياماموتو قد اختتم للتو زيارة إلى إريتريا، وهي أول زيارة لمسؤول أميركي إلى أسمرة منذ سنوات، حيثث أعلن خلالها استعداد بلاده للتوسط مع إثيوبيا.
الأوروبية:
ومع الدور الكبير الذي لعبته أبوظبي في المصالحة بين إثيوبيا وإريتريا، فإنه مما يجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن جدول أعمال المصالحة تلك، أو ما يمكن أن نُطلق(13) عليه مجازا خطة إعادة تأهيل إريتريا، كانت أجندة أميركية(14) في المقام الأول، ففي الوقت الذي كانت أبوظبي تقوم فيه بهندسة جولات المصالحة في أفريقيا، كانت جولات أخرى موازية لا تقل أهمية تدور رحاها في مكاتب وزارة الخارجية في واشنطن، بحضور وزير الشؤون الخارجية الإريتري “عثمان صالح” ومستشار الرئيس “أفورقي” المقرب “يمان غبريب”، إضافة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي السابق “هيلياريام ديسالين”، وذلك بقيادة مسؤول الشؤون الخارجية في وزارة الخارجية الأميركية آنذاك “دونالد ياماموتو”.
قبل أسابيع من المحادثات التي قادها في واشنطن، وتحديدا في أبريل/نيسان، كان ياماموتو قد اختتم(15) للتو زيارة إلى إريتريا، وهي أول زيارة لمسؤول أميركي إلى أسمرة منذ سنوات، حيث أعلن خلالها استعداد بلاده للتوسط مع إثيوبيا، وكانت تلك إشارة غير مسبوقة من الإدارة الأميركية حول انفتاحها على التقارب مع أسمرة التي طالما اعتبرتها إحدى العواصم المارقة المناهضة للولايات المتحدة في أفريقيا.
على مدار تاريخ إريتريا، كان موقف أميركا تجاه البلاد عدائيا(16) في أغلب الأوقات، منذ أن اقترحت بريطانيا والولايات المتحدة دمج المستعمرة الإيطالية السابقة مع إثيوبيا في أوائل الخمسينيات على غير رغبة الإريتريين، ولاحقا خلال الحرب الباردة حين دعمت واشنطن حليفها الإمبراطور الإثيوبي هيلا سيلاسي في قتاله ضد المتمردين الإريترين، موقف عدائي حافظت عليه الولايات المتحدة حتى خلال السبعينيات والثمانينيات حين حكمت إثيوبيا بواسطة نظام ستاليني حليف للسوفييت، ورغم حدوث انفراجة نسبية في العلاقات مطلع التسعينيات حين قدمت إدارة كلينتون مساعدات مالية عسكرية للبلاد، فإن هذه الانفراجة انتهت بعد سنوات قليلة حين اندلعت الحرب مع إثيوبيا عام 1998، حيث قامت واشنطن بتعليق بيع السلاح إلى إريتريا.
وخلال حكم إدارة جورج بوش الابن، كانت(17) إريتريا أحد الملفات الواضحة للخلاف بين الدبلوماسيين والعسكريين رفيعي المستوى في واشنطن، فبالنسبة إلى أرباب الدبلوماسية كانت أسمرة حقلا غير مكلف لممارسة التشبث بالقيم الأميركية المزعومة حول حقوق الإنسان والديمقراطية، وقبل ذلك، فإن السياسيين غالبا ما منحوا وزنا أكبر بوضوح لمصالحهم مع إثيوبيا، الجارة الأكبر حجما ذات مئة المليون نسمة، بيد أن كبار المسؤولين في البنتاغون كانوا يريدون منذ وقت طويل التعامل الوثيق مع إريتريا منذ عهد وزير الدفاع الأسبق “دونالد رامسفيلد”، الذي تحدث عام 2002 حول جهود إريتريا في مكافحة الإرهاب والفوائد التي تعود على الولايات المتحدة من العمل معها.
الرئيس الإريتيري إسياس أفورقي (رويترز):
في ذلك التوقيت، كان نظام “أسياس أفورقي” مهتما بشدة (18) بالتقارب مع واشنطن، واستثمر في توظيف لوبيات الضغط مثل شركة المحاماة “جرينبيرج تراوريج” -المرتبطة آنذاك بزعيم مجلس النواب “توم ديلاي”- من أجل الترويج لاستضافة قاعدة عسكرية أميركية في إريتريا للاستفادة من موقع البلاد الإستراتيجي في الغزو الذي يلوح في الأفق على العراق، في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة تواجه فيه معارضة للغزو من جوار العراق العربي، وحتى من جيبوتي التي استضافت للتو وقتها القاعدة الأميركية في أفريقيا.
لم تفلح مغازلات “أفورقي” في استقطاب واشنطن التي واصلت سياسة نبذ إريتريا إلى النهاية، سياسة بلغت ذروتها عام 2009 حين نجحت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة “سوزان رايس” في دفع مجلس الأمن إلى فرض عقوبات ضد إريتريا تحت دعوى دعمها للإرهابيين في الصومال، موقف حافظت عليه الولايات المتحدة حتى قبل أشهر قليلة حين بدأت التصدعات في الظهور في العلاقة بين واشنطن وجيبوتي بفعل المخاوف الأميركية من النشاط الصيني المتزايد في القارة.
ومع مرور الوقت، كانت المخاوف بشأن التوسع الصيني تُهيمن على الرؤية العسكرية الأميركية شيئا فشيئا، موقف دفع الجيش الأميركي إلى إدخال تعديلات جوهرية(19) على خريطة أولوياته الإستراتيجية في أفريقيا، واضعا مكافحة الصين وروسيا في قلب استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة التي كُشف عنها مطلع العام الحالي 2018، وهي أحدث علامة على تغيير الأولويات بعد أكثر من عقد ونصف من التركيز على الحرب على الإرهاب.
وزير الدفاع الأمريكي “جيمس ماتيس” (الجزيرة):
وفي معرض تقديمه للاستراتيجية الجديدة التي ستحدد أولويات البنتاغون لسنوات قادمة، وصف وزير الدفاع “جيم ماتيس” الصين وروسيا بـ “قوى رجعية تسعى لخلق عالم يتوافق مع نماذجهما الاستبدادية”، ورغم حرص ماتيس على التأكيد أن “مكافحة الإرهاب” لا تزال في قلب جدول الأعمال الأميركي، فإنه أكّد على أن السلطة والقوة تقعان على رأس هذا الجدول.
في ذلك التوقيت، كانت واشنطن تشعر(20) بتهديد كبير من قيام جيبوتي بمنح السيطرة على محطة حاويات دوراليه إلى شركات صينية بعد انتزاعها من موانئ دبي، خاصة بعد أن وقّعت جيبوتي اتفاقية لتوسيع الميناء مع شركة سنغافورية شريكة للعديد من الشركات الحكومية الصينية، وأهمها مجموعة التجار الصينيين التي تمتلك حصة في الميناء بالفعل، وقد حذر الجيش الأميركي علانية من أن سيطرة الصين على الميناء يمكن أن تعرض الأمن القومي الأميركي للخطر، ورغم أن القيادة الجيبوتية أبلغت واشنطن أنها ليس لديها أي نية لتسليم الميناء إلى السيطرة الصينية، ظلت واشنطن قلقة من أن تراكم الديون الصينية على جيبوتي يمكن أن يدفعها لتسليم الميناء لبكين في نهاية المطاف، وهو ما دفع البعض إلى القول إن الولايات المتحدة ستكون أفضل حالا إن نقلت قاعدتها الأفريقية إلى بلد قاري آخر.
ويمكن القول ببساطة إن إريتريا كانت الفائز الأول من جدول الأعمال الأميركي الجديد، وإن جيبوتي كانت أبرز ضحاياه، فمع دخول الاتفاق بين إثيوبيا وإريتريا حيز التنفيذ يبدو أن حكومة “غيلة” في جيبوتي قد فوجئت بالتشكيلات(21) الإقليمية الجديدة التي صارت تهدد بفقدان البلاد لجبايتها التجارية، مع التأثيرات المحتملة للترتيبات الجديدة على مكانة ميناء جيبوتي البارزة في القرن الأفريقي.
لعقود، كانت جيبوتي هي الفائزة بلا منازع(22) بالعداء الإثيوبي الإريتري والعزلة الدولية للأخيرة، حيث حافظ البلدان على علاقة سياسية واقتصادية وثيقة بدافع الضرورة المتبادلة، خاصة منذ اندلاع الحرب الحدودية بين إثيوبيا وإريتريا عام 1998، وفقدان إثيوبيا إمكانية الوصول إلى ميناء إريتريا، ما خلق للبلاد أزمة وجودية وأوقعها رهينة للاعتماد على جيبوتي، وبالنسبة لبلد يقل عدد سكانه عن مليون شخص، فإن أكثر من 1.5 مليار دولار سنويا من عوائد الشحن لجارتها الكبيرة مثّلت النسبة الأكبر من حصة المدخولات الأجنبية في البلاد.
ولكن موانئ جيبوتي سوف تواجه اليوم منافسة كبرى(23) من الموانئ الإريترية التي يحتل بعضها مواقع أفضل نسبيا، وتأتي بامتيازات مادية أكبر مما توفره جيبوتي، ناهيك بالاستعداد(24) الكبير الذي أبدته أبوظبي لتمويل بنية تحتية جديدة للربط بين إثيوبيا والموانئ في إريتريا والصومال لموازنة مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تم تشييدها للربط بين جيبوتي وأديس أبابا، وعلى رأسها مشروع خط السكة الحديد بين أديس أبابا وميناء جيبوتي الذي تموله الصين بقيمة 3.5 مليار دولار، ويعد أنبوب النفط المموّل من الإمارات والذي تمّ الإعلان عنه للتو من عصب إلى أديس أبابا هو مسمار آخر في نعش جيبوتي.
وحتى جاذبية جيبوتي للجيوش الأجنبية التي استثمر فيها نظام غيلة طويلا سوف تكون موضعا للتساؤل والتشكيك مع هذا الترتيب الإقليمي الجديد، فمع تحسن العلاقة بين واشنطن وإريتريا، فسوف ترحب أسمرة(25) بشدة باستضافة قاعدة أميركية بديلة لقاعدة جيبوتي المتاخمة للوجود الصيني، حيث يمكن لواشنطن أن تستفيد من الموقع الإستراتيجي للبلد الذي يمتلك أكثر من 700 ميل من السواحل على البحر الأحمر، مع وجود عسكري لدولة الإمارات، حليف واشنطن الأبرز في منطقة البحر الأحمر وباب المندب.
تتجاوز المصالحة بين أديس أبابا وأسمرة إذن مجرد كونها اتفاق سلام تقليديا، خالقة دنياميكية اقتصادية جديدة في القرن الأفريقي تُعيد هيكلة العلاقات بين القوى وتصعد قوى جديدة وتنحي قوة صاعدة، وفي الوقت الذي تنظر فيه جيبوتي إلى المصالحة بين إثيوبيا وإريتريا على أنها لعبة صفرية بالنسبة لها، فإنها لا تبدو مخطئة تماما، فكلما تسارعت وتيرة تطبيع الخلافات بين الغريمين بالرعاية الإماراتية والتوجيه الأميركي اختفت المزايا الاستراتيجية التي بنتها جيبوتي حول الصراع، ومع توتر علاقة الدولة الصغيرة مع الفاعلين الرئيسيين في الترتيب الجديد، يبدو أن لعبة إسماعيل عمر غيلة شارفت على الانتهاء، وأن وهج جيبوتي الصغيرة في طريقه إلى الأفول أسرع مما كان يعتقد الجميع.